
































 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
مكتبة الأخوة أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن
|
|
إن روح الله مزمع أن يضع أمامنا خراب بيت الله والفشل المتزايد للمسيحية المعترفة خلال هذا التدبير مع وصول الشر إلى ذروته في الأيام الأخيرة. إنها صورة مرعبة لسقوط المسيحية والتي لا شفاء لها, هذه الصورة المرعبة حقاً للقلب - ولو كان صاحبها يمتلك أشجع قلب . ولهذا قبل أن يرسم أمامنا هذا الخراب فإن الرسول يسعى أن يرسخ نفوسنا ويثبت قلوبنا في الله حيث يضع أمامنا تلك المصادر الباقية في الله. وهو يستعرض أمامنا الحياة التي في المسيح يسوع (ع 1)، والأشياء التي أعطاها لنا الله (ع 6و7)، وشهادة ربنا (ع 8) وخلاص الله ودعوته (ع 9 و10)، ويوم المجد المشار إليه أنه "ذلك اليوم" (ع 12و18) وصورة الكلام الصحيح في الحق الذي لم يمسه أي خطأ (ع 13). (ع 1): يفتتح بولس رسالته بأن يستحضر أوراق اعتماده وهو يكتب بكل سلطانه باعتباره "رسول يسوع المسيح". ومن المفيد لنا أن نقرأ الرسالة كمن تستحضر بياناً من يسوع المسيح لنا بواسطة مرسله. ولم تكن رسولية بولس برسامة ولا بمشيئة إنسان، بل "بمشيئة الله". هذا فضلاً عن إن بولس قد أرسل بيسوع المسيح ليخدم في هذا العالم عالم الموت، لتتميم وعد الحياة، الحياة التي ترى في كل كمالها في المسيح يسوع وهو في المجد. وبالنسبة للرسول بولس فغالباً ما كان يرى "الحياة" في كل ملئها ومجدها, وبهذا المعنى يمكن أن يشار إليها كوعد. ولا يمكن حتى لخراب الكنيسة أن يمس هذه الحياة التي في المسيح يسوع والتي ترتبط بكل مؤمن أيضاً. (ع 2- 5): وأمكن للرسول أ يخاطب تيموثاوس باعتباره "الابن الحبيب"، فأي تعزية لنا في زمن الخراب أن نجد أولئك الذين نستطيع أن نعبر لهم عن عواطفنا بلا تحفظ، والذين بكل ثقة يمكننا أن نفضي لهم بما في قلوبنا. لقد كان في تيموثاوس صفتان بارزتان انتزعت ثقة ومحبة بولس، أولهما أنه كان يتذكر دموعه، وثانيهما أنه يتذكر إيمانه العديم الرياء.إن دموع تيموثاوس بينت أنه كان رجلاً ذا عمق روحي يشعر بالحالة الهابطة والمتردية للمسيحية المعترفة. أما إيمانه العديم الرياء فقد برهن على قدرته أن يتجاوز كل الشرور الحادثة بطاعته وثقته في الله. وكان لتيموثاوس في الواقع طبيعة جبانة رعديدة، وبالتالي كان محاطاً بخطر أن يرتبك يبتلع بهذا الشر الذي يغزو الكنيسة. وهو إذ تميز بالدموع والإيمان فإن الرسول تشجع بأن يعلمه ويحرضه، عارفاً بما كانت له من صفات تمكنه من التجاوب مع دعوته، ويتضح لنا السبب هنا لماذا لا تجد تعاليم هذه الرسالة اليوم ولو تجاوباً قليلاً من المؤمنين. وكيف يكون التجاوب ما لم تتوافر الدموع التي تتحدث عن قلب رقيق، يمكنه أن يبكي ويحزن على أحوال شعب الله المسكين، وكذلك الإيمان الذي يمكنه أن يتخذ طريق الله بالانفصال من وسط هذا الخراب. لقد سر بولس أن يتذكر في صلاته رجل الدموع ورجل الإيمان هذا. وأي سرور يملأ القديس الذي ينكس قلبه على شعب الله –عندما يعرف أن هناك قديسين أتقياء وأمناء وهو يتذكرهم في صلاته. فالأمانة في زمن الارتداء تربط القلوب معاً بروابط المحبة الإلهية. (ع 6): وبعد أن عبر عن محبته لتيموثاوس وثقته فيه فإن بولس يحرضه ويشجعه ويعلمه. فهو أولاً يحرضه بأن يضرم "موهبة الله" التي أعطيت له لخدمة الرب. وفي حالة تيموثاوس بالذات كان قد منح هذه الموهبة بواسطة الرسول. أما عندما تكثر الصعوبات والمخاطر وعدم الأمانة وعندما تبدو نتائج قليلة من الخدمة، فهناك تتربص بنا خطورة التفكير بعدم جدوى ممارسة الموهبة، ولذلك فإننا نحتاج إلى التحذير من إهمال الموهبة أو تركها بلا استخدام، فعلينا أن نضرمها. وفي زمن الخراب يزداد الإلحاح على استخدام الموهبة. وأمكن للرسول أن يقول في حديث لاحق بالرسالة "أكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب" (4: 2). (ع 7): وبعدما تحدث عن المواهب المختصة بالأفراد، فإن الرسول يذكر تيموثاوس بالموهبة المعطاة لكل المؤمنين. فقد أعطى الله للبعض موهبة خاصة لخدمة الكلمة، وأما لكل شعبه فقد أعطاهم روح القوة والمحبة والنصح[1]. ويبدو لنا من الصعوبة القول بأنه يشير هنا إلى الروح القدس مع أنها تتضمن عطية الروح. بل نقول بالحري أنه يتحدث عن الحالة وروح المؤمن، وهما نتاج عمل الروح القدس، وبالتالي الاشتراك في خصائص الروح، كما قال الرب: "المولود من الروح هو روح ". إن تيموثاوس بحسب الطبيعة جبان وخجول وميال إلى التراجع، ولكن الروح القدس لا يولد فينا روح الجبن أو الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح (والنصح معناه الفكر الواعي الصحيح).قد نجد في الإنسان القوة بدون المحبة، أو المحبة التي تنكمش إلى مجرد عاطفة، أما مع المسيحي فبقيادة الروح القدس فإن القوة تمتزج مع المحبة، والمحبة تعبر عن نفسها بالنصح أو الحكمة المتبصرة. ولذلك، كيفما كانت صعوبة الأيام فالمؤمن مجهز تماماً بالقوة لعمل إرادة الله، وللتعبير عن محبة الله، ولممارسة الحكم الهادىء والمتزن في وسط الخراب. (ع 8): وإذ يذكرنا بروح المجاهرة المقدسة التي أعطيت لنا, أمكن للرسول أن يقول "فلا تخجل بشهادة ربنا, ولا بي أنا أسيره" إن شهادة ربنا هي الشهادة لمجد المسيح – المسيح الذي جلس كإنسان في قوة فائقة بعدما انتصر على قوة الشيطان. لم يكن بطرس قد خجل من شهادة ربنا إذ جاهز بتلك الشهادة وقال "فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً" (أع 2:36). وكما قال واحد "بعدما قاد إبليس الإنسان ليظهر قمة عداوته وشره بالمسيح، فإن يسوع الآن صار مكللاً بالمجد والكرامة بعد كل هذا. إنها يقينا نصرة". كذلك أيضأن في زمان الرسول، عندما دب الخراب بين شعب الله، وأحرز الشيطان انتصاره بإدخال بولس السجن، وتركه القديسون، والشر قد ازداد، فإن الرسول مع شعوره العميق بعظم الفشل، لكنه كان مسنوداً ومؤازراً خلال كل هذا, وقد ارتفع فوق الظروف كلها متحققاً بأن الرب يسوع في قمة القوة الآن بعيداً عن تأثيرات إبليس كلها وكان مصدره الدائم هو الرب الممجد، لذلك قال "الرب وقف معي وقواني" "وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي" (4: 17 و18). ونحن نتحدث كثيراً عن المسيح في طريقه على الأرض، أو عن المسيح وهو مصلوب، أو عن المسيح في مجيئه، وهذا كله صحيح في مكانه. ولكن قليلاً جداً ما نتكلم عن المسيح حيث يقيم الآن في مجد الله، وهذه هي شهادة ربنا – الشهادة العظمى التي نحتاجها الآن، والشهادة التي يأتينا الحذر لئلا نخجل منها. وكيفما عظم الخراب، ومهما كان الفشل بين شعب الله، ومهما قابلنا من مصاعب. ومهما تخلى القديسون وانشقوا (1: 15) وكيفما كانت الإرادة الذاتية التي تقاوم وتعاند (2: 2 و26)، أو كان خبث أولئك الذين يعملون الشرور معنا (4: 14)، فإن مصادرنا الباقية نجدها في الرب يسوع وهو عن يمين الله. وإذ نتطلع إليه نصبح كالرسول فنرتفع فوق كل الفشل الذي في أنفسنا أو في الآخرين. ويا للأسف ففي المصاعب التي تواجهنا فإننا نفسد الأمور بمحاولتنا أن نصحح الأشياء بقوتنا الشخصية، بينما لو تطلعنا إلى الرب فسنجد مثل بولس، لأن الرب معنا يقوينا وينقذنا من كل عمل رديء. وكم هو ضروري لنا أن نقدم شهادة صحيحة لمركز ربنا الحاضر وهو في تفوقه وقوته كإنسان في المجد، فهو بذلك أعظم مصدر لنا في الأيام المظلمة. وليس هذا فحسب، بل لنتحذر من أن نخجل من أولئك الذين، في أيام الارتداد، لهم جسارة وهم يسعون لإعطاء الرب مكانه. وليكن عندنا الاستعداد أن نتحمل الألم. غذ لزم الأمر – في دفاعنا عن الإنجيل، عالمين أننا نعول على قوة الله التي تؤازرنا. (ع 9 و 10) وإذ نحذر من أن نخجل من شهادة ربنا, ولا أن نخجل من الذي يشهد عن تفوق الرب ومجده محتملاً التعبير والألم بسبب هذه الشهادة، كما يشجعنا لكي نشارك في آلام الإنجيل أيضأن فإن الرسول يتقدم في أن يذكرنا بعظمة الإنجيل الذي هو قوة الله للذين خلصوا والذين دعوا (1كو 1: 18 و24). إن التحقق من مجد الرب وعظمة الإنجيل سيحفظنا من أن نخجل بالشهادة ويعدنا لاحتمال آلام الإنجيل. يتضح من هذين العددين أن أعظم نقطتين يتحدث عنهما الإنجيل هما الخلاص والدعوة. فمن جهة يعلن الإنجيل طريق الخلاص، ومن الجهة الأخرى يستحضر غرض الله تجاه الذين خلصوا. ونحن نميل إلى تحديد الإنجيل بالسؤال الهام عن خلاصنا ونكتفي بهذا, وإذ نفعل ذلك نفقد أعظم بركة ترتبط بقصد الله الأزلي، وبذلك نفشل في الدخول إلى الدعوة السماوية. ومن الواضح أن أعظم وأول موضوع يطرحه الإنجيل هو خلاصنا, والله لا يريد من المؤمن أن يكون في شك من جهة أمر هذا الخلاص، وكما نقرأ في النص "الذي خلصنا". إن النتيجة المباركة لموت وقيامة ربنا يسوع المسيح أن تضع المؤمن بعيداً عن الدينونة التي استحقها بسبب خطاياه، وأن تنقذه وتحرره من طريق هذا العالم. لذلك نقرأ "الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير" (غل 1: 4) فمع كوننا الآن في هذا العالم، ولكنا قد تحررنا من قوته وتأثيره، وأننا لسنا أدبياً مثل العالم. هذا هو الجزء الأول من الإنجيل، وعند هذه النقطة يقف جمهور عظيم من شعب الله ليكتفوا بذلك ومع هذا فإن الإنجيل يعلن بركات أعظم وهو يخبرنا عن دعوة الله. فلم يكتف الله بخلاصنا فقط إذ نقرأ: "الذي دعانا دعوة مقدسة" وفي هذا النص يشير إلى الدعوة بأنها "دعوة مقدسة". ويتحدث عنها في مكان آخر بأنها "دعوة سماوية" (عب 3:1). و "دعوة عليا" (في 3: 14). إن الخلاص يحررنا من خطايانا ومن دينونة العالم الهالك، أما الدعوة فتربطنا بالسماء وبكل البركات الروحية التي قصدها في السموات في المسيح. ولهذا فإن بركات دعوة الله ليست بمقتضى أعمالنا ولا بحسب أفكارنا أو استحقاقنا, "بل بحسب القصد والنعمة" أو "بحسب قصده ونعمته". إنه لم تسدد ديوننا فحسب، ولم نتحرر من تأثير وقوة مشهد الديون التي جلبناها على أنفسنا فقط، بل إننا نتعجب إذ نتعلم أنه بحسب مقاصد الله فهناك أشياء أعدت للذين يحبون، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر (1كو 2: 9). ففي دعوة الله تعلن لنا أسرار قلبه التي تكشف لنا عن اتساع وعظم البركات السماوية، ويؤكد لنا أن كل هذه البركات قصدها لنا في المسيح من قبل تأسيس العالم. ولذلك نتعلم أنه قبل أن نخطىء منذ أمد طويل، وقبل أن نتعرض لأي مسألة واحدة فإن الله كان له غرض مستقر لأجل بركتنا الأبدية. فلا الشر الذي نفعله ولا فشل الكنيسة في مسئوليتها يمكن أن تبدل قصد الله، كما وأنه لا الخير الذي يمكن أن نفعله قادر أن يجلب لنا قصد الله. هذا القصد الأزلي أصبح الآن معلناً بظهور خلاصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. لقد واجه المسيح بموته عن المؤمن حكم الموت الذي كان مسلطاً علينا وفتح لنا مشهداً جديداً للحياة والخلود. فلم يعد الموت يمنع المؤمن من الدخول إلى هذا المشهد من الحياة والبركة بحسب قصد الله. إن النفس لن تعبر من الموت إلى الحياة فحسب، بل إن الجسد سيلبس عدم فساد ولذلك فإنه بالإنجيل يستحضر إلى النور دائرة الحياة والخلود والتي لا يمكن أن يفسدها الموت أو الفناء.وبقوة الروح يمكننا أن نتمتع الآن بهذا المشهد الجديد. (ع 11) وفضلاً عن ذلك، فهذا الإنجيل بكل ملئه صار معروفاً لنا بواسطة إناء خاص معين –إنه الشخص الذي أتى إلينا كرسول يسوع المسيح للأمم. وقد أتى الإنجيل بسلطته كافية من خلال رسول يتحدث بإعلان ووحي. [1] في ترجمة داربي Wise discretion وتعني الحكمة والتبصير لفهم الأمور المحيطة بنا واتخاذ الموقف المناسب لذلك (المعرب). (ع 12) هذا بالإضافة إلى انه بسبب شهادته الأمينة فإن بولس قد تألم. إنه لم يفعل شيئاً خاطئاً يستحق عليه الألم والتعبير، فغيرته كمبشر وتقواه كرسول أرسله المسيح، وأمانته للكنيسة كمعلم، قد مكنته أن يقول "لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضاً" . فالسجن كان واحد من "هذه الأمور" التي كان على الخادم الأمين أن يتحملها. ولقد كانت هناك آلام أخرى أكثر حدة يستشعرها بقلبه الحساس، ومن "هذه الأمور" أولئك الذين أحبهم في آسيا وخدم بينهم طويلاً ولكنهم تركوه. كما أنه أيضاً تألم من مقاومات المعترفين بالمسيحية الذين كانوا يقاومون الحق (2: 25)، ومن اضطهاد الناس الأشرار (3: 11 - 13)، ومن حقد وأذى بعض الأفراد المعترفين بالمسيحية أمثال الإسكندر الذي أظهر للرسول شروراً كثيرة (4: 14). وبالرغم من أنه كان يتألم بسبب أمانته كخادم ليسوع المسيح، أمكنه أن يقول "ولكنني لست أخجل". إنه ليس فقط لم يخجل ولكنه لم يفشل كذلك، ولم تفرط شفتيه بكلمة غضب بسبب ظلم العالم له، أو بسبب تخلي بعض المؤمنين عنه وجحودهم ومقاومتهم له. بل ارتفع فوق كل كآبة وكل غيظ وكل حقد متيقناً بأن المسيح قادر أن يحفظ وديعته إلى ذلك اليوم. إذ أن المسيح عندما شتم لم يكن يشتم عوضا, وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضى بعدل وهكذا سلك بولس بذات روح سيده في مواجهة الآلام والترك والإهانات إذ سلم كل شيء لدى المسيح. أما كرامته وسمعته وشخصيته وبراءته وسعادته فقد أسلم الكل إلى للمسيح عالما أنه مع تخلي القديسين ومقاومتهم له فالمسيح لن يخيبه إذ كان مقتنعا بأن المسيح قادر أن يعتني به ويسدد أعوازه ويثبت براءته ويصحح كل خطأ"في ذلك اليوم". وفي نور "ذلك اليوم" الآتي، أمكن لبولس أن يتجاوز منتصراً لما يأتي عليه من إهانات وازدراء وعار. قد نتعجب لماذا سمح للرسول المكرس أن يتخلى عنه ويقاوم من القديسين، ولكننا لن نتعجب "في ذلك اليوم " الآتي عندما يتصحح كل خطأ وعندما يوجد كل عار وألم وتعيير للمدح والكرامة والمجد عند ظهور يسوع المسيح. قد نجد الأمين الآن في وضع بسيط أو محتقر ومزدري به، كما كان الرسول بولس وأولئك القليلين الذين كانوا مرتبطين به في ختام حياته، وعلى الرغم من هذا ففي "ذلك اليوم" الآتي سيكون أفضل جداً أن نوجد مع البقية المحتقرة عن أن نوجد مع الأكثرية غير الأمينة. إن الجسد في بطلانه يميل إلى الشعبية وتركيز الاهتمام عليه ليجعل نفسه مشهوراً أمام العالم والقديسين، ولكن بالنظر إلى "ذلك اليوم" الآتي فمن الأفضل أن نأخذ المكان المتواضع في إنكار الذات عن أن نأخذ مكاناً علنياً ومشهوراً, فكم سيصبح كثيرون من الأولين آخرين، وآخرون أولين. إننا نتألم حقاً بسبب فشلنا وهذا يذللنا. وبالرغم من هذا, فنفعل حسنا, وأمامنا الرسول بولس كمثال، أن نتذكر أن سيرنا بأمانة مطلقة يوجب علينا أن نتألم أكثر إذ ستبقي الحقيقة أن الذين يعيشون بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون (3: 12). وإذا كنا أمناء للنور الذي منحه لنا الله، وسعينا للسير بالانفصال عن كل ما يخالف الحق فسنجد أننا سنواجه الاضطهاد والمقاومة بقدر ولو بقليل، وبصورة أشد وأقسى من إخوتنا المؤمنين. ونفعل حسناً عندما تأتينا التجربة أن نسلم الكل للرب وننتظر تبرئته لنا "في ذلك اليوم" الآتي وغالباً ما نكون نحن متعجلين وغير صبورين إزاء الأخطاء التي تصيبنا من الخارج ساعين أن نصححها في يومنا هذا بدلاً من الانتظار إلى "ذلك اليوم" الآتي. فإذا كنا بالإيمان نرى مجد "ذلك اليوم" الآتي يلمع أمامنا فبدلاً من أن نجرب بالتمرد إزاء الإهانات والأخطاء التي يسمع بها فإننا سنفرح ونتهلل جداً كما يقول الرب "لأن أجركم عظيم في السموات" (متى 5: 12). (ع 13 و14) نرى إذن أن هذا الإنجيل العظيم بما فيه من خلاص ودعوة، قد جاء إلى تيموثاوس خلال مصدره موحى به، ويحرض بأن يكون له "صورة التعليم الصحيح" الذي سمعه من الرسول. لقد وصلت الحقائق إلى تيموثاوس في كل "كلام صحيح"، وكان عليه أن يتمسك به في صورته المرتبة الصحيحة لكي يكون فيما يتمسك به واضحاً ومحدداً. وترينا هذه الصورة كيف أن الحقائق معبر عنها ومحمولة "بالكلام الصحيح"، وأيضاً نرى الترابط الصحيح بين الحقائق بعضها ببعض وصورة "الكلام الصحيح" نجده في الكلمة المكتوية وبصفة خاصة في رسائل بولس –ففي الرسالة إلى رومية نجد أنها تستحضر لنا بشكل مرتب الحقائق بشكل المختصة بالخلاص، بينما الرسائل الأخرى تعطينا صورة الكنيسة ومجيء الرب وبقية الحقائق الأخرى. أما في المسيحية اليوم فهذه الصورة ضائعة إلى حد بعيد، إذ تستخدم نصوصاً بمعزل عن سياقها. ولكن "صورة التعليم الصحيح" قائمة كما يستحضرها لنا الكتاب، فعلينا مسئولية حراستها بغيرة شديدة. وربما نجد أناساً مخلصين في الماضي أو الحاضر يحاولون أن يصيغوا إيمانهم في شكل عقائدي كمادة للاعتراف الإيماني بها, أن ربما جعلوها في مقالات أو في شكل قوانين لاهوتية وعلى الرغم من هذا فكيفما استفاد الناس من تلك المحاولات البشرية في مكانهم فإنهم قد عجزوا عن إدراك الحق ولم يحيطوا "بصورة الكلام الصحيح" بحسب الوحي المعلن في الكتاب. وفضلاً عن ذلك، فإن "صورة الكلام الصحيح" والذي قبل من الرسول والذي يلزم التمسك به، ليس هو مجرد قانون نتشبث به، وإنما نمسك بالإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع، بذلك الشخص الحي الذي يتكلم عنه الحق. إنه لا يكفي أن تكون لنا "صورة الكلام الصحيح" فإذا كان الحق مؤثراً في حياتنا فيجب التمسك به "في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع". فالحق عندما يستحضر للنفس لأول مرة فإننا نقبله بفرح، ولكنه يفقد نضارته ما لم نتمسك به في الشركة مع الرب. هذا, وإذا كان الحق نحفظه بالشركة مع المسيح، فإنما يكون ذلك بقوة الروح القدس. ولذلك فإن مستوى الحق كله المتضمن في صورة الكلام الصحيح الذي أعطي لتيموثاوس لابد من حفظه بالروح القدس الساكن فينا. (ع 15) إن الأهمية القصوى للتمسك بصورة الحق في الشركة مع المسيح بقوة الروح، وقد تأكدت لنا بهذه الحقيقة الخطيرة أن الذي استعلن له الحق لينادي به، قد تركه وتحول عنه غالبية القديسين في آسيا. أولئك القديسون الذي صارت لهم الدعوة السماوية وقد أعلن لهم كل الحق المسيحي قد ارتدوا عن بولس . وهذا لا يعني أن هؤلاء القديسين قد تحولوا عن المسيح أو تركوا إنجيل خلاصهم، ولكنهم لم يعودوا يتمسكون بالحق المختص بالدعوة السماوية الذي أعلن للرسول، ولم يحفظوه في الشركة مع المسيح بقوة الروح القدس. ولذلك لم يكونوا مستعدين لأن يرتبطوا به في مكان الرفض خارجاً عن هذا العالم، وهذا ما يتضمنه الحق الكامل للمسيحية. وذلك يؤكد لنا أننا لا نقدر أن نثق في معظم القديسين المستنيرين لحفظ الحق. إنه فقط كما يأمرنا المسيح بأن تبقى العواطف والتأثيرات بقوة الروح لنحفظ هذا الشيء الصالح المسلم لنا. (ع 16- 18) والإشارة هنا إلى أنيسيفورس وبيته إشارة مؤثرة للغاية.ولقد برهنت هذه على أن اللامبالاة وارتداد الغالبية من المؤمنين لم تجعل الرسول أن يتغافل عن المحبة والرحمة لهذا الفرد وعائلته. حقاً فإن ارتداد الأكثرية تجعل عواطف القليلين ثمينة للغاية. وعندما تحزن الرسول أغلبية من المؤمنين فإنه يوجد واحد على الأقل أمكن أن يقول عنه "مراراً كثيرة أراحني (أو أنعشني)". لقد خجل الكثيرون منه أما عن هذا الأخ فلم يخجل بسلسلته، وعندما ارتد عنه الجميع بقي واحد كتب عنه قائلاً "طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني". ولما نسيه الآخرون أمكنه أن يعترف بسرور بهذا الأخ "الذي خدمه في أشياء كثيرة". وكم كان مشبعاً لقلب الرسول، أنه في أيام الارتداد عنه، يتحقق من مشاركة وتعزية المسيح التي تجد تعبيرها بواسطة هذا الأخ المكرس. وإن كان بولس لم ينس هذا التعبير عن المحبة في يوم التخلي عنه، فإن الرب لن ينسى "في ذلك اليوم" –يوم المجد الآتي. إن المؤمن الذي تعلم فكر الله لا يمكنه أن يسلم بأن ما حدث لكنيسة الله وهي في يد الناس تتشابه مع كنيسة الله كما هي في المكتوب. هذا التحول الخطير عن كلمة الله يرينا بوضوح أن غرض الله من جهة الكنيسة في زمان غربتها أثناء غياب المسيح عنها, لم يستمر هكذا إذ خربت وهي أيدي الناس. إن قليلين حقاً ينكرون أننا نعيش في زمان الخراب. والنقطة المهمة الأولى أن نفهم بوضوح ماذا نعني عندما نتكلم عن خراب الكنيسة. يجب أن نتذكر أن الكنيسة بحسب الكتاب منظور لها من زاويتين: الأولى تستحضر أمامنا بحسب مشورات الله، والثانية منظور إليها بالارتباط بمسئولية الإنسان. بالمنظار الأول نراها كتابياً مؤسسة على المسيح كابن الله والتي تضم كل المؤمنين الحقيقيين، ومعين لها أن يحضرها المسيح لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك. وهي حصيلة عمل المسيح، وأبواب الجحيم لنتقوى عليها. ولا يمكن للخراب أن يمس عمل المسيح، ولا يقدر أن يزيح جانباً مقاصد اله لأجل المسيح وكنيسته. وبالمنظار الثاني فإن الكنيسة بحسب مسئوليتها عليها أن تشهد للمسيح أثناء غيابه عنها وأن تستحضر نعمة الله للعالم المحتاج. وللأسف فقد فشلت الكنيسة تماماً في حمل تلك المسئولية. ولسبب ضعف الاستناد على الرب، والطاعة للكلمة، فإن شعب الله أصبح مقسماً ومشتتاً, ونقص السهر أدى في النهاية إلى اتساع رقعة المسيحية التي ضمت مؤمنين وكانت النتيجة التي استخلصها العالم عن الكنيسة أنها بعيدة تماماً عن كونها تمثل مجد المسيح، ولا في طبيعتها ولا في المحبة، ولا في القداسة، ولا في عواطف المسيح. وأصبحنا ننادي بهذه الحقيقة أن هناك كنيسة معترفة منظورة، وكنيسة روحية تضم كل المؤمنين الحقيقيين وهم غير منظورين، هذه الحقيقة في حد ذاتها تؤكد لنا اكتمال الخراب. وإذا تحدثنا عن العيشة في زمن الخراب، فإننا نعني أن قرعتنا وقعت في وقت أصبحت فيه الشهادة للمسيح أثناء غياب المسيح قد خربت. وفي الخطابات إلى السبع الكنائس في الرؤيا نجد مجمل الصورة النبوية لتاريخ الكنيسة على الأرض، ومسئولية الشهادة على الأرض، ونرى هنا تقدم فشل الكنيسة في مسئوليتها كما يسبق الرب ويخبرنا عنها بنفسه بدقة إلهية، والتي تبدأ من تحولها عن المحبة الأولى إلى أن تنتهي بالحالة التي تجعل المسيح في غثيان شديد ثم يتقيؤها من فمه. ويعطينا الكتاب نوراً بالنسبة ليوم الخراب. ففي الرسالة الثانية لتيموثاوس لا نجد النبوة عن الخراب فحسب، ولكن الروح القدس بواسطة الرسول بولس يعطينا تعليمات محددة للتقي كيف يعمل في زمن الخراب، فإن شعب الله لم يترك بدون قيادة إلهية. إن رحمة الله تميز طريق شعب الله في يوم الخراب. وقد ينقصنا الإيمان بالله والتكريس للمسيح وهما ضروريتان للسير في الطريق وهذا أقل ما يجب أن يميزنا بحسب كلمة الله وهي طاعة الإيمان. وهنا نصل إلى النتيجة فهناك شيئان ضروريان لنسير بوعي في طريق الله في وسط الخراب: أولاً من الضروري أن يوفر بعض المعرفة في تعليم بولس (والتي تتضمن الحق المختص بالإنجيل والحق المختص بالكنيسة). وثانياً يجب أن تتوفر حالة روحية صحيحة. وبدون توفر المعرفة عن الكنيسة، وكما جاءت في الكتاب، فمن المستحيل أن نقدر مدى الخراب، وبدون توفر حالة روحية صحيحة فإنه يصعب على المؤمن أن يعد ليسير في الطريق الذي رسمه الله في وسط الخراب. وعندما يأتي بولس إلى شخص مثل تيموثاوس فهو متيقن أن تيموثاوس على إلمام جيد وواسع بتعليم بولس . ففي الإصحاحين الأول والثاني يشير إلى الأشياء التي سمعها تيموثاوس منه (1: 13، 2: 2).وفي الإصحاح الثالث يقول: "وأما أنت فقد تبعت تعليمي" ولهذا لا نجد التعليم الذي يشرح الحق الكنسي في لرسالة الثانية هذه. ولكن مثل هذا الحق يشرحه الرسول في رسائل أفسس وكولوسي والرسالة الأولى إلى كورنثوس والرسالة الأولى إلى تيموثاوس. وطريق الله لنا في يوم الخراب والحالة الروحية المطلوبة للسير في هذا الطريق، معلنة في الإصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس. وإذا رغبنا إلى أن نجيب عن فكر الله في يوم الفشل هذا فمن المفيد أن ندرس بروح الصلاة هذا الجزء الهام. فحقائق هذا الفصل نراها في ترتيب كالآتي: (أ) الحالة الروحية الضرورية للتمييز وللسير في طريق الله وسط فشل المسيحية (ع 1- 13) (ب) موجز لطريق الشر الذي قاد إلى تشويش المسيحية (ع 14- 18) (جـ) مصادر التقي، وطريق الله للفرد في وسط الخراب (ع 19- 22) (د) الروح التي نواجه بها أولئك الذين يثيرون المقاومة لطريق الله (ع 23- 26)
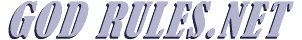 |
