
































 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
مكتبة الأخوة أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن
|
|
وكأن الله يستنفذ كل أساليب التشبيه، في تصوير الحالة التاعسة التي انتهى إليها شعبه المخدوع، وقلوبهم التي ثبتوها على الانحراف عن ذاك الذي كان خيرهم الحقيقي الوحيد. لقد تأملناهم قبلاً في حالة سقوطهم الشقية البائسة، ممثلين في الزوجة الزانية، وفي السكارى بسَوْرَة الخمر، وفي البقرة الجامحة، وفي العجين المختمر، وفي خبز الملة الذي لم يُقلب، وفي الحمامة الرعناء، وفي القوس المخطئة. والآن يحذرهم أنه بسبب خطاياهم سوف يتبددون بين الأمم «كإناء لا مسرة فيه». تلك هي النتيجة المنطقية لعهد سيناء، حيث ألزموا أنفسهم بأن يطيعوا كل كلمات الشريعة، التي وعدت بالبركة لمن يحفظونها، وتوعدت باللعنة على ناقضي وصاياها. وإسرائيل، طبقاً لهذا الأصحاح، قد نقضوا الشريعة من كل اتجاه! وعلى هذا الأساس لم يبق لهم حق في شيء. أما أن عند الله موارد نعمة عجيبة عتيدة أن تفتح أبوابها، فذلك ما يوضحه الأصحاح الأخير، لكنهم إنما يدخلون في خيره حينما يعترفون بخطيتهم، ويتخلون عن كل إدعاء بأي استحقاق. وكأن النبي نفخ في الصور ليستدعي الجماعة كلها إلى حضرة الرب، لكي يواجهوا حقيقة حالتهم كشعب تجاوز العهد وتعدى على الشريعة (ع1). ومن العدد الثاني نشتَّم رائحة رجوع عتيد «إليَّ يصرخون، يا إلهي نعرفك، نحن إسرائيل». لكنه قول يحمل في طياته عدم الإحساس بحقيقة حالهم يومئذ، وخلال سنوات ضلالهم وهم تحت يد الله. هم يقولون «نعرفك، نحن إسرائيل»، بينما يسيرون طوال الزمان في غبائهم، إذ طرحوا كل بر فهربوا من قدام أعدائهم. أقاموا ملوكاً بحسب قلبهم، وأقاموا رؤساء دون مشورة الرب وفي كل مكان تفشت الوثنية، ولم تكن خدمة الهيكل إلا سخرية (ع3،4). وهكذا هم يعترفون بأنهم يعرفون الله، لكنهم بالأعمال ينكرونه. وكم هو يسير بالأسف الانحدار إلى مثل هذه الحالة التي يرثى لها، والتي يصورها روح الله هنا! فاليوم ما أكثر الذين يقولون إنهم شعب الرب، أو الذين يقولون - على حد تعبيرهم - إنهم “في خط الشهادة”؛ بينما هم يتساهلون مع الإثم ويسلكون غير طائعين لكلمة الله. ولقد قال سيدنا في يومه «على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون». فقد كان في مقدورهم أن يتكلموا بأقوال حسنة طبقاً للناموس، لكن التصرف كان دليلاً على حالة نفوسهم؛ وما كان أبعدها عن الله! وينبغي أن نذكر، أنه ولو كان على درجة كبرى من الأهمية أن يكون الإنسان في موقف سليم من الناحية التعليمية وغيرها من نواحي الحق، غير أن مجرد اتخاذ موقف صحيح شيء لا قيمة له إذا كان غير مصحوب بحالة قويمة للنفس. صحيح إن إغفال أي من الجانبين يجلب خسارة، لكن ليس هناك ما هو أردأ من التفاخر على أساس اتخاذ “قاعدة إلهية” ومواصلة السير في “خط الشهادة”، بينما الحياة مدنسة والقلب غير خاضع للحق. لكن النفس التي تتحول عن الإله الحي الحقيقي إلى الأوثان من أي نوع، لابد أن تتعلم آخر الأمر معنى الحرمان والنسيان، عندما تعوزها المعونة عند الحاجة. إن عجل السامرة طوَّح بهم، فصرخوا كما فعل كهنة البعل في أيام إيليا، لكن لم يكن من مصغٍ ولا من مجيب. وهل يكون غير هذا وهم الذين وثقوا بأعمال أيديهم؟ (ع5،6). لقد زرعوا الريح، فليحصدوا الزوبعة، وهذا عين ما يحدث مع كل نفس . على أنه ما أبطأنا في التعلم! فمن الناحية النظرية نجد أن جميع القديسين يعرفون أنه لا توجد بركة حقيقية بعيداً عن السير مع الله، ولكن من الناحية الاختبارية كم ينخدع الكثيرون وينقادون وراء آلهة أخرى حين تسنح الفرصة لكسب امتيازات. أما أخيراً، فيتحقق الجميع أن الثمرة الوحيدة لمثل هذا النوع من الزرع إنما هي الفشل والحزن. «زرع ليس له غلَّة لا يصنع دقيقاً. وإن صنع فالغرباء تبتلعه» (ع7). دعنا نطبق هذا على كل نواحي الحياة، وحينئذ نجدها قاعدة لا تقبل استثناء. قد نرى نجاحاً ظاهرياً منظوراً، يجيء في أعقاب التمرد، ولكن يجب ألا نؤخذ بالمظهر، فليس المنتهى بعد. وقد نتخيل أنه في الإمكان عدم اعتبار الله وكلمته، ولكننا لابد أن نتبين في مرارة النفس أنه في الواقع شر عظيم أن نختار بأنفسنا سبيلاً نسلكه. وإننا لنستطيع أن نذكر كم زوجة انكسر خاطرها، كمثال على المبدأ المذكور هنا، وكم زوجاً تاعساً صار عيِّنة حية للمبدأ ذاته. فلقد نهى الله نهياً صريحاً عن النير المتخالف؛ والكلمة في هذا الشأن واضحة، والقديس الشاب يعرفها وهي في ضميره، وكذلك القديسة الشابة. غير أنه يحدث أن يعترض سبيل أيهما شاب أو فتاة، يبدو حسناً كشريك المستقبل. فيتطور الاحترام إلى عاطفة، وتنضج العاطفة لتصبح حُباً، ومن ثم يُطرح اقتراح الزواج، وعندئذ تبدأ فترة الشك والتردد. إن كلمة الله واضحة كل الوضوح، ولكن وصاياها الواضحة كثيراً ما تُنسى، ولا تُذكر إلا صفات الملاحة والحسن. أما أن الطرف الآخر لم يخلص بعد، فتلك مسألة يُتجاوز عنها. قد يكون للطرف الآخر استعداد لحضور اجتماعات المؤمنين، ورغبة في سماع أقوال الكتاب، فيحسب المؤمن أو المؤمنة أن ذلك برهان على بداية عمل الله في النفس. وأخيراً يقع الشريك المؤمن في الفخ ويدخل تحت ضغط النير المخالف، الأمر الذي تتبعه فوراً حياة كلها ندم. وفي معظم الحالات سرعان ما يتبدد الاهتمام بالأمور الإلهية ويموت مع الأسابيع الأولى من الحياة الزوجية، ويحل في مكانه، إن لم تكن مقاومة علنية مكشوفة، فعلى الأقل برود وعدم مبالاة بالأمور الأبدية التي لا يمكن أن يعوضها اللطف أو الاحترام. وهكذا يقع الجانب المولود من الله في تعاسة مزدوجة، فمن جهة يستشعر ضميره، الذي لابد أن يستيقظ بعد فوات الأوان، بحالة عدم الطاعة التي وضع نفسه فيها؛ إذ يتحقق أن الشريك الذي أحبه لا يهتم بالله أو مسيحه. ومن الجهة الأخرى فما لم ينتبه هذا الشريك البائس ويُقبل إلى المسيح فيخلص، فإن هذين اللذين أحب كلاهما الآخر على الأرض لابد أن ينفصل أحدهما عن الأخر طوال الأبدية. وهكذا وعلى عديد من صور العلاقات والممارسات يتم هذا الناموس عينه، سواء في حياة العمل، أو الحياة الاجتماعية أو الدينية. ألا ليتنا نتعلم مما أوضحه الله لنا بجلاء في كلمته، ومن الاختبارات غير السعيدة التي عاناها الآلاف من القديسين، ومن خطورة العبث بالضمير، والتلاعب بالحق الذي يقدس النفس الطائعة! ولما أبى الشعب الأرضي أن يطيع كلمة الله، لم يسعَ الله، آخر الأمر، إلا أن يقول «قد ابتُلع إسرائيل، الآن صاروا بين الأمم كإناء لا مسرَّة فيه» (ع8). في عدد واحد يصف النبي تاريخهم خلال ألفين من السنوات. فإذ طُردوا من أرضهم، وتبددوا بين الأمم، كانوا كإناء لم يجد الله فيه مسرة. وهنا تتجلى المفارقة بين أولئك وبين ذاك الذي جاء لكي يخلصهم! فقد أعلن الآب إعلانه المشهور «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»، يوم قدَّم نفسه في المعمودية كمن جاء ليفعل في كل حين ما يرضي الآب. هو إناء مسرة ومرضاة الله، أما إسرائيل فقد صار إناءً لا مسرة فيه. ويا لها مفارقة! عبثاً اتجهوا نحو أشور أو سواه من الشعوب المجاورة. إذ لا معونة تُرجى لهم وهم تحت لعنة الناموس المنقوض. ومثل حمار وحشي أظهروا طبيعتهم التي لا تقبل الترويض. لم يتعلموا كيف يطيعوا، ومن ثم لابد أن يحزنوا تحت سلطان الظالم الأممي، نبوخذ نصر ملك بابل، الذي جعله الله «ملك الرؤساء» (ع9،10). وواضح أن الله يتجاوز الآشوري، ويضع عينه على الشخصية التي عُهد إليها مُلك الأمم جمعاء لأول مرة. لقد أكثر أفرايم مذابح الخطية، حين ذبحوا للشياطين وليس لله. وخطيته لابد أن ترجع على رأسه (ع11). وفي ع12 نجد أساس وسبب مخاصمة الرب لهم «أكتب له كثرة (أي عظائم) شرائعي، فهي (أو لكنها) تحُسب أجنبية». كان لزاماً عليهم أن يتصرفوا على هدى الكلمة المكتوبة، ولكنهم فشلوا. ولذلك فإن الديان واقف قدام الباب. وكما كان معهم، هكذا الحال مع النصرانية التي لم تتجلَّ مفضوحة مثلما تتجلى في زماننا. فإن كلمة الله محتقرة، وغير ذات موضوع من كل النواحي. والعاقبة ليست بعيدة. وما دامت الكلمة محتقرة، فمن العبث أن يأتوا بتقدمات ويذبحوا ويأكلوا لحماً قدام الرب. فإنه لن يقبل عبادة من شعب متمرد مفترٍ. هو يذكر خطاياهم، ولابد أن يقتصّ منهم لأنهم رفضوا شريعته. فإلى مصر لابد أن يرجعوا، كما حدث بالفعل، إذ رجعت بقية إلى مصر في أيام إرميا الأخيرة «فقد نسي إسرائيل صانعه وبنى قصوراً (أي هياكل)». طرحوا وصاياه وراء ظهورهم، ومع ذلك أقاموا هياكل تقام فيها عبادة مزعومة. والتاريخ يعيد نفسه. فإن هذه الأقوال تصلح وصفاً للأمور السائدة في يومنا. لكن يوم الرب قادم، ولسوف تنـزل - كما في الماضي - نار من عند الله تأكل المشاريع الباطلة التي أقامها المتكبرون المتبجحون، عندما تدق ساعة الغضب (ع13،14). لنذكر هذا: إن المسؤولية تعظم طبقاً لحق الله المعلن. أذاً فما أخطر فترتنا الحاضرة، وما أخطر النتائج إذا كنا نختزن الحق في الأذهان، فهذا لا يمكن أن يغيِّر الحياة.
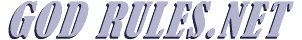 |
