
































 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
مكتبة الأخوة أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن
|
|
(ع 10- 17) في النصف الأخير من الأصحاح نتعلم من هذا الجزء الذي يمدنا بغنى وفير كيف أن الله يمنحنا هذا الإمداد لكي يحفظ شعبه من فساد المسيحية والوضع الذي يكون عليه إنسان الله في الأيام الأخيرة (ع 10و11) أولاً يقال لنا بالتحديد أن الأمان العظيم ضد كل ما هو خاطئ يكون في معرفة ما هو حق. لهذا أمكن للرسول أن يقول لتيموثاوس "أما أنت فقد تبعت (أو عرفت تماماً) تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهادي وآلامي". وليس من ضرورة تحتم معرفتي التامة للشر، بل بمعرفة الحق نستطيع أن نتبين ما هو خطأ وما هو مضاد للحق. وعندما نتبين الشر فإن التحريض ليس بأن ننشغل به بل بأن نعرض عن أولئك الذين يسيرون فيه.والحق مطروح أمامنا في تعليم الرسول الذي نجده في رسائله ويمكن تلخيصه بأنه الاستبعاد التام للإنسان وهو في الجسد بسبب خرابه الكامل ووجوده تحت سيادة الموت، كذلك دينونة الإنسان العتيق في صليب المسيح واستحضار الإنسان الجديد في الحياة والخلود في المسيح المقام والممجد، والتي أصبح المؤمنون فيها من اليهود والأمم متحدين معاً في جسد واحد للروح القدس. وأمكن للروس بولس أن يقول لتيموثاوس عن هذا التعليم "وأما أنت فقد تبعت". فبقدر ما نتعلم وندخل تماما إلى تعليم بولس بقدر ما نكن أكثر تحديداً في أن نتبين هذه الشرور في الأيام الأخيرة ونتحول عنها. وثانياً أمكن للرسول أن يحتكم إلى أسلوب حياته أو "سيرته" فقد كانت حياته في تمام التوافق مع التعليم الذي يعلم به. وبلا شك فقد كانت هناك مباينة أشد ما يمكن ما بين الرسول والمعلمين الأشرار الذين يتكلم عنهم. فقد كان حمقهم واضحاً كما كانت حياتهم تكشف عن التضاد الهائل للتقوى التي كانوا يعترفون بها. وقد تبين للجميع أن اعترافهم بصورة التقوى لم تكن لها قوة على حياتهم. ولكن ما أبعد الفارق مع الرسول. ففي تعليمه أعلن الدعوة السماوية للقديسين، وكانت "سيرته" أو أسلوب حياته في تمام التوافق مع تعليمه إذ كان غريباً ونزيلاً لأن سيرته (أو مواطنته) في السماء. إنها الحياة التي كان يحكمها الغرض أو القصد عند الرسول، فعاش "بالإيمان" مظهراً صفة المسيح في كل "أناة" و "محبة" و "صبر" "آلام" و "اضطهادات". ولذلك فإن الأمان العظيم من شر الأيام الأخيرة يكون أولاً في معرفة الحق، وثانياً في الحياة التي تتوافق مع الحق. وثالثاً في مؤازرة الرب لنا. وفي هذه استطاع بولس أن يشهد من اختباره الشخصي وهو يتحدث عن الآلام والاضطهادات التي تغلغلت في حياته، وأمكن أن يقول "ومن جميعها أنقذني الرب". فإذا اجتهدنا أن نعرف التعليم، وتم إعدادنا لكي نحيا حياة متوافقة مع هذا التعليم، عندئذ سنتحقق من مؤازرة الرب. ولربما يتركنا الآخرون كما فعلوا مع الرسول، حتى أن الناس تظن أننا نتخذ موقفاً متشدداً وأننا نرفض الحلول الوسيطة، ولكن إذ ندافع عن الإيمان سنجد أن الرب يقف معنا كما وقف معه، وأن الرب يقوينا كما قواه، ويمكننا في إعلان الحق وينقذنا من فم الأسد ومن كل عمل ردئ ويخلصنا لملكوته السماوي كما فعل معه (3: 11. 4: 17، 18). (ع 12و13). وثالثاً يذكرنا بمدى حاجتنا إلى مؤازرة الرب لنا, إذ يأتينا التحذير أن "جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون." أما صور الاضطهاد فتتباين مع الأزمنة المختلفة والأماكن المختلفة، ولكن الحقيقة تبقى أن من يريد أن ينفصل عن شرور المسيحية ويجتهد للتمسك بالحق فإنه يجب أن يعد نفسه للإهانات والأذى والترك وحيداً. وإلا فكيف نجد في المسيحية ذاتها "الناس الأشرار يتقدمون إلى أردأ مُضلِين ومُضلَين"؟ (ع 14) ورابعاً في مواجهة الشر فإن التقى يجد الأمان والمؤازرة بثباته في ما تعلمه من الرسول. ولذلك يكتب إلى تيموثاوس "وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفاً ممن تعلمت". وهنا نجد لثالث مرة في هذا الجزء القصير من رسالة بولس أنه يؤكد أهمية، ليس فقط أن نمتلك الحق بل في نواله من مصدر الوحي الذي نتمسك به بيقين كامل (أنظر 1:3، 2: 2). وبالاختبار تبرهن أيضاً أن المؤمنين ليس بمقدورهم مواجهة الشر لأنهم ليسو متيقنين تماماً من هذا الحق. ونحتاج في مواجهة الشر خاصة الشر الممتزج بالحق أن يكون لدينا تأكيداً مطلقاً بأن ما تعلمناه هو الحق. وهذا اليقين يمكن أن نمتلكه بمعرفة الرسول الذي سلمنا الحق والذي تحدث بسلطان الوحي. أما المعلم فيمكنه أن يستحضر الحق أمامنا, مع أنه ليس هناك معلم يمكنه أن يتكلم بسلطان الوحي، إذ عليه أن يوجهنا إلى كتابات الرسل الموحى بها إذا كان علينا أن نتمسك بالحق في الإيمان واليقين. وفي مواجهة الأشرار والمزورين الذين يتقدمون إلى أردأ ويستحضرون أشكالاً جديدة للشر، فإنه علينا أن نتحذر جيداً من الذين ينادون بأفكار جديدة لكي نثبت فيما تعلمنا. (ع 15- 17) ولذلك فإن الأمان في النهاية ضد الشر هو في وحي الكتب المقدسة وكفايتها أما الناس فلا تكف عن النظريات الجديدة والمتغير والتي لا تنتهي، ولكن في الكتاب المقدس لنا كل حق نافع ومحفوظ في صبغة دائمة، محروسة من الشر بالوحي، ومستحضرة لنا بسلطان إلهي. وبلا شك فإن الكتب المقدسة التي عرفها تيموثاوس منذ طفولته كانت هي أسفار العهد القديم، ولكن إذ يقرر الرسول أن "كل الكتابات هي موحى به من الله"، فإن ذلك يتضمن العهد الجديد مع كل الكتابات الرسولية. ونعرف أن بطرس يضع كل رسائل بولس مع الكتب الأخرى (2بط 3:16). وعلاوة على ذلك فإنه يضع أمامنا الفائدة العظيمة للكتاب. فأولاً تعطينا المقدرة أن نكون حكماء للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، وثانياً فهي تقودنا إلى المسيح لنجد فيه الخلاص لنكتشف أن كل الكتابات هو نافع للمؤمن، كما أن ناموس موسى والأنبياء والمزامير نجد أن فيها أموراً تختص بالمسيح (لوقا 24: 27و44). كذلك كم يكون مفيداً الكتاب للتوبيخ وللأسف قد نكون في عمى تجاه أخطائنا أو قد ننحصر في ذواتنا فنصم آذاننا عن اعتراضات الآخرين ولكن لو خضعنا للكلمة سنجد أن الكتاب يستحضر لنا التوبيخ لأنها "كلمة حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين ومميزة أفكار القلب ونياته". وفضلاً عن ذلك فإن الكتاب لا يدين فقط ولكنه نافع أيضاً للتقويم، وليس التقويم فحسب بل التأديب أو تعليمنا الطريق الصحيح. وإنسان الله يمكنه بكتابات الوحي أن يبنى في الحق لمواجهة الشر المتزايد ليكون "كاملاً ومتأهباً لكل عمل صالح" في اليوم الشرير. رأينا في الأصحاح الثالث كيف أن الرسول يسبق فينبئنا بالحالة المرعبة التي ستنحط إليها المسيحية المعترفة في الأيام الأخيرة، وعليه فإنه يذكر المؤمنين بالمئونة الغنية التي أعدها الله لكي يتجهزوا بها لكل عمل صالح في الزمان الذي تكثر فيه الشرور. وبعد أن يرينا خراب المسيحية المعترفة ومصادر التقى، فإن الرسول بولس في الأصحاح الرابع يعطينا التعليم الخاص بخدمة الرب في وقت الفشل العام. والخبرة تقول لنا أنه في زمان ازدياد الشر بين المسيحيين المعترفين والضعف الذي يسود شعب الله، فإن الخادم يصيبه الإحباط مع الخوار والإعياء في خدمته. من هنا كانت أهمية هذه التعاليم التي يسجلها كاتب الرسالة، فبدلاً من أن تصبح هذه الحالة المؤسفة للمسيحية والتي لا أمل فيها. سبباً في فتور همة الخادم، فإنها تدفعه بالأكثر إلى خدمة غيورة ونشيطة. (ع 1). ويفتتح الرسول هذا الجزء من تعليمه بأن يستحضر الأسس التي يقيم عليها نداء للمؤمنين بالمثابرة في خدمتهم للرب. إنه يتحدث بكل وقار أمام الله والمسيح يسوع وهما المراقبان العظيمان لمركزنا وما نقف عليه، وهو يدفعنا لكي نخدم بالنظر إلى ثلاثة حقائق عظمى. أولاً. المسيح كالديان للأحياء والأموات. وهو الذي يحكم على الطريق الذي نسلكه وعلى حالتنا في هذه الطريق. هذا فضلاً عن أن حالة المسيحيين المعترفين على غالبيتهم العظمى غير متجددين ولا بد أنهم سيأتوا إلى الدينونة، سواء كانوا أحياء عند ظهور المسيح، أو حسبوا في عداد الأموات وعند ذلك سيقفون أمام العرش الأبيض العظيم. من هنا أصبح لزاما أن نحذر الناس من الدينونة الآتية وأن نشير نحو المخلص. ثانيا: يشجعنا بولس أن نستمر في خدمتنا بهذا الحق العظيم وهو ظهور المسيح. والترجمة الدقيقة "وبظهوره"* وليس "عند ظهوره حقيقة أخرى ومتميزة عن دينونة الأحياء والأموات، أنه لا يتحدث عن الاختطاف بل عن ظهوره للحكم. لأن مكافأ الخدمة ترتبط دائماً بالظهور. وتقول الكلمة "ها أنا آت سريعاً. وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله" (رؤ 22:12). ثالثاً: ونحن نتشجع للخدمة "بملكوته" فكا نفس خلصت بكرازة الإنجيل ستضم إلى مجد المسيح للحكم وللتمجيد في قديسيه. فسواء كانت دينونة الأشرار أو مكافأ الخادم أو مجد المسيح، فهناك دائماً الباعث للخادم أن يثابر في خدمته. (ع 2). وبعد أن يقرر لندائه فإن الرسول يعطيه الوصية لكي يخدم. فإن كان الناس مسئولين أمام الله. لذلك "أكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب". وإذا كان المسيح سيدين، لذا "وبخ" و "انتهز" الذين يعيشون بسلوك يأتي بهم إلى الدينونة، فإذا كان القديسون سيكافئون عند ظهور المسيح، لذلك "عظ (أو انهض) بكل أناة وتعليم". فالخادم يعلن "الكلمة"، إنها ليست فقط إعلان الإنجيل للخاطئ، بل إنها كلمة الله سواء للخاطئ أو للقديس فالضرورة ملحة كذلك لأن نعكف على التبشير وعلى الكرازة في كل وقت . إن كلمة الله لجميع الناس وفي كل الأزمنة. "والتوبيخ" و "الانتهار" تقال ككل من القديسين والخطاة. وهذا يتم فقط عند الكرازة بالكلمة، فهي الكلمة وحدها التي تنتج التوبيخ. ربما نستخدم في التوبيخ والانتهار كلمتان نحن فتنتهي مناقشاتنا عادة بالاستياء، ولكن لو رغبنا أن يكون التوبيخ فعالاً فيجب أن يقوم على كلمة الله. فالذين يريدون أن يخضعوا للكلمة ويقبلوا انتهارها وتوبيخاتها فلهم أيضاً الوعظ (أو التشجيع). وكيفما كانت صيغة الخدمة التي تقوم بها فيجب أن تمارس بكل طول أناة وبحسب الحق أو التعليم. وبكل تأكيد فإن الكلمة تثير عداوة الجسد وهذه تستدعي طول الأناة من جانب الخادم، والإجابة الفعالة الوحيدة لهذه المقاومة هي في التعليم أو الحق الكتابي. (ع 3 و 4).. في العدد الأول كان خادم الله يتطلع إلى ما وراء المرحلة الحاضرة، وعلى ضوء الأمور الآتية التي كانت هي الدافع له لكي يعكف على الخدمة. ومرة أخرى فإنه الآن يتطلع إلى نهاية التدبير المسيحي، فيستخدم الأحوال المرعبة التي توجد بين المعترفين المسيحيين كدافع جديد لكي يخدم بنشاط. ولقد سبق أن تحدث عن معلمين كذبة يدخلون البيوت، وهو الآن يتحدث عن هؤلاء الناس أنفسهم. وساء فشل المعلمون أم لأن فسيأتي الوقت الذي يصبح الناس فيه لديهم "مسامع مستحكة" ولا يحتملون فيه التعليم الصحيح، ولكن بحسب شهواتهم يجمعون لهم معلمين. وليس هذا هو وصفاً للوثنيين الذين لم يسمعوا الحق من قبل بل إنهم المسيحيون الذين سمعوا الإنجيل ولكنهم لم يحتملوه. ومع ذلك فإنهم لم يتخلوا عن كل اعترافهم بالمسيحية بل لا يزالون يجمعون لأنفسهم معلمين أولئك المعلمين الذين لا يجدون في الكرازة بالحق إشباعاً لملذاتهم. والفكرة السائدة بين بعض الجماعات من المسيحية المعترفة التي تختار لنفسها معلماً, إنما هي فكرة غريبة عن الكتاب، وترينا كم تباعدت المسيحية وتحولت عن ترتيب الله في كنيسته. ونتيجة هذا التشويش أنه غالباً ما يكون هذا المعلم المختار قائد أعمى لعميان، "وإن كان أعمى يقود أعمى فكلاهما يسقطان في حفرة" (متى 15: 14). ولذلك فعندما تصرف الناس مسامعها عن الحق "تنحرف إلى الخرافات". (ع 5) فإذا كانت حالة المسيحية أصبحت مفزعة إلى الحد الذي فيه أن أولئك المعترفين بالمسيحية لا يحتملون التعليم الصحيح، ويتبعون شهواتهم، وقد تحولوا إلى الخرافات، فإنه يتعين على الخادم أن يصحو في كل شيء وإذ يتشكل حكمه بحسب الحق فإنه لا يسمح لفكرة أن يتأثر بالشرور والخرافات التي تسود جموع المسيحيين. كان التحريض لنا "احتمل المشقات للأجل الإنجيل" وأيضاً أن "نشترك في احتمال المشقات" كجدي صالح ليسوع المسيح، "وأخيراً لنا هذا التحذير" جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون (1: 8، 2: 3، 3: 12). ثم نحذر بعد ذلك إذ يجب أن نكون مستعدين أن "نحتمل المشقات" بسبب شرور المسيحية. ولذلك فإن الأمين يجب أن يكون مستعداً للآلام لأجل الإنجيل، لأجل يسوع المسيح، وعلى أساس من التقوى المسيحية، بالنظر إلى شرور تلك الأيام. وفضلاً على ذلك، فكيفما كان شر تلك الأيام، وطالما بقي زمان النعمة، فإن إنسان الله مهما كانت موهبته فعليه أن يستمر في عمله كمبشر. إن هجران غالبية المسيحيين للحق مع الأكثرية ممن تسمى نفسها كنائس التي استسلمت للروح العالمية والخرافات هذا كله يعطى إلزاماً أكثر على إنسان الله أن يستمر في عمله كمبشر وأن يتمم خدمته إلى قياسها الكامل. فإن عمل الرب لا يجب أن يعمل جزء منه فقط بل علينا أن نتمم إلى النهاية ما أعطانا إياه لكي نعمله. (ع 6). ويأتي هنا رحيل خادم المسيح كدافع آخر لخدمته كانت حياته التقوية تقترب من النهاية.، وبالتالي كان الاضطهاد الذي كان سيقع عليه من العالم قريباً جداً حتى قال "إني الآن أسكب سكيباً" إنه يتحدث عن رحيله كأنه وقت انحلال أو انطلاق. فمن جهته عندما يترك هذا المشهد فمعناه أن يتحرر من هذا الجسد الذي قيده عن المسيح،ولكنه يشير إلى تيموثاوس بهذا السبب إذ أكمل خدمته. ومن ذلك اليوم كم كان رحيل الخادم التقي باعثاً من الرب لدفع آخرين هنا تركوا لخدمة نشيطة. (ع 7) ومع أن الكنيسة كانت على وشك أن تحرم من قيادة الرسول النشيطة، فإنه كمثال يبقى لتشجيعنا. وهنا نجد بولس قبيل رحيله يتطلع إلى ما الوراء ناظراً إلى طريقه كخادم ويتطلع إلى يوم المجد الآتي عندما تجد خدمته المكافأة المنيرة. ففي تطلعه للوراء أمكنه أن يقول "جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان". ففي زمان الرسول كان الإيمان يهاجم بعنف من كل اتجاه ولا يزال هكذا يهاجم إلى يومنا هذا. فمن خارج الدائرة المسيحية كان يهاجم بالطقوس اليهودية والفلاسفة الوثنيين. ومن داخل المسيحية المعترفة كان أولئك الذين "زاغوا من جهة الإيمان" (1تي 6: 21) والبعض الذين صاروا "من جهة الإيمان مرفوضين" (2تي 3: 18). ولذلك في مواجهة الذين يهاجمون من الداخل ومن الخارج أمكن للرسول أن يقول "جاهدت الجهاد الحسن". إنه حارب لأجل الإيمان وقد حفظ الإيمان. إن الإيمان هو أكثر من إنجيل الخلاص. إنه يدور حول المسيح يتضمن أمجاد شخصه وعظمة عمله. إنه يتضمن الحق الكامل للمسيحية. لقد حارب الرسول بكل جسارة لأجل الإيمان، رافضاً أن يسمح لأي اعتداء عليه من أي جانب ولم يسمح لأية محبة كاذبة أن تتدخل في دفاعه بصلابة عن مجد المسيح سواء في شخصه أو في عمله. (ع 8) وإذا قد حارب المحاربة الحسنة، وأكمل السعي، وحفظ الإيمان، أمكنه أن يتطلع بيقين عظيم إلى المستقبل ويقول "وأخيراً قد وضع لي إكليل البر" لقد سبق له أن سار في طريق البر، واتبع تعليم البر (2: 22، 3: 16) والآن يتطلع أن يلبس إكليل البر. علاوة على أن إكليل البر سيعطى للرسول من الرب الديان العادل. لقد دافع عن حقوق الرب في زمان رفضه وسينال إكليل البر في زمان مجده. أما الإنسان فقد كافأ الرسول بالسجن، وقديسون كثيرون تخلوا عنه، والبعض قاوموه وهذه جميعها حسبها أنها "أقل شيء" عنده أن يحكم عليه من القديسين أو من الناس، إذ إن الرب هو الذي يحكم فيه (1كو 4: 3- 5) إنه لم يقل أن حك القديسين عليه سواء بالأمانة أو بخلاف ذلك من جهة مسلكه لا يعتبره شيئا, بل بالمقارنة مع حكم الرب يصبح "أقل شيء" عنده. وغالباً ما تكون أيضاً أحكامنا, أحدنا نحو الآخر، معوجة بأشياء في شخصياتنا وباعتبارات ذاتية. أما الرب فهو الديان العادل. ولثالث مرة في الرسالة يشير الرسول إلى "ذلك اليوم" (1: 12و18، 4: 8) ففي كل آلامه واضطهاداته والتخلي عنه والإهانات التي لاقاها, فإن ذلك اليوم يضيء أمامه بلمعان إنه يوم ظهور الرب فكم من أشياء لا نقدر أن نفهمها أو أن نحل لغزها. وكم من ترك وإهانات تلحقنا فتجعلنا نصمت عندما ننظر إلى ذلك اليوم. ولكن في هذه جميعها نجد الراحة عندما نسلم الكل للرب الديان العادل. عندما يستحضر في ذلك اليوم كل شيء إلى النور عندما ينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله (1كو 4:5). هذا علاوة على تشجيعنا إذ نخبر بأن إكليل البر ليس محفوظاً فقط للرسول أو الخادم الموهوب، بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً. فقد نظن أن إكليل البر محفوظ للنشاط الفائق في عمل الرب، أو للذين هم في المقدمة أو يقودون شعب الله فقط، ولكن الكلمة لا تقول أن الإكليل للذين هم في المقدمة أو يقودون شعب الله فقط، ولكن الكلمة لا تقول أن الإكليل للذين يعملون أو للذين لهم شهرة، بل للذين يحبون –بأنها محبة ظهوره أيضاً. والحقيقة فإن الموضوع العظيم لهذا الجزء من الرسالة لتشجيع الخادم لكي يعمل بل ليحرص الخادم أن يكون عمله محكوماً بالمحبة. إن محبة ظهوره تتضمن المعنى أننا نحب ذاك الذي سيظهر. كما أن محبته تعني أننا نحب أن نفكر في اليوم عندما يأتي –الذي هو الآن مرفوض ومحتقر من الناس، ولكنه "سيتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين". وفضلاً عن ذلك فإن محبة ظهوره تفترض أننا نسير في الحكم على ذواتنا, لذلك نقرأ "كل من عنده هذا الرجاء (رجاء أن نكون مثل المسيح عندما يظهر. به يطهر نفسه كما هو طاهر)" (1يو 3: 3). وفي الأعداد الختامية من الرسالة لنا صورة جميلة عن غنى نعمة المسيح، وعواطف المسيح ومسرات الرب. التي تربط القديسين الأفراد معاً. إنها حلوة دائماً فكم تكون أكثر حلاوة لنفوسنا الآن فيوقت الضعف والفشل عندما يتكلم الخائفون الرب. الواحد مع الآخر. (ع 9) ويعبر بولس عن رغبته في أم يرى تيموثاوس محبوبه الغالي (1: 4) والآن بالنظر إلي سرعة رحيله فإنه يلح عليه بسرعة المجيء إليه. (ع 10و11) إنه اشتاق أن يرى تيموثاوس كثيراً إذ أصابته خسارة من رفيقه في العمل، ديماس الذي ترك الرسول وأحب العالم الحاضر. لم يقل أن ديماس قد ترك المسيح، ولكنه وجد من المستحيل أن يسير مع شخص تقي ممثل للمسيح وفي ذات الوقت يحتفظ بالعالم الحاضر فلا بد من ترك أحدهما. وللأسف فقد ترك بولس واختار العالم. وآخرون فارقوه، ولكنهم فارقوه بلا شك لأجل خدمة الرب. بقي لوقا وحده معه –هذا الرفيق الأمين ممن كانوا يعملون بنشاط معه، وهكذا ظل معه حتى في لحظات موته، وبسرور يكتب الرسول مظهراً تلك المحبة المكرسة. ويرغب الرسول بصفة خاصة من تيموثاوس أن يحضر معه مرقس . وفي وقت سابق كان مرقس قد تحول عن العمل وعن الرسول، وبسبب ذلك رفض الرسول بكل أمانة أن يأخذ معه مرقس في رحلته الثانية في خدمة الرب، وكان حكمه أن خدمته لن تكون نافعة. كان فشل مرقس قد حكم عليه ولذلك استبعد هذا الشعور من الرسول تمامً ولا يلمح بأي إشارة إلى هذا الفشل. وهذه هي الإشارة الوحيدة عن مرقس ولا نعرف أي فشل آخر يرتبط بخدمته. وعلى كل فإن بولس قد استودعه بصفة خاصة إلى كنيسة كولوس (كو 4: 10) والآن يرغب في حضوره. والشيء الملفت للملاحظة بصفة خاصة انه في الشيء الذي فشل فيه أصبح هذا الخادم الذي ردت نفسه أكثر خدمة ونفعا, إذ قال الرسول "إنه نافع لي للخدمة".
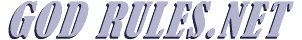 |
