
































 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
مكتبة الأخوة أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن
|
|
(ع 1) إن النعمة الروحية هي الضرورة الأولى والعظمى في يوم الضعف، ولذلك فالتحريض في افتتاحية العدد "فتقو أنت يا بني بالنعمة التي في المسيح يسوع" ولكي ما نواجه تيار الشر الممتد، ونقف في طريق الرب الذي وصفه الرب لخاصته في وسط تشويش المسيحية، ونستمر في سيرنا بثبات في هذا الطريق بالرغم من الفشل والمقاومة والتخلي، فهذا يستدعي نعمة عظيمة - النعمة التي في المسيح يسوع. وكيفما كانت المقاومة في طريق الله، وكيفما كانت الصعوبات المستمرة في الطريق، وكيفما كانت التجارب التي تأتي من الطريق، فإن نعمة الرب كافية لتمكن المؤمن من أن يتغلب على كل المقاومات، وأن يرتفع فوق المصاعب، ويقاوم كل تجربة، ويطيع كلمته ويجيب عن فكره. كما قال واحد "كيفما كان الاحتياج فسيبقى ملؤه كما هو بعينه بلا نقصان وفي متناول اليد وفي حرية العطاء. إن النعمة روحياً هي المطلب الأساسي والأولى للشخص الأمين في زمان عدم الأمانة. وهكذا عندما يتكلم الرسول عن النعمة هنا فهو يعني في كلامه أكثر من روح السخاء واللطف. إنها تتضمن في المسيح المقام والصاعد منذ بداية الكنيسة على الأرض إلى آخر يوم في بقائها هنأن إذ تبقى مصدراً حقيقياً دائماً لإنسان الله لكي يعيش حياة شاهدة وخدمة بدون تحفظ، حتى إن كثيرين جداً اختيروا لإظهار تلك النعمة في زمن الحيود والانحراف وإذ يكتب الرسول للكورنثيين، فإنه يشكر الله لأجل "نعمة الله" المعطاة لهم "في المسيح يسوع"، ثم يريهم إن هذه النعمة هي "كلمة التعليم" والعلم" أو "المعرفة" و "المواهب" الذين صاروا أغنياء فيه أي في المسيح (1كو1: 4- 7). فكل تحريض في الإصحاح إنما يعمق فقط إحساسنا بالاحتياج للنعمة التي في المسيح إن كنا نجيب عن فكر الله. (ع2) وثانياً, فليست النعمة هي المطلوبة فحسب، بل إن الأمناء يجب أيضاً أن يمتلكوا الحق إذا كانوا مؤسسين على فكر الله في مواجهة زمن الفشل وأن يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين. وليس الحق في صورته الإجمالية هو المطلوب في زمن الخراب فحسب، بل إن الحق المرتبط بالرسول بواسطة الشهود الأمناء. وفي زمان الخراب فإن الكتابات الرسولية تصبح هي المحك الدقيق لتمييز الأمناء، "نحن من الله" قال الرسول يوحنا "فمن يعرف الله يسمع لنا, والذي ليس من الله لا يسمع لنا" (1يوحنا 4: 6). ولكي ما نمتلك الحق في كل زمان، فإن تيموثاوس يسلم الأشياء التي سمعها إلى رجال أمناء، الذين بدورهم يكونون قادرين أن يعلموا آخرين. إنه طريق الله أن نجد الحق في غناه مكنوزاً في الكتابات الرسولية التي يودع لمن هم قادرين أن يعلموا آخرين. إن الاكتفاء بالذات والمشغولية بالذات النابعة من الجسد قد تمدح نفسها وتستغني عن مساعدة الآخرين، ولكن الله في مطلق سلطانه وهو قادر أن يعلمنا مباشرة من كلمته، إنما يرينا طريقته التي يستخدمها لكي يجعلنا في اعتماد متبادل أحدنا بالآخر لكي نتعلم وأن يشارك أحدنا الآخر النور والحق الذي قبلناه. علاوة على ذلك فمن المهم أن نرى أننا لسنا أمام سلطان رسمي ولا مركز رسمي بل أمام الحق. وليس أمام تيموثاوس أي تفويض أو قوة ليمنحها لفرد أو لجموع من الأفراد فتصبح لديهم وحدهم أو لغيرهم الحق الرسمي للتبشير. إنه الحق المعلن، وضمان خلوه من الخطأ بواسطة الشهود والذي كان عليه أن يسلمه لآخرين. وفي ضوء هذا المكتوب فإننا في وضع التحدي لأنفسنا لنرى إلى أي مدى تباعدنا عن مسئولياتنا في أن نسلم الآخرين ميراث الحق الثمين الذي تعلمناه من الأمناء. وللحفاظ على هذا الحق وتسليمه للآخرين فإنه يتطلب فقط أن نتقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. (ع3) وحفظ الحق في زمان الارتداء العام في المسيحية يتضمن الآلام. ونحن عادة ما نجزع من الألم، ولذلك فإن تيموثاوس يحرص.. وكل واحد منا يرغب أن يكون حقاً للمسيح أيضاً أن "يشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح" وبالمقارنة مع بولس الذي اشترك فسي حمل المشقات التي دعينا إليها, فنصيبنا فيها قليلاً. وعلى كل فإن أي قديس يرفض الخطأ ويقف في صف الحق عليه أن يعد نفسه بقدر ما لمواجهة المقاومات (2 : 25)، والاضطهاد (3 :12)، والترك (4 :10)، والحقد (4 :14) وكما حدث مع الرسول فإن هذه الأشياء وقعت عليه حتى من إخوته. وعندما نتعرض للألم ظلماً فإننا نميل بالطبيعة إلى الانتقام، ولذلك يجعلنا نتذكر بأن نشترك في الآلام لا كإنسان طبيعي بل كجندي صالح ليسوع المسيح، فالجندي الصالح يطيع قائده ويعمل مثله. والمسيح هو قائد خلاصنا العظيم، وقد وصل إلى مكانه بالمجد بالآلام، تاركاً لنا مثالاً كاملاً في احتمال الآلام بالبصر، وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل (1بط 2:23). ولكي ما نسلك في طريق مخالف للطبيعة فهذا يتطلب حقاً أن نتقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. والرب يسوع هو في مكان القوة الفائقة الآن، وسيستخدم قوته هذه في إخضاع كل أعدائه تحت قدميه في المستقبل القريب ومع أنه لا نزال في يوم النعمة غير أن يوم القضاء على الأعداء لم يأت بعد، ولذلك لا نحتاج إلى القوة لسحق الأعداء بل إلى النعمة لنشترك في الآلام. واسطفانوس في مواجهة أعدائه، الذين كانوا يصرون بأسنانهم عليه وهم يرجمونه بالحجارة، لكنه شخص إلى السماء حيث كان "يسوع قائماً عن يمين الله" ومع أن يسوع هو الرب الذي يتخذ مكان القوة العليا الآن غير أنه لا يعمل عموماً بالقوة لسحق أعداء خدامه، ولم يمنح اسطفانوس قوة لسحق أعدائه. إنه يعمل لحفظهم حفظاً كاملاً في زمان النعمة وهو يعطي النعمة التي تجعل اسطفانوس يتقوى بتلك النعمة التي في المسيح يسوع ليصبح قادراً أن يشترك في الآلام، وكجندي صالح ليسوع المسيح فإنه لم يهدد أو يشتم مضطهديه، بل على العكس فإنه صلى لأجلهم واستودع روحه للرب. كذلك بولس في زمانه، الذي كان متقوياً جداً بالنعمة التي في المسيح يسوع فجعلته يحتمل الآلام لأجل خاطر المسيح، ولقد استودع حياته وسعادته وكل شيء للمسيح إلى "ذلك اليوم" (1 :12). (ع4) ورابعاً إذا كنا نقبل طريق الله بقلب كامل في زمان الخراب، فإنه يتعين علينا بالضرورة أن نحفظ أنفسنا من الوقوع في شراك أعمال هذه الحياة. ولكن الرسول لم يعني بذلك أننا لا نولى العناية بأعمال الحياة، أو أنه ألزمنا بضرورة التخلي عن أعمالنا وحاجاتنا الأرضية. ففي مواضع أخرى في الكتاب يدحض أفكاراً كهذه، ويطينا تعليماً محدداً بأن نعمل بأيدينا لنوفر احتياجاتنا بكل أمانة، وأمكن أن يقول عن نفسه "أنتم تعلمون أن حاجاتي خدمها هاتان اليدان" ولكنه يحذرنا من السماح لأعمال هذه الحياة أن تأخذ كل وقتنا, وتستهلك طاقاتنا, وتستنفذ تفكيرنا فنقع في شراك هذا الشباك، ولا نعد قادرين على تتميم إرادة الرب. فالجندي الصالح ليسوع المسيح هو من يسعى لا لكي يسر نفسه أو يسر الآخرين، لكن أولاً وقبل كل شيء آن يسر ذلك الذي اختاره أن يكون جندياً. والولاء الخالص لذاك الذي اختارنا جنوداً تحت قيادته، ساعين فقط لمسيرته، فإنه يتعين علينا أن نرفض كل تنظيم بشري يتضمن التوجيه من سلطة بشرية . ولكي ما نهرب من شباك هذه الحياة ونصبح في ولاء لرئيس خلاصنا, فإن هذا يتحقق فقط إن كنا أقوياء بالنعمة التي في المسيح يسوع. (ع 5) خامساً: يقول الرسول مستخدماً تشبيه الألعاب والمباريات العامة. "وأيضاً إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونياً". كذلك في المجال الروحي فإن الإكليل لا يمنح لأجل نشاط عظيم ولا لكثرة الخدمة ولكن للأمانة في الخدمة. فالإكليل يعطى لمن يجاهد قانونياً. قد يقال من البعض أنه عندما يزداد الضعف فعلى كل منا أن يختار الوسائل التي تظن أنها الأفضل لتتميم خدمتنا – وقول كهذا غير صحيح، ونحن نحذر بصفة خاصة في زمان الخراب علينا أن نلتزم بأن نجاهد قانونياً. ولذلك فإن تقديم الطرق الجسدية والاختراعات البشرية والحيل العالمية في خدمة الرب محكوماً عليها بالرفض والإدانة. وإذا أردنا أن نخدم بحسب مبادىء الكتاب فهذا يتطلب أن نتقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع. (ع 6) سادساً: والخادم الأمين يجب أن يعمل قبل أن يشترك في الأثمار وليس هذا الوقت هو وقت الراحة بل وقت العمل وزمن الحصاد سيأتي. وغالباً ما نكون شغوفين برؤية الثمر، ولكن من الأفضل أن نثابر في أعمالنا, عاملين أن الله ليس بظالم حتى ينسى "عمل الإيمان وتعب المحبة". إن الخادم الأمين ينتظر أن يسمع من ذاك الذي يسعى لأن يسره "نعماً"، لكي ينال الإكليل بعد الجهاد القانوني، ولكي يشترك في الأثمار بعد التعب والمشقة. (ع 7) وعلى كلٍ، فلا يكفي أن تكون لنا هذه التحريضات، ونقبلها بشكل عام كحق. فإذا كانت تحكم حياتنا, فإنه يجب أن نتأمل ما يقوله الرسول، وكما أمعنا النظر في هذه الأشياء فإن الرب يعطينا فهماً في كل شيء. وسيكون تقدمنا بطيئاً في فهم الأمور الإلهية ما لم يكن لنا الوقت للتأمل والفهم. والرسول يمكنه أن يضع أمامنا الحقائق الأكيدة ولكنه لا يقدر أن يعطينا الفهم. فهذا يفعله الرب وحده، ولذلك نقرأ أن الرب ليس فقط فتح الكتاب أمام تلاميذه، ولكنه فتح أيضاً ذهنهم ليفهموا الكتب (لوقا 24: 27 و32 و45). (ع 8) وفضلاً على ذلك، فلكي يشجعنا أن نحفظ هذه التحريضات، فإنه يركز أنظارنا على المسيح. "اذكر يسوع المسيح المقام من بين الأموات من نسل داود بحس إنجيلي" فإنها ليست ببساطة حقيقية القيامة فحسب التي علينا أن نتذكر، بل ذاك الذي أقيم، وهو كإنسان من نسل داود . فهل دعينا أن نتألم في طريق الأمانة؟ ودعونا نتذكر أن نصيبنا في الألم قليل إذ قورن بالألم الذي تحمله السيد. فإذا كان بسبب أمانتا القليلة التي صارت من نصيبنا نجد أنفسنا وحيدين ومقاومين ومهانين حتى من بين كثيرين من شعب الله، فلنتذكر أن المسيح في طريقه الكامل كان أميناً لله وكان يصنع خيراً للناس،وبسبب أمانته لاقى التعيير الدائم. ولذلك أمكنه أن يقول: "من أجلك احتملت العار" وأيضاً "وضعوا على شر بدل خير وبغضاً بدل حبي" (مز 69: 7،109: 5). وإن كان في طريق الخدمة نحرض باحتمال اللم، ساعين فقط لإرضاء من اختارنا, فلنتذكر أن المسيح أمكنه القول "إني أفعل كل حين ما يرضيه" (يو 8: 29). ولا شيء استطاع أن يدفع الرب بعيداً عن طريق الطاعة المطلقة للآب. لقد عمل بحسب ثمر تعبه، فأمكنه أن يقول "ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني، مادام نهار " (يوحنا 9: 4) والآن قد أكمل عمل الله الذي أعطاه إياه أن يعمله لقد انقضت أعماله وآلامه ونراه الآن مقاماً ومكللاً بالمجد والكرامة، وهو هناك لينال بقيامته ثمر تعب نفسه. ليتنا ونحن عابرين في الطريق بما لنا من آلام وأتعاب محددة أن "أن نذكر يسوع المسيح المقام". (ع 9) وليس فحسب لنا النموذج الكامل لربنا يسوع في طريق آلامه وأتعابه، بل لنا كذلك الرسول بولس كمثال، ساعياً لجعل الإنجيل معلناً, وقد اشترك بقدر غير قليل في الآلام التي تتصف بها حياة المسيح. وبدلاً من الكرامة التي ينالها في هذا العالم فإنه تألم حتى القيود كمذنب أو كفاعل شر. ولها اتبع آثار خطوات سيده الذي في زمانه اتهمه العالم الديني بأنه "أكول وشريب خمر "، وأن "به شيطان " وأنه "خاطىء" (لوقا 7: 34، يوحنا 8: 48، 9: 24). وعلى أية حال فإن الاضطهاد الذي يأتينا من العالم لا يعوق البركة التي من نصيب مختاري الله. فقد يقيد العالم الكارز ولكنه لا يقدر أن يقيد كلمة الله. حقاً فإن عداوة العالم صارت فرصة لتقديم الإنجيل لعظماء الأرض. وعلاوة على ذلك فقد كتب الرسول رسائل السجن التي أظهرت دعوتنا بطريقة عجيبة . (ع 10) قد لا نكون مستعدين لاحتمال الكثير من الآلام أو الإهانات، ولكن الرسول أمكنه أن يقول "أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلوا هم أيضاً على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي "قال واحد: "}القليلون هم الذين يخاطرون بمثل هذا القول على اعتبار أنه اختبارهم الشخصي! وهم قليلون كذلك منذ أيام الرسول إلى الآن. وعلى الرغم من ذلك فقد تكون هذه رغبتنا الجادة على قدر طاقتنا الضعيفة. ولكنها تفترض في المؤمن ليس فقط الضمير الصالح والقلب الملتهب بالمحبة، بل أيضاً إدانة نفسه تماماً وان المسيح ساكن في قلبه بالإيمان{ (وليم كيلي). إن مختاري الله لا بد أن يحصلوا على الخلاص ويصلوا إلى المجد. بالرغم من هذا ففي طريق المجد تصطف ضدهم كل قوة إبليس وعداوة العالم وخراب المسيحية. ولذلك ففي طريق التجربة والألم فإنهم سيصلون إلى المجد. ولإحضار المختارين في وسط هذه الظروف فإنهم يحتاجون إلى كل "النعمة التي في المسيح يسوع" والمخدومة بواسطة خدامة الأمناء. (ع 11و 12). ولكي ما يشجعنا في تذكر يسوع المسيح، وإتباع الرسول كمثال في قبوله طريق الألم والتعب، فإنه يذكرنا بهذا القول الأمين "إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه". وإذا كنا قد دعينا أن "نصبر على كل شيء" حتى الموت، فليتنا لا ننسى أنه بمقدورنا أن نتحمل الحياة الحاضرة في ضوء هذا الحق العظيم أنه إذا متنا مع المسيح فبالتأكيد أننا سنحيا معه. وليس فحسب "سنحيا معه"، بل "إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه". (ع 12 و13) وعلى أية حال فإننا نجد التحذير الخطير: "إن كنا ننكره فهو أيضاً سينكرنا, إن كنا غير أمناء فسيبقي أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه". والإنكار هنا ليس السقوط مهما كان مخجلاً كما في حالة الرسول بطرس، بل هو الاستمرار في هذا الطريق لهؤلاء الذين كيفما كان اعترافهم الظاهري، فإنهم بذلك ينكرون مجد الابن وعمله. إن البعض ينكرونه، كما قيل بحق }إن الله لن يكون هو الله إذ قبل إهانة ابنه{. ومع كل عدم أمانة المسيحية من نحو المسيح فإنه يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه. ولذلك ففي مستهل هذا الجزء الهام والمبارك الذي يوضح لنا بجلاء انه لكي نميز طريق الله في زمن الخراب، وفوق الكل لكي نرتاد هذا الطريق بأمانة في مواجهة الخبث وتخلي الآخرين عنا ومقاومتهم لنا فإننا لا نحتاج إلى القوة الإلهية لسحق أعدائنا, بل للنعمة التي في المسيح يسوع التي تجعلنا قادرين أن نشترك في الآلام، النعمة التي تقودنا أن نجاهد قانونياً رافضين كل الطرق العالمية والجسدية، النعمة التي تجهزنا لتعب صابر بينما ننتظر ثمار تعبنا. وفضلاً على ذلك، فإننا نطلب ليس فقط النعمة المخدومة من الرب الممجد، بل الإدراك الروحي بأن الرب وحده هو الذي يعطي، وفوق الكل أن يكون لنا الرب نفسه أمامنا كالغرض الوحيد. الإنسان الحقيقي الذي من نسل داود، هو الإنسان الحي في المجد فوق كل قوى الموت. ورأينا في مستهل هذا الإصحاح الذي أمامنا الحالة الروحية التي يلزم أن تصف الأمناء وأمكنهم أن يميزوا التحول الخطير عن الحق، وأيضاً طريق اله في وسط الخراب. وقبل أن نضع أمامنا طريق الله، فإن الرسول في الأعداد من 14 - 18 يلمس بكل اختصار بعضاً من الشرور التي أدت إلى خراب الكنيسة وهي تحت المسئولية. (ع 14- 16) تعلمنا من الإصحاح الأول أن جميع الذين في آسيا قد ارتدوا عن الرسول. وهذا يتضمن في معناه أن الكنيسة لم تدم في قمة دعوتها السماوية. وكان الخطوة الأولى في انحراف الكنيسة هي التخلي عن صفتها السماوية. وكانت أعظم الحقائق هي التي بدأت الكنيسة أولاً في التخلي عنها. هذا التفريط في الدعوة السماوية ترك الباب مفتوحاً لدخول العالم والجسد بطريقة سافرة. وبشار إلى خدام الله في عدد 14 كأول مظهر لهذا الفساد. إنه يتتبع الخراب في شكل أفكار بشرية تقود إلى المنازعات، (الكلام غير النافع وبذلك يضلون عن كلمات الحق. إنه يحذرنا من مجالات الكلام، ويذكرنا ليس فقط بكلمة الحق، ل بكل كلمة الحق التي تفصل بالاستقامة. فكل الكتاب هو كلمة الحق وما يسبب الضرر أن يعطى الكتاب بتفسيرات خاصة أو باستخدام النصوص في غير سياقها الأصلي، ولذلك كما قال بطرس يحرقون الكتاب لهلاكهم. ثم نحذر من انحراف آخر، فإن الكلام غير النافع ينتج "الأقوال الباطلة والدنسة" فالأقوال الباطلة التي تدنس تتعامل مع الأمور الإلهية كما لو كانت أموراً شائعة، وهم يتعاملون بخفة مع الأشياء المقدسة. والأقوال الباطلة تجعل مناقشاتهم بلا أي موضوع. كما نحذر أيضاً من الأقوال الباطلة والدنسة ستزداد. وبالقدر الذي تهتم به المسيحي المعترفة فإن بولس لا يضع أي أمل بأن هذا التيار المنحدر سيقاوم، بل على العكس فإننا بالتحديد نحذر من ازدياد الشر. وفضلاً عن ذلك، فكما أننا نحذر من ازدياد الأقوال الباطلة والدنسة، فإنه يتبعها أيضاً ازدياد في السلوك غير التقوى. فالكلام الدنس يقود إلى سلوك غير تقوي. والتمسك بالكلام الدنس ونشره يقلل دائماً من مستوى السلوك الخارجي. والتساهل في التعليم يقود إلى الرخاوة في السلوك الأدبي. (ع 17 و18) ونتيجة أخرى مرعبة من ازدياد الكلمات الباطلة والدنسة وعدم التقوى. وهي أنها تدر الحقائق المسيحية الحيوية في أذهان الناس، إذ نقرأ أن أقوال أولئك –الأقوال الباطلة والدنسة –تنتشر كالغنغرينا أو ترعى كآكلة التي تأكل وتدمر الأنسجة الحية في الجسم. ولذلك خطوة تلو الأخرى، نرى أن الرسول يتتبع بمهارة إلهية تقد الشر الذي أفسد المسيحية فأولاً: مماحكات الناس حول الكلمات التي لا تفيد ولا تنفع. ثانياً: المجادلات الكلامية تؤدي إلى الأقوال الباطلة والدنسة. ثالثاً: الازدياد المستمر لهذه الأقوال الباطلة والدنسة يؤدي إلى انعدام التقوى. وهكذا نجد في دائرة الاعتراف المسيحي أن المسلك الخارجي ينحط إلى المستوى بأن الناس تتصرف بدون خوف الله. رابعاً: فالسلوك غير التقوى يميل إلى تدمير وسلب الناس من الحقائق المسيحية العظمى والحيوية. ولكي يرى نتيجة هذا التفسخ الحادث بسبب حالة الشر التي أسقطت المسيحية، فإن الرسول يعطينا مثلين خطيرين: هيميناس وفيليتس وهما رجلان في دائرة المسيحية وكانا يعلمان تعاليم خاطئة.وبدلاً من أن يفصلا كلمة الحق بالاستقامة فإنهما زاغا عن الحق، وعلما بأن القيامة قد صارت ومن الواضح أنهما لم ينكرا القيامة، بل أنهما أعطوا روحنة لمعنى القيامة وأثاراً جدالاً حول حدوثها بمعنى ما. ومثل هذا الخطأ لا نستبعده باستخفاف ظانين أنها طائشة هوجاء صادرة عن أناس مبالغين وغير مسئولين، ومع أن هذا الخطأ يبدو أنه غير منطقي، فإن الرسول يسبق فيرى الكنيسة المعترفة وهي تفسد ويعمل فيها الخطأ وكأنه غنغرينا تأكل فيها. أيصبح من الصعب أن نرى أنها "تقلب إيمان " أولئك الذين يتشربون هذا التعليم! وإذا كانت القيامة قد صارت، فمن المؤكد أن القديسين وصلوا إلى حالتهم النهائية وهم على الأرض، ونتيجة ذلك أن الكنيسة ستكف عن التطلع إلى مجيء الرب، فتفقد الحق المختص بنصيبها السماوي، وبذلك تتخلى عن صفتها كالغريب والسائح. وعندما تفقد الكنيسة صفتها السماوية، فإنها بذلك تستقر في الأرض وتأخذ مكانها هنا داخل نظام العالم في محاولات إصلاحه والتدخل في نظامه. واليوم قد لا نجد من يحاول أن يعلم بأن القيامة قد صارت، ولكن نتائج هذا التعليم المتهور باقية ونراه بشكل تام وظاهر ي دائرة الاعتراف المسيحي، فالمجهودات الدينية والإدارية، وغيرة المرسلين في المسيحية المعترفة تنادي بأن الكنيسة مستقرة هنا في مكانها وتقوم بعملها ساعية لإصلاح العالم وتهذيب الوثنيين لجعل العالم مكاناً له التقدير وترفرف عليه السعادة. (ع 19) وإذ سبق للرسول وأنبأنا بحالة الشر التي ستسقط فيها المسيحية، فإنه يعطينا تعليماً بكيفية التصرف في وسط الخراب. وقبل أن يفعل ذلك فإنه يستحضر أمامنا حقيقيتين عظيمتين لتعزية قلوبنا. أولاً - كيفما عظم فشل الإنسان فإن "أساس الله الراسخ قد ثبت" فالأساس هو عمل الله مهما كان الشكل الذي يتخذه هذا العمل سواء كان الأساس في النفس، أو كان الأساس في الكنيسة على الأرض، موضوعاً بواسطة الرسل (باعتبارهم أدوات فيه) وبمجيء الروح القدس. فلا يمكن لفشل الإنسان أن يطرح جانباً أساس الله الذي وضع، أو يمنع الله من تتميم عمله الذي بدأه. ثانياً - يقال لتعزيتنا "يعلم الرب الذين هم له" وكما قال واحد: }هذه المعرفة لا تقل عن تجارب قلب مع قلب، إنها العلاقة بين الرب وأولئك الذين هم له{ وبسبب كثرة التشويش وتفاقمه، وقد أصبح المؤمنون في أوثق العلاقات مع غير المؤمنين، فإنه بالنسبة للأكثرية المعترفة لا نستطيع أن نحدد من هم الذين للرب ومن هم ليسوا له. ففي حالة كهذه لنا تعزية أن نعرف أن الذي من الله لا يمكن أن يزاح بعيداً, والذين هم للرب مهما كانوا مختفين بين الأكثرية فلا يمكن أن يضيعوا أساساً. إن عمل الله، والذين هم للرب، لا بد أنهم سيستحضروا إلى النور "في ذلك اليوم" والذي يشير إليه الرسول مرة تلو الأخرى في هذه الرسالة (1: 12 و18، 4: 8). وإذ تجد قلوبنا التعزية لما يتميز به عمل الله من ثبات، وأمان أولئك الذين هم للرب، فإن عبد الله يعلم الفرد ماذا يعمل في وسط خرائب المسيحية. وبعد رحيل الرسل، سرعان ما استقر الانحراف وظل مستمراً عبر الأجيال والقرون حتى اليوم، إذ نرى في المسيحية الأحول الخطيرة التي آلت إليها وقد سبق للرسول أن أخبرنا بها. وفضلاً عن ذلك كما رأينا فإن الرسول لا يضع أمامنا أي أمل في إصلاح المسيحية التي انحرفت بها الغالبية، وعلى العكس من ذلك فإنه يحذرنا أكثر من مرة أنه مع مرور الوقت فإن الشر يزداد. وليس فقط الأقوال الباطلة والدنسة التي ستزداد (2: 16). ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ (3: 13) بل إن الوقت سيأتي الذي لا تقدر فيه جموع المسيحية المعترفة أن تحتمل التعليم الصحيح بل يحولون آذانهم عن الحق (4:3). فإذا كان، كما اتضح لنا, لا توجد بارقة أمل في إصلاح جموع المسيحية المعترفة، فماذا يفعل المسيحي الفرد الذي يرغب أن يكون أمينا للرب؟. إنه سؤال خطير وعميق يجيب عليه الرسول في الجزء الهام الذي يتبعه. وهو الجزء الذي يبين بوضوح طريق الله للفرد في زمن الخراب (19- 22). أولاً: لنلاحظ أننا لم نوص بأن نتخلى عن الاعتراف بأنه بيت الله على الأرض. ومن المستحيل أن يكون ذلك إلا إذا تركنا الأرض أو أصبحنا مرتدين. ليس علينا أن نتخلى عن الاعتراف بالمسيحية لكونها فسدت على أيدي الناس. وعليه فلم نوص بأن نعيد إصلاح ما خرب من الاعتراف المسيحي. والمسيحية بشكل عام خارج نطاق الإصلاح. فإذا كان علينا ألا نترك هذا الاعتراف ولا نسعى لإصلاح جماهير المسيحية ولا أن نستقر هادئين فيها مصادقين على خرابها بالارتباط بها, فما هو إذن الطريق الذي نسلكه؟ ولأجل تعزية قلوبنا فإن الرسول يضع أمام المؤمن كفرد طريق الله الذي عليه أن يرتاد في زمن الخراب. ونحن على يقين من أنع مهما ازدادت ظلمة الأيام التي نعيش فيها, وكيفما ازدادت الصعوبات، ومهما تعاظم الخراب، فإنه لم يأت يوم ولن يأتي في تاريخ الكنيسة على الأرض أن يترك الأتقياء فيه بدون توجيه للسلوك في الطريق في زمن الخراب. أن اله سبق ورأى الخراب، وقد أمدنا في كلمته بما يجب أن نعلمه في زمن الخراب. وعندما يكون الاختيار ناقصاً فإننا قد نفشل في تميز الطريق، وعندما يكون الإيمان ناقصاً فإننا قد نخشى أن نسلك هذا الطريق. ومع ذلك يبقى الطريق واضحاً في أحلك ظلمات الأيام كما في أيام ازدهارها. وإذا كان الله قد أوضح الطريق أمام شعبه في زمان الخراب، فمن البين أننا لم نترك لنخترع طريقاً لأنفسنا أو أننا ببساطة نفعل أفضل ما يمكن. إن علينا أن نميز طريق الله ونقف فيه بطاعة الإيمان بينما نطلب النعمة من الله ليحفظنا في الطريق. إن الخطوة الأولى في طريق الله هي الانفصال عن الشر. فإذا لم يكن علي أن أصلح شرور المسيحية فإنني مسئول أن أكون في الوضع الصحيح. ومع أنني لا أقدر أن أتخلى عن الاعتراف بالمسيحية، فإنني أستطيع حقاً الانفصال عن الشرور السائدة في المسيحية. ولنلاحظ بعناية، المرات الكثيرة وبكلمات مختلفة وبطرق عديدة يأتي الإلحاح على الانفصال عن الشر في الرسالة. يقول الرسول: "وأما الأقوال الدنسة والباطلة فاجتنبها" - 2: 16 "تجنب الإثم" - 2: 19 "إن طهر أحد نفسه من هذه" (أي من أواني الهوان) –2: 21 "أما الشهوات الشبابية فاهرب منها" - 2: 22 "والمباحثات الغبية والسخيفة فاجتنبها" - 2: 23 "اعرض عن هؤلاء" - 3: 5 إذاً "يتباعدوا أولاً عن الإثم. ولا يجب أن يربطوا اسم الرب بالشر بأي شكل". إن الخلط والتشويش في المسيحية أصبح عظيماً للغاية، حتى أننا من جانب قد يسهل علينا أن نسيء الحكم على شخص ما فنقول عنه أنه ليس للرب، وهو مؤمن حقيقي في قلبه، ولكن يعلم الرب الذين هم له. ومن جانب آخر فإن الذي يعترف بالرب مسئول أن يتجنب الإثم. أما إذا رفض أن يفعل ذلك فليس من حقه أن يشتكي إذا أساء الآخرون في حكمهم عليه. وفي يوم التشويش لا يكفي للشخص أن يعترف بالرب، إذ أن اعترافه يوضع تحت الفحص والامتحان هل هو يخضع لسلطان الرب بالتحول وترك الإثم؟ أما أن يبقى في ارتباط بالشر وفي ذات الوقت يدعو باسم الرب فمعناه أنه يربط اسمه بالشر. (ع 20، 21) ثانياً. وليس علينا فقط أن ننفصل عن الإثم بل أيضاً عن الأشخاص المرتبطين بالشر، الذين يدعوهم هنا أواني الهوان. ولكي يرينا الرسول الحالة التي انحدرت إليها المسيحية فإنه يستخدم شرح البيت الكبير الذي لإنسان في العالم. فتلك التي اتخذت مكانها على الأرض لتصبح بيت الله، بدلاً من انفصالها عن العالم ومضادتها له فإنها تصبح مثل العالم مشتبه ببيوت العالم، التي توجد فيها أواني من مواد مختلفة تستخدم لأغراض عديدة، ولكن أواني الكرامة وجدت في ارتباط بأواني الهوان. فإن كان هناك إناء يلزم أن يكون نافعاً لخدمة السيد فلا يجب أن يبقى في ارتباط بأواني الهوان. ولتطبيق ذلك فإن المؤمن الذي يريد أن يكون نافعاً لخدمة السيد يجب عليه أن "يطهر نفسه" من أواني الهوان. ومن الملاحظ أن المكان الوحيد في العهد الجديد حيث ترجمت كلمة "يطهر" مستخدمة في 1كورنثوس 5: 7حيث توص الكنيسة في كورنثوس: "نقوا منكم الخميرة العتيقة" عندما كانت الكنيسة هناك في وضعها المعتاد ووجد في وسطها فاعل شر، فيعلمهم الرسول بأن يعزلوا الخبيث من بينهم. وهنا ينبئنا الرسول بالانحدار الشديد الذي ستصل إليه جموع المعترفين بالمسيحية حتى أنه لا تعد هناك قوة لعزل فاعل الشر أو الخبيث.ففي حالة كهذه عندما تصبح احتجاجات الأتقياء بلا فائدة، فإن الأتقياء يوصيهم الرسول أن ينفصلوا عن أواني الهوان. وفي كلتا الحالتين فإن المبدأ واحد إذ لا يجب أن يكون هناك ارتباط بين الأتقياء وغير الأتقياء. ورفض مثل هذا الارتباط. في الحالة الأولى –وهي الحالة الطبيعية- فإن الكنيسة تنقي من نفسها الخميرة العتيقة، أما في الحالة الثانية، حيث لا تصبح هناك قوة للتعامل مع الشر، فإن إناء الكرامة يطهر نفسه من أواني الهوان إذ يفصل نفسه عنهم. وكما قال واحد بحق }فإذا كان واحد يدعو باسم الرب، وتحت دعاوي الوحدة أو محبة الاسترخاء والكسل أو تحيزه لأصدقائه صار يتسامح مع الشر الذي مكروه لدى الله، فليس أمام التقي أي اختيار بل يلتزم بأن يسمع الكلمة الإلهية فيطهر نفسه ن أواني الهوان{. ومن الواضح أنه يجب لأن نكف عن فعل الشر قبل أن نتعلم فعل الخير، والانفصال عن الشر يجعل الفرد مقدساً ومؤهلاً لخدمة السيد ومستعداً لكل عمل صالح. وقياس انفصالنا هو قياس إعدادنا للسيد وكما قال واحد }في كل عصر من عصور الكنيسة أي مجهود قليل لإطاعة هذا الأمر كان له مكافأته سواء من فرد أو من مجموع. وكل من يجتهد في التقصي لمعرفة طريق أي خادم مميز للرب أو أي مجموعة من المؤمنين فسيجد أن الانفصال عن الشر كان من إحدى السمات الهامة التي اتصفوا بها وأنها ارتبطت بالخدمة وبكونهم آنية للكرامة بذات درجة انفصالهم. وبالقدر الذي حادوا فيه عن هذا المبدأ وتهاونوا في انفصالهم كلما أهملوا أو صاروا غير نافعين في خدمة السيد{. ولتعزية وتشجيع ذاك الذي يجتهد في حفظ تلك الوصية، فعليه أن يتيقن أنه لم يعد نافعاً فحسب لخدمة السيد، بل يكون أيضاً "إناء للكرامة" وسيواجه الازدراء والتعييرات من أولئك الذين انفصل عنهم، ولكن الرسول يقول أنه "يكون إناء للكرامة". وترينا هذه الأعداد أن الانفصال يتميز بخاصتين أولهما أنه علينا أن ننسحب من كل نظام شرير، وثانيهما أن ننفصل كذلك عن الأشخاص الذين هم "أواني الهوان". هذا هو التفويض المعطى للفرد أن ينفصل عن كل أنظمة الناس الكبرى التي استبعدت المسيح كرأس الجسد الوحيد والتي تجاهلت حضور الروح القدس، والتي تخلت عن حقائق المسيحية الأساسية، وحيث تجع تلك الأنظمة المؤمنين مع غير المؤمنين في عبادة متحدة، وليس لديهم قوة للتعامل مع الشر، بل إنهم يقبلون مبادىء تجعل من المستحيل التعامل مع الشر. (ع 22) إن تعليم الانفصال عن الشر نجده متبوعاً بوصية مساوية في الأهمية "أما الشهوات الشبابية فاهرب منها" فبعد الانفصال عن تشويش المسيحية فإننا نحذر لئلا نسقط في فساد الطبيعة. والشهوات الشبابية لا تشير فقط إلى رغبات الجسد البذيئة، بل تتضمن أيضاً كل رغائب الطبيعة الساقطة مع اندفاع وطيش الإرادة الذاتية لشاب التي بلا تفكير. ولن نتعرض لتلك الأخطار العظيمة النابغة من الجسد إذا سلكنا بأمانة للرب. قال واحد: }قد نتعرض للخداع بالتراخي في حالتنا الأدبية بعدما نستريح في انفصالنا الكنسي{. فكم يكون مناسباً هذا التحريض "أما الشهوات الشبابية فاهرب منها". ويتبع ذلك وصية تجنب الإثم والانفصال عن أواني الهوان. وإذا انفصلنا عن تشويش المسيحية ورفضنا فساد الطبيعة، فإننا نحرض أن نتبع الأوصاف الأدبية العظيمة والتي تعطينا الصفة الإيجابية للطرق، فالرسول لم يوصينا بإتباع معلمين مشهورين وإن كنا يجب أن نسر بالتعرف على كل موهبة تقود هؤلاء السائرين الذين لهم هذه الأوصاف. أما الأشياء التي علينا أن نتبعها فهي "البر والإيمان والمحبة والسلام". والبر يأتي كضرورة أولية، فالمسألة هنا هي طريق الفرد فإن كنا قد انفصلنا عن الإثم، إذن فعلينا أن نحكم على طرقنا إزاء ارتباطاتنا العملية سواء كانت علاقاتنا بالعالم أو علاقاتنا شعب الله والتي يجب أن تتصف بالبر. ثم يأتي الإيمان تالياً لكي يجعل الطريق ضيقاً أكثر، ذلك لأن الإيمان يتعامل مع الله، وليس كل طريق للبر هو طريق الإيمان، فالبر العملي مع الناس بمعنى الأمانة في التعامل الواحد مع الآخر، الذي قد يتوفر دون وجود الإيمان بالله. ولذا فإن طريق الله لخاصته في هذا العالم يتطلب اختبار الإيمان الدائم في الله الحي فنحن لا نحتاج إلى طريق نرتاده بل نحتاج إلى إيمان لنرتاد هذا الطريق. ثم تتبعه المحبة فمتى كانت علاقاتنا العملية مع الآخرين صحيحة، ونسير بالإيمان مع الله، فإن قلوبنا ستستمر في الطريق بكل حرية المحبة. من نحو الآخرين. ونجد "الإيمان بالمسيح يسوع" متبوعاً بالمحب نحو جميع القديسين (أف 1: 15، كو 1: 4). وفي النهاية يأتي السلام، ويأتي في المكان المناسب كنتيجة البر والإيمان والمحبة. إن البر يتصدر القائمة والسلام، يختمها, لأن "ثمر البر يزرع في سلام ". وما لم يحفظ السلام بهذه الصفات التي تسبقه، فإنه يمكن أن يصل بالذين يسلكون فيه إلى حالة اللامبالاة من نحو المسيح وبالتالي قبول الشر. وبعد ذلك ينتقل الرسول في حديثه من التعاليم الخاصة بسلوك الأفراد في زمن الخراب إلى التعاليم المرتبطة بالجماعة. وعند هذه النقطة يخبرنا عن الصفات التي يجب أن نتبعها "مع الذين يدعون الرب من قلب نقي "فكلمات" مع الذين "تأتي بنا إلى ما يرتبط بالجماعة وهذه. في غاية الأهمية وبدونها كان يجوز لنا أن نسأل عن ما يصرح به الكتاب للسلوك مع الآخرين في زمن الخراب. وهذا ما يقوله الكتاب لأننا لم نترك وحيدين. فهناك دائماً الآخرون الذين يدعون باسم الرب من قلب نقي في زمن الخراب والدعاء باسم الرب هو التعبير عن الاستناد على الرب، ويبدو أنه يرتبط بصفة خاصة بالوقت الذي يكون فيه تحولاً عن الرب. ففي أزمنة الشر أيام شيث نقرأ "وابتدأ الناس يدعون باسم الرب" كذلك نقرأ عن إبراهيم عندما خرج من أرضه (وطنه) ومن عشيرته وبيت أبيه أنه "دعا باسم الرب". ولذلك إذ لنا شركة مع اللذين لهم ولاء للرب وقد انفصلوا عن تشويش المسيحية، وفي المكان الخارج هذا يسلكون بالاستناد على الرب، وهم إذ يفعلون ذلك إنما يفعلونه بقلب نقي. والقلب النقي هو ذلك القلب الذي لا يدعى لنفسه فقط النقاء. بل بالحري هو من يجتاز الفحص عند الرب تابعاً البر والإيمان والمحبة والسلام. ولذا نجد أمامنا طريقا محددا مرسوما بكلمة الله لزمن الخراب وله هذه الأوصاف أولاً: الانفصال عن تشويش المسيحية. ثانياً: الانفصال عن تشويش الجسد. ثالثاً: إتباع الصفات الأدبية السالفة الذكر. رابعاً: الارتباط مع أولئك الذين يدعون الرب من قلب تقي. فإذا كان هناك بعد أفراد قلائل وجدوا أنفسهم مرتبطين معاً بحسب هذه التعاليم الصريحة، عند إذ يلوح هذا التساؤل إي مبادئ تقود هؤلاء في عبادتهم وفي تذكرهم الرب، وفي اجتماعاتهم للبنيان وفي خدمتهم وفي أسلوب حياتهم الواحد من نحو آخر واتجاه العالم؟ الإجابة بسيطة فإنهم يجدون كل المبادئ التي يمكن أن تقودهم فيما يخص كل تفاصيل ترتيب كنيسة الله، يجدونها في رسالة كورنثوس وفي أجزاء أخرى في العهد الجديد، مبادئ لا يمكن أن يستبعدها الخراب الحادث. وفضلاً عن ذلك فبعد الانفصال عن شرور المسيحية، فإن البعض سيجد أن العديد من المبادئ والتوجيهات التي لها طابع عملي في الكنيسة وتبدو صعوبة تطبيقها في أنظمة الناس وطوائفهم، إلا أنه يسهل تطبيقها ببساطة. ولذلك فإن أولئك الذين يقبلون طريق الله في زمن الخراب سيجدون أنه لا يزال ممكناً السير في نور الكنيسة كما تأسست في البداية. إن هؤلاء ليسوا هم الكنيسة، ولهم كنيسة نموذجية بل غالباً هم أفراد قلائل انفصلوا عن تشويش المسيحية، فإن كان ثمة شهادة لحالة خربة للكنيسة في الأيام الأخيرة هذه، أكثر مما هي نموذج لكنيسة كما في أيامها الأولى. وفي الأعداد الختامية لهذا الإصحاح أمامنا تحذير هام لخادم الرب. فبالإشارة إلى طريق الانفصال عن تشويش المسيحية فإن الرسول يسبق فيتنبأ كما أن هناك أولئك الذين يطيعون تلك الوصايا والتوجيهات، كذلك هناك أيضاً الذين يقاومون بعنف.فالتأكيد على هذه الحقائق إنما تثير على نحو غير متوقع "المباحثات الغبية والسخيفة[1] "و الاختبار كشف لنا حقيقة هذا الأمر. وغالباً فإن كل جدل يثير الذكاء الإنساني إنما يتجه إلى محاولة استبعاد هذه الوصايا الصريحة في هذا الجزء، ولكننا نحذر بأن هذه المناقشات تولد النزاع والخصومات. فمهما حدث لخادم الرب فلا يجب أن يستدرج للنزاع والخصومة. إنه "لا يجب أن يخاصم"، وإذا سمح لنفسه أن ينزلق إلى الخصومة فإنه يجد نفسه مهزوماً بالرغم من وقوفه لأجل الحق المطلق. فعلى الخادم أن يتذكر أنه خادم فقط وليس هو السيد، وكخادم الرب من واجبه أن يظهر صفة الرب في الترفق وصلاح التعليم والصبر والوداعة في مواجهة المقاومات. إن الميل الطبيعي فينا أن ندفع ونتمسك بما نحن مرتبطين به حتى ولو كان غير كتابي بالمرة. والنتيجة الأولى لاستحضار هذه الحقائق غالباً ما تثير المباحثات الغبية والسخيفة. فإذا أتت المقاومات على الخادم نفسه، يصبح عليه أن يتحلى بالصبر الكثير والوداعة بقدر كبير إذا أراد أن يعلم الآخرين. وعندما نكشف هذه الحقائق للآخرين ليس بسبب وضوح كشفنا لتلك الحقائق ولا بسبب الوداعة في أسلوب تقديمها تصبح مقبولة منهم، ولكن لسبب أن الله وحده هو الذي يحضر الشخص إلى "معرفة الحق". [1] "foolish and senseless questions" كما جاءت في ترجمة داربى, وتأتي حرفياً "foolish and undisciplined questionings" وفي معناها العام الذهن غير الخاضع لله, وهو الشخص الذي رأيه الخاص وإرادته الذاتية. (المعرب). تعلمنا في الإصحاح الثاني سوء حالة الكنيسة المعترفة التي تظهر نفسها في ذلك اليوم. وفي الإصحاح الثالث يعطينا وصفاً مهيباً للحالة المرعبة التي ستسقط فيها المسيحية المعترفة في الأيام الأخيرة. فمن جهة المعيشة في هذه الأيام فإننا نشكر الله إذ لم نترك لنشكل رأينا بالنسبة لحالة المسيحية. فقد سبق أن أخبرنا الله ووصف لنا تلك الحالة ليكون أمامنا تقييما إلهياً وعادلاً لشعب الله المعترف. وإذ يغيب الفكر الصحيح عن المسيحية كما وردت في الكتاب فإن جماهير المسيحية المعترفة ترى في المسيحية أنه نظام ديني طائفي، حتى أن العالم يتشكل تدريجياً به والوثنية تنقاد بها إلى المدينة. حتى أن الكثيرين من أولاد الله بسبب معرفتهم الجزئية للخلاص الذي يستحضره الإنجيل يعلق في أذهانهم توقعات خاطئة فيظنون أنه بانتشار الإنجيل يتحول العالم تدريجياً وندخل بذلك إلى العصر الألفي السعيد. وهكذا نجد بين المعترفين بالمسيحية وبين كثير من أولاد الله الحقيقيين، انطباعاً خاطئاً بأن المسيحية تتقدم إلى الانتصار الحقيقي على العالم والجسد والشيطان. ولكن الحق الكتابي الصريح يرينا أن الكنيسة وهي منظور لها من وجهة المسئولية الإنسانية قد فسدت تماماً حتى أن جماهير المسيحية تجتاز القضاء الإلهي. وكتاب الوحي العهد الجديد يتفقوا في تحذيراتهم لنا من سيطرة شر المسيحية المعترفة في الأيام الأخيرة ومن القضاء الذي سيقع على المسيحية. ويخبرنا يعقوب "هوذا الديان واقف على الباب" (يعقوب 5: 7- 9). ويحذرنا بطرس أن "ابتداء القضاء من بيت الله" وأنه في الأيام الأخيرة تتصف المسيحية المعترفة بالاستهزاء والمادية المنحطة (1بطرس 4: 17، 2بطرس 3: 3- 5). ويحذرنا يوحنا أنه في الساعة الأخيرة يظهر ضد المسيح الخارج من الدائرة المسيحية (1يوحنا 2: 18و19). ويخبرنا يهوذا عن الارتداد الآتي وفي هذا النص المهيب يعدنا الرسول إلى التشويش المرعب الذي يصف المسيحية المعترفة في ختامها. وعلى الرغم من هذا, فإن كان لأجل تحذيرنا أعطى لنا هذا الوصف التفصيلي في ختام الأيام الأخيرة، كذلك لأجل تشجيع الأتقياء لنا إعلانات صريحة ومساوية عن اكتمال مصادرنا ليتمكن المؤمن أن يهرب من تشويش المسيحية وأن يحيا بالتقوى في المسيح يسوع. هذان هما الموضوعان الأساسيان في الأصحاح الثالث هذا –شر المسيحية المعترفة في الأيام الأخيرة ومصادر التقى في مواجهة الشر. (ع 1) إن الله لا يريدنا أن نجهل حالة المسيحية، ولا يريدنا أن ننخدع بدعاوى المحبة فنصبح غير مبالين بالشر. ولذلك فإن خادم الرب يفتتح هذا الجزء من تعليمه بهذه الكلمات "ولكن اعلم هذا" وهو ينذرنا بالقول "إنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة (أو خطيرة)". (ع 2- 5) ويتقدم الرسول فيعطي بأكثر دقة صورة مرعبة للحالة التي ستؤول إليها المسيحية من سقوط ويرسم بالتفصيل الصفات البارزة لأولئك الذين يكونون جماهير المسيحية المعترفة في تلك الأيام الأخيرة. إن روح الله يتحدث عن أولئك المعترفين باعتبارهم "الناس" فليس هناك أساس ليدعوهم قديسين أو مؤمنين. ومن الملاحظ فإن الرسول لا يصف حالة الوثنيين هنا بل المعترفين بالمسيحية والذين لهم صورة التقوى. ويستعرض أمامنا في هذه الصورة تسعة عشرة صفة مرعبة. 1- "الناس يكونون محببين لأنفسهم". إن الصفة الأولى والبارزة للمسيحية في هذه الأيام الأخيرة هي محبة الذات. ونجد هنا مباينة مباشرة للمسيحية الحقيقية التي تعلمنا أن المسيح "مات لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعدهم لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام" 2- "محبين للمال" إن محبة الذات تقود إلى محبة المال. لذلك نجد أناس يريدون أن يشتروا لكي يرضوا ذواتهم. إن المسيحية تعلمنا أن محبة المال هي أصل كل الشرور. وأن الذين يريدون أن يكونوا محبين المال فإنهم يضلون عن الإيمان ويطعنون أنفسهم بأوجاع كثيرة (1تي 6: 10). 3- "متعظمين" إن محبة المال تقود الناس إلى التعظم. ونقرأ في الكتاب عن أولئك الذين يتكلمون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون (مز 49:6). وأيضاً الشرير يفتخر بشهوات نفسه ويبارك الخاطف ويهين الرب (مز 10:3). فليس الناس يفتخرون بذكائهم في كسب الثروة فحسب ولكنها تكون الثروة. وغالباً ما ينتهزون الفرصة للإعلان عن أعمالهم وعطاياهم السخيفة، بعكس المسيحية في عطائها الذي يتصف بالاتضاع فهي تعلمنا أن نعطي بحيث لا تعرف يمينك ما تفعله شمالك. 4- "مستكبرين" إن الافتخار وتمجيد الذات تسير مع الكبرياء التي تعطي أهمية للمولد والمركز الاجتماعي والمواهب الطبيعية بالمباينة مع المسيحية التي تقودنا أن نحسب هذه الأمور جميعها خسارة لأجل امتياز معرفة المسيح يسوع ربنا. 5- "مجدفين" إن الكبرياء تقود إلى التجديف والكبرياء بسبب الإنجازات، والقدرات الذهنية تجعل الناس لا تترد في أنهم "يفترون على ما يجهلون" ويتكلمون بتجاديف على العلى، ويجدفون على شخص المسيح وعمله، ويرفضون الإعلان الإلهي ويستهزئون بالوحي. 6- "غير طائعين للوالدين" فمتى كان الناس قادرين على التجديف ضد الله فلا نتعجب أنهم لا يطيعون الوالدين. وإذا كان توقيرهم قليلاً للأقانيم الإلهية فإنهم لا يوقرون العلاقات الإنسانية. 7- "غير شاكرين" هؤلاء الذين لا يطيعون الوالدين، فإن كل رحمة من الله أو الناس تصبح كأنها حقاً لهم وبذلك فلا يوجد لديهم شعور العرفان بالجميل. وتعلمنا المسيحية أن كل المراحم الممنوحة للخليقة "تقبل مع الشكر من المؤمنين وعارفي الحق" 8- "دنسين" فإذا كان عدم الشكر لأجل البركات الزمنية والروحية متوفراً فسرعان ما يستهزئون ويحتقرون النعمة التي تهبهم البركات. فقد احتقر عيسو البكورية التي منحها الله كبركة له. 9- "بلا حنو" أي بلا عواطف طبيعية – فالشخص الذي يتعامل بخفة مع رحمة الله ومحبته سرعان ما يفقد عواطفه الطبيعية من نحو زملائه. إن محبة الذات تقود إلى اللامبالاة تجاه الروابط في الحياة العائلية فتراهم كعائق يمنع إشباع الذات. 10- "بلا رضى" فالشخص الذي يقاوم العواطف الطبيعية سيصبح بالتأكيد عنيداً لا يقبل الاقتناع ولا يمكن أن يهدأ. 11- "ثالبين" والشخص الذي له روح الحقد والانتقام يقف مواجهة أي دعوى ولا يتردد في الثلب واتهام كل من يقاوم إرادته. 12- "عديمي النزاهة" فمن لا يتردد متكلماً بلسانه في ثلب الآخرين واتهامهم فإنه بسهولة يفقد لتحكم في نفسه ويعمل بلا كبح لذاته. 13- "شرسين" فالذي يثلب الآخرين في حديثه وغير ضابط لأفعاله فإنه يظهر ميلاً للشراسة وبذلك يفتقر إلى اللطف الذي يميز الروح المسيحية. 14- "غير محبين للصلاح" فالمزاج الفظ والشرس لا بد أن فالمزاج الفظ والشرس لا بد أن يصيب الناس بالعمى تجاه ما هو صالح. فليس فقط أولئك الذين في دائرة الاعتراف المسيحي الذين يحبون الشر بل إنهم حقاً يكرهون الصلاح. 15- "خائنين" وليسو فقط غير محببين للصلاح، بل إنهم لا يترددون في العمل بخبث وخيانة بدلاً من الثقة، ولا يحترمون روابط العلاقات كأصدقاء. 16- "مقتحمين" أو متهورين. فالذي يخون أصدقاءه بإمكانه أن يتبع إرادته الذاتية ولا يبالي لما يحدث بسبب ذلك ودون اعتبار للآخرين. 17- "متصلفين" وذوي ادعاءات فارغة، وهم مملؤون بالغرور والمتصلف يسعى أن يضع غطاء على إرادته الذاتية بادعاءات باطلة فيوهم الآخرين بأنه يعمل للصالح العام. 18- "محبين للذات دون محبة لله". وحيث أن ادعاءات الناس فارغة كذلك فإن سعيهم لتحقيق ذلك ينقصه الجدية. وتتجمع سحب القضاء الآتي وبالذات على المسيحية التي أعمتها الأنانية وكل ما هو باطل مندفعة وراء الإثارة وباحثة عن مسراتها الحسية، وغالباً ما نجد الخدام الدينيين يقودون الناس إلى كل نوع من المسرات العالمية. 19- "لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها" ولذلك ففي الأيام الأخيرة من المسيحية نجد أن جماهير المعترفين وقد تفرغوا لعمل كل أنواع الشرور بينما يحاولون أن يغطوا شرورهم بقناع من القداسة. وهكذا يصبح المسيحيون الإسميون أكثر شراً من الوثنيين إذ بينما هم غارقون في كل أنواع شرور الوثنية فإنهم يضيفون إلى شرورهم غطاء له شكل مسيحي مع خلوه التام من القوة الروحية. وهل هناك إفراط في الشر أكثر من محاولة استخدام اسم المسيح كغطاء لعمل الشر. إن هذا الغطاء من التقديس في الأيام الأخيرة لتلك الأزمنة الصعبة" تعطي صورة ظاهرة للتقوى، وهي صورة خادعة حتى للمسيحيين الحقيقيين. ومن الملاحظ أن أولى الشرور الظاهرة التي تتصدر القائمة المرعبة هي محبة الذات أو الأنانية غير المحكوم عليها والتي تقود إلى باقي أنواع الشرور. ولكون الناس مستبعدة لمحبة الذات فهي تحب المال وتفتخر بالذات (أي الكبرياء) والافتخار بالذات يقود إلى عدم كبح جماح الذات سواء تجاه الناس أو الله. ومحبة الذات والانغماس في الإرادة الذاتية تجعل الناس غير شاكرين ودنسين وتقودهم إلى استبعاد العواطف الطبيعية كما تجعلهم بلا رضى وثالبين. ومحبة الذات أيضاً تقود الناس إلى أن تطلق عنانها لكل أهواء فيصبحون عديمي النزاهة ولكل قسوة وشراسة تجاه إرادتهم المنحرفة. وتجعل الناس يكرهون الصلاح ويصبحون خائنين ومقتحمين وذوي ادعاءات باطلة، كما تجعلهم يحبون الملذات دون محبة لله. هي القائمة المرعبة والتي يستحضرها الكتاب في الأيام الأخيرة للمسيحية المعترفة وإن كان إسرائيل قديماً الذي انفرز عن بقية الأمم لكي يحمل الشهادة لله الحقيقي، وقد فشل تماماً تحت المسئولية حتى قيل لهم إن "اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم" فماذا يكون بالنسبة للكنيسة المعترفة التي حوت نوراً أعظم وامتيازات أكثر، كم يكون مرعباً فشلها في تلك المسئولية. إن الكنيسة التي أقامها الله شاهدة للمسيح في زمان رفضه، نرى جماهير المعترفين باسم المسيح وقد انحدرت إلى أدنى من مستوى الوثنيين، وصاروا تعبيراً عن إرادتهم وأهوائهم الذاتية، وهكذا صار اسم المسيح المبارك للتعبير. فهل نتعجب أن تكون نهاية أولئك الذين يعترفون باسم المسيح على الأرض أنه يتقيأهم من فمه؟ وعلى الرغم من هذا فلنتذكر أنه في وسط هؤلاء المعترفين فإن الله خاصته، والرب يعلم الذين هم له فلا يفقد واحد منهم، وفي النهاية فإن أولئك الذين يكونون كنيسة الله الحقيقية سيستحضرون للمسيح بلا دنس ولا غضن ولا شيء من مثل ذلك. وفي ذات الوقت فإن شعب الله الحقيقي. أولئك الذين يدعون الرب من قلب نقي –تعلموا صراحة أن يعرضوا عن تشويش المسيحية المعترفة. فنحن لن ندع لكي نصارع مع أولئك المعترفين، فإنهم لا يزالوا تحت القضاء ولكن علينا أن نتحول عن مثل هؤلاء ونتركهم لدينونة الله. وكما انفصلنا عن تشويش المسيحية المعترفة، فهل لنا التقدير الصحيح لتلك الحالة المخيفة، أو هل نجد شهادة كافية للحق؟ وإذ نتحقق من حالة المسيحية التي حولنا فإننا نذلل أنفسنا أما الله معترفين بفشلنا وضعفنا, متذكرين أيضاً أن الجسد فينا, ولكن لأجل رحمته فإننا بسهولة يمكننا أن نضلل بواحدة من هذه الشرور. (ع 6- 9) وبعد أن يصف الكاتب الحالة المخيفة التي تصيب المسيحية ككل في الأيام الأخيرة فإنه يحذرنا من شر معين يظهر نتيجة هذا التشويش. إذ تقوم فئة خاصة باعتبارها أدوات فعالة ونشيطة في مقاومة الحق بتعليم الشر. وناهيك عن تعاليمهم الشريرة فقد اختاروا لتوصيل هذه التعاليم طرقاً ماكرة ومدانة. ونحن نقرأ أنهم "يدخلون البيوت" "creep into houses" إنها صفة الخطأ الذي يتجنب النور ولكنه ينتشر سراً, وبعدما تتهيأ لها أرضية كافية بتلك الأساليب السرية الخادعة فإن قادة هذه التعاليم الخاطئة لا يخشون أن يعلنوا صراحة تعاليمهم الخاطئة الشريرة وعندئذ يعلن الخطأ جهاراً ويأتي إلى النور بعد أن ظل لسنوات يعلم ويحفظ. وهؤلاء المعلمون مدانون إذ يدفعون أناساً يتصفون بأنهن "نُسيات" أو "نساء سخيفات silly women" ليتمكنوا من التأثير على البيوت وعائلات المعترفين بالمسيحية. ومن المرجح أن الرسول يستخدم تعبير "نساء سخيفات" أو "نسيات" للتأكيد على نوعية هؤلاء الأشخاص المتخنثين (سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً) والذين تحكمهم العواطف والشهوات أكثر مما يحكمهم الضمير والعقل. وأذهانهم قلقة بهواجس الخطأ على الرغم من افتخارهم بأنهم "يتعلمن في كل حين" ولكن "لا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق" فالخطأ يترك ضحاياه في ظلمة عدم اليقين. وبعض المعلمين أمثال ينيس ويمبريس في القديم اللذين قاوما الحق بمحاكاتهم للمظاهر الخارجية للديانة بينما كانوا يخلون تماماً من جوهر المسيحية الحيوي، فهؤلاء "أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون". وكل نظام خاطىء في المسيحية إنما يعود إلى أناس قد فسدت أذهانهم بالشر ومن جهة إيمانهم وجد باطلاً. وبالرغم من هذا فإن الله في طرق حكمه غالباً ما يسمح بأولئك المعلمين الكذبة لكي يكشفوا أمام أعين جميع الناس. ومرة تلو الأخرى فإن حمق هذه الأنظمة الدينية، كذلك حياة الشر لكثيرين من قادتها تعلن بوضوح أمام العالم، فيصبحون موضوعاً للازدراء في أعين الجميع –وبالذات أمام ضحاياهم المخدوعين.
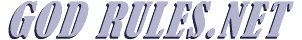 |
