
































 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
مكتبة الأخوة أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن
|
|
الأعداد الأولى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما كنا نعالجه في الأصحاح السابق، وفي بقية الأصحاح توجيه لضمائر أفرايم ويهوذا. وليس أوفق من التعبير الذي تنطوي عليه هذه الأعداد، على شفاه البقية الراجعة في يوم قوته العتيدة، قوة ذاك الذي بقي وجهه محجوباً عنهم زماناً طويلاً: «هلم نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا. ضرب فيجبرنا. يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يُقيمنا فنحيا أمامه. لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب. خروجه يقين كالفجر. يأتي إلينا كالمطر. كمطر متأخر يسقي الأرض». تلك صيحة البقية الراجعة التي تعلّمت أن تعرف الرب في الأتون المشتعل، أتون فترة الضيق. فها هي تلتمس الطريق إلى صهيون، وبأرواح جازت التأديب يرجعون إلى ذاك الذي طالما ازدروه. ولاحظ أن يقظة الأصحاح الثاني عشر من نبوءة زكريا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما نجده أمامنا. ونظير نعمي، سوف يدركون أنه هو الذي افترسهم وضربهم، بيد أن الإيمان يُعتمد عليه للشفاء ونوال البركة. وبعد يومي الشهادة الخطيرة لضمائرهم، تلك الشهادة التي قادتهم إلى التوبة الواضحة، يحييهم في اليوم الثالث. هذا اليوم يقابل اليوم الذي يُرش فيه ماء النجاسة على المتنجس (عدد 19)، حتى تعلن طهارته في اليوم السابع، وهكذا يمكن لمن تنجس لميت أن يحيا قدامه. وإذ ينـزل في يوم مجده كالوابل على العشب، فإنهم يجدون الحياة والبركة، وسيكون لهم نمو يومي في معرفته في ملكوته خلال الدهر الآتي. ومع أن هذا هو ما سوف يتحقق فعلاً حين ينتدبون في يوم قوته، لكنهم - للأسف - لم يكونوا في تلك الحالة السعيدة يوم أُرسل إليهم هوشع . لذلك لم تُقدم لهم تلك الصورة المشتهاة للملك الألفي إلا في عبارة وجيزة، قبل أن يمضي روح الله في تعامله معهم بسبب حالة سقوطهم التاعسة، وفي توسلات لطيفة يحرّضهم على الرجوع عن طرقهم الشريرة. لقد مرت عليهم فترات محدودة بدت فيها الرغبة في الإخلاص للرب، لكنها عبرت سريعاً وظهر أنها كانت رغبة وقتية. لذلك يصرخ بينهم قائلاً «ماذا أصنع بك يا أفرايم؟ ماذا أصنع بك يا يهوذا؟ فإن إحسانكم كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكراً» (ع4). وهم يشبهون كنيسة أفسس في يوم تالٍ، فإنهم إلى أجل قصير تمسكوا بمحبتهم الأولى. إن عواطف تلك الأيام الباكرة، على رقتها، يوم ذهبوا وراءه في البرية، قد تبخرت، تبددت ومضت كالندى إذ تطلع الشمس في قوتها. ولذلك، وبدلاً من أن يرسل إليهم أنبياء لبهجة أرواحهم، اضطر أن يرسل لهم خدمة نظير تلك الخدمة التي أُعطيت بواسطة يوحنا المعمدان فيما بعد، حين وضع الفأس على أصل الشجر، القضاء الذي في كبريائهم خرج عليهم (ع5). لكن يجب أن نلاحظ إن أنبياء العهد القديم كانوا كمن ينقبون حول الأشجار لاستئصال الحشائش القاتلة، ويقلّمون أغصانها، وذلك لتنقية الأشجار حتى تثمر. لكن جهودهم باءت بالفشل، فجاء يوحنا ليضع الفأس على أصل الشجر. أجل، فلابد من إسقاطها، إذ لا أمل في الشفاء. والإنسان الأول لم يأت لله بشيء ما، ومن ثم لابد أن يفسح المجال للإنسان الثاني. وهذا هو الفارق الكبير بين آخر أسفار العهد القديم، وبين ما يبدأ به العهد الجديد. إن مجرد إصلاح وتقويم الصورة الشكلية والطقسية لا يُقنع الله، لهذا يقول «إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات» (ع6). وبالمثل نرى إشعياء يكشف عدم التوافق بين إصلاح الشكليات الطقسية، والقلب المبتعد عن الرب، فالله يريد الحقيقة، وما عداها فإنه سخرية فارغة قدام ذاك الذي عيناه «أطهر من أن تنظرا الشر». «كآدم تعدوا العهد» (ع7). لقد أعلن الله مشيئته لهم، غير أنهم نقضوا كل وصية، تابعيين شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. وهكذا غدروا به، غدر به أولئك الذين أقرّوا بأنهم عبيده. وجلعاد التي طالما كانت موطن الخيرات الطبيعية، قد أصبحت قرية إثم، وتلطخت بالدم (ع8). كان يجب - بوصفها مدينة كهنوتية - أن تكون قدساً للرب، غير أن أولئك غير الأتقياء، بالرغم من تقديسهم ككهنة، لم يكونوا إلا قُطّاع طرق يكمنون للسائرين في الطريق المستقيم؛ يعيشون في النجاسة عوضاً عن أن يعيشوا في طرق الله المقدسة. إن زعماء الشعب أضلوهم، وقادوهم بعيداً عن سبل الحق. ومن ذا الذي لا يستطيع أن يلمس الحالة عينها، حالة الإثم والفجور التي تتطور الآن بين ما يسمى بالبروتستانتية؟ إن الفجور العلني الذي كان متفشياً في العصور المظلمة قد وَجَد رادعاً في النور الساطع من الكتاب المفتوح، الذي جعل الناس يخزون ويستحون مما كانوا يفاخرون به قبلاً منغمسين في ظلام وجهل الرومانية والقرون الوسطى. غير أن هدف الشيطان الأعظم في هذه الأيام هو تسميم أفكار الناس بتلك التصورات غير المقدسة، لقيادات دينية ملحدة، يطلقون العنان لدنس الروح، ويستغلون مراكزهم كزعماء وقادة الفكر المسيحي - على حد تعبيرهم - ليستغنوا هم، بينما قطيع المسيح الحقيقي يموت جوعاً. ويقيمون رعاة من أولئك الذين وإن كانوا يحملون أسماء مسيحية، ولكنهم رافضون لنعمة الله. وما أظلم مصيرهم يوم غضب الرب، الذي فيه يحكم على الديانة الزائفة. وبلا جدوى علا صوت النذير قديماً. وبلا جدوى يعلو في يومنا؟ فقد مضت الغالبية في عهدهم وعهدنا على السواء في طريقها، لا تعبأ بتوبيخاته الخطيرة. «في بيت إسرائيل رأيت أمراً فظيعاً. هناك زنى أفرايم، تنجس إسرائيل» (ع10). يبدو وكأن العدد الأخير (ع11) يسمح بتفسير مزدوج، فليهوذا قد تهيأ حصاد حين يجتمع سبيهم. وهذا قد يعنى أن الله سوف يحصل على حصاده مهما تكن خيبة الإنسان، ذلك عندما يرجعون إليه آخر الأمر. ولكن حيث أن يهوذا وحده هو الذي يُذكر هنا، بينما أعلن الرب إثم المملكتين، فأستطيع أن أتبيَّن أن الحصاد المشار إليه هو حصاد الدينونة المرعبة، التي سوف يحصدونها بسبب رفض المسيّا. ولابد أن يجتاز يهوذا في هذه الدينونة العارمة، قبيل رجوعهم وبركتهم. لأن العشرة الأسباط لم يكن لهم دور في رفض الرب يسوع، وليس على رؤوسهم تنصبُّ اللعنة التي أثارها الشيوخ المسعورون يوم صاحوا «دمه علينا وعلى أولادنا». ومن ثم فإن يهوذا ينتظره حصاد مريع. لقد زرعوا الريح، فليحصدوا الزوبعة، يوم تنسكب جامات غضب الله على الأرض النبوية.
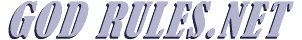 |
