
































 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
مكتبة الأخوة أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن
|
الأصحاح العشرونالمسيح ينتقل إلى المجد. والتلاميذ ينتقلون من العيان إلى الإيمان: في الأصحاح السابق, تركنا المسيح في ذلك القبر الجديد الذي لم يوضع به أحد من قبل, وتركنا تلاميذه في قبر من اليأس والأحزان. فما أشد الخوف الذي كان مستولياً على قلوبهم طوال يوم السبت, الذي أعقب يوم الصلب, بل ما أرهب السكون الذي خيم على قلوب رؤساء الكهنة بعد انقضاء تلك العاصفة الهوجاء التي أثاروها, فاختتمت بالصلب. ومن المحقق أنهم شعروا بدهشة مرهبة, ورهبة مدهشة, حينما ذهبوا إلى الهيكل في صباح. سبتهم "المقدس", ورأوا "حجاب" الهيكل السميك, وقد "انشق من فوق إلى أسفل" (متى 27: 51). ولعل ذلك اليوم, كان أرهب الأيام عليهم, وأشقاها على التلاميذ, الذين قد تشتت شملهم بعد أن ضرب راعيهم, وهدم صرح آمالهم في "مسيا المنتظر", فقد كانوا هم أيضاً "يرجون أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل" (لوقا 24: 21). غير أن هذه المخاوف التي خيمت على قلوب التلاميذ منذ غروب شمس الجمعة, لم تكن سوى سحابة صيف, بددتها شمس صباح. الأحد, فتبدلت أتراحهم أفراحاً, واستحالت مخاوفهم يقيناً, واهتزت قلوبهم بنشوة الظفر, عندما سرت بينهم هذه البشرى: "الرب قام بالحقيقة"! (لوقا 24: 33). كل قبر محفور في الأرض, يعتبر موقعة ظفر للموت ملك الأهوال, لكن قبر المسيح صار مدفناً للموت, ومقبرة لأعوان الشر, ومطلع حكمة , وكنز عزاء, ومنبت أنوار للمؤمنين. ولا عجب فهو القبر المثمر "في بستان". وإذا حق للإنسان أن يعجب من قيامة الموتى, فمن حقه أن يعجب إذا لم يكن المسيح قد قام. لأنه "كان ينبغي أن يقوم المسيح من الأموات" (20: 9). فالقيامة هي الختم الإلهي, الذي كان ينبغي أن تتوج به حياة هذا الكامل الأوحد. لأننا نحن البشر الفاسدين نولد في الأرض, وعوامل الفساد تعمل فينا. فكأن حياتنا منسوجة بخيوط العدم. لأنها في أتم مظاهرها موت بطيء. لكن المسيح "قدوس الله", قد جاء أرضنا, وعاش بيننا, ولم "يكن لرئيس العالم فيه شيء" – بشهادة الأعداء والأصدقاء – فكان من المحتم, أن الذي تنزه جسده عن فساد الحياة, لا يرى أيضاً فساد القبر. إن قيامة المسيح, هي طابع رضى الآب عن ذبيحة الكفارية التي قدمها على الصليب. لأن كل ذبيحة مقبولة لدى الله, كانت ترتفع إلى السماء على نسمات رضى الله. فكان من المحتم إذاً, أن يرتفع المسيح بجسده إلى السماء, علامة رضى الآب عن ذبيحته. ولاشك في أن الذي فاز برضى الآب عنه عند نهر المعمودية (لو 3: 23), وكسب مسرة الآب به على جبل التجلي (مت 17:51), وظفر بتمجيد الآب له عند تل الجلجثة (يو 3: 28), يكون أيضاً حقيقاً برضى الآب عنه, بعد أن "أكمل" تدبير الفداء (يو 19: 30). إن قيامة المسيح, هي حصن إيماننا, وحجة قيامتنا العتيدة (1كو 15: 13 و14), وهي خير باعث لنا على السلوك في جدة الحياة (كو 3: 1 – 3). هي ختم بنوة المسيح الأزلية (رو 1: 4), وهي باب دخوله إلى المجد الذي كسبه لنفسه بآلامه وموته (في 2: 9 وعب 2: 9) وهي تاج عمل الفداء الذي قام به عنا, إذ "أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا" (رو 4: 25). بعد أن أدخل جسد المسيح إلى القبر, وضع على باب القبر حجر كبير, ثم "مضى رؤساء الكهنة والفريسيون وضبطوا القبر بحراس من قبل بيلاطس . وختموا الحجر" (مت 27: 62 – 66). فكان القبر إذاً, في قبضة أعداء المسيح, الذين أفرغوا جعبتهم في ابتكار أبرع الوسائل لحبس هذا الجسد المقدس داخل القبر. وكأنهم عقدوا مؤامرة مع الموت لإبقاء "قدوس الله" في ظلمة القبر. وفي الوقت نسه, كان تلاميذ المسيح المساكين محاطين بجو تسوده عوامل ثلاثة: أولها – يأسهم من المستقبل المظلم الذي ينتظرهم, بعد أن وضع الحجر الكبير على قبر سيدهم. والعامل الثاني – خوفهم من حاضرهم, غذ صاروا محاطين باليهود الذين سطوا على الراعي, فلا يتورعون من أن يبسطوا أيديهم على الرعية أيضاً. والعامل الثالث – أسفهم على ماض تركوا فيه أشغالهم, وودعوا أهلهم وذويهم, ليتبعوا إنساناً صار القبر غاية مصيره, فلو لم يكن المسيح قد قام, لما قامت لتلاميذه قائمة. ولو لم يمتلئ تلاميذه بيقين القيامة في أنفسهم, لصار مهد الكنيسة لحدها. من أجل هذا, اهتم كل البشيرين بتسجيل حادثة قيامة الفادي. إلا أن كلاً منهم حدثنا عن الحوادث المتعلقة بالقيامة من وجهة نظره الخاصة. ولا يبرح عن بالنا, أن يوحنا كاتب هذه البشارة, لم يقصد أن يقدم لنا تاريخاً وافياً للحوادث التي وقعت بين قيامة المسيح وصعوده – فإن بشارته كتبت في وقت كانت فيه الكنيسة المسيحية ملمة غاية الإلمام بالحوادث المتعلقة بالقيامة – ولكنه اختار من جعبة اختباراته الخاصة, بعض الحوادث, كنماذج تحمل بين طياتها رمزاً معنوياً لحقائق روحية, أراد أن يجعلها نصب أعيننا. فجاءت روايته, بحكم طبيعتها, متممة ومؤيدة لروايات من سبقوه من البشيرين. وجدير بالذكر, أن ما كتبه يوحنا في الأصحاحين التاليين, عن الحوادث المتعلقة بالقيامة, يقابله ما كتبه في الأصحاحين السابقين عن حوادث الصلب. في حوادث الصلب, أرانا بغضة اليهود للمسيح, وقد هوت إلى حضيض البغضاء والانتقام والإجرام. وفي حوادث القيامة, أرانا محبة التلاميذ وقد ارتقت من مستوى العيان المنخفض إلى أوج الإيمان الراقي. فإذا كان ظل الموت منعكساً على الأصحاحين السابقين, فإن نور الحياة الجديدة يسطع في أرجاء الأصحاحين التاليين. ولقد اهتم أيضاً يوحنا البشير بتدوين حوادث معينة, انتقاها لتكون صوراً حية تمثل شخصيات بارزة, بكل وضوح وجلاء – كشخصية بطرس , ويوحنا نفسه, وتوما, ومريم المجدلية. فمن الحوادث التي تفرد يوحنا بذكرها: إعطاء المسيح تلاميذه سلطاناً لإعلان الحل والعقد (يو 20: 23), وظهور المسيح لتلاميذه وتوما معهم في الأحد الثاني للقيامة (20: 26). هذا فضلاً عن حوادث الأصحاح الختامي. ومما يسترعي الالتفات, في الحوادث التي دونها يوحنا : درجات الإيمان, الممثلة في الأشخاص الذين آمنوا بحقيقة القيامة: (1) فالتلميذ "الذي كان يسوع يحبه" آمن نتيجة ثلاث علامات تجلت له, من غير أن يرى المسيح بالذات (20: 8). (2) و"مريم المجدلية" آمنت بعد أن سمعت المسيح منادياً إياها باسمها (20: 14 – 16). (3) و"التلاميذ" آمنوا إذا رأوا جروح الرب (20: 20). (4) و"توما" آمن بعد أن عرض عليه المسيح أن يضع يده في جنبه كما طلب (20: 27). أما أرقى درجة في الإيمان, فقد جعلها المسيح من نصيبنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور: "طوبى للذين آمنوا ولم يروا" (20: 29). ومع أنه من الصعوبة بمكان, أن نعين بالضبط, الوقت الذي وقعت فيه الحوادث المتعلقة بالقيامة, إلا أننا نستطيع أن نقدر وقتنا تقريباً, لبعض تلك الحوادث, استناداً إلى أوثق المصادر:
أما المرات التيِ ظهر فيها المسيح مدة الربعين يوماً التي توسطت بين قيامته وصعوده, فقد استطعنا أن نرتبها في الجدول الآتي – على قدر ما وصل إليه علمنا, بعد البحث والاستقراء:
1ٍوَفِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ إِلَى الْقَبْرِ بَاكِراً خامساً: القيامة (20: 1 – 3) هذا أصحاح الحياة الجديدة. فلا غرو إذا كان قلبه نابضاً بحياة الإيمان وإيمان الحياة: "فرأى وآمن" (20: 8). ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام: (1) العلامات الثلاث المثبتة لحقيقة القيامة (20: 1 – 10). (2) الظهور المثلث (20: 11 – 29). (3) غاية يوحنا من كتابة بشارته (20: 30 و31). (1) العلامات الثلاث المثبتة لحقيقة القيامة: أ – العلامة الأولى: القبر المفتوح (20: 1 و2) – هذه العلامة رأتها مريم وخبرت بها – ب – العلامة الثانية: القبر الخالي – أكفان ولا جسد (20: 3 – 6): هذه العلامة تحققها بطرس ويوحنا – ج – العلامة الثالثة: المنديل الملفوف على حدة (20: 7 – 10). هذه العلامة وسابقتها كانتا سبباً في إيمان بطرس ويوحنا. (أ) العلامة الأولى – القبر المفتوح (20: 1 و2) عدد 1. (1) مريم المجدلية ترى القبر المفتوح: "في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً والظلام باق. فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر". ينتهي الأصحاح السابق ببدء آخر "سبت يهودي" في العهد القديم. ويستهل هذا بغرة أول "سبت مسيحي" في العهد الجديد. وما كاد يحل آخر سبت يهودي على العالم حتى كان ظلام البشرية على أشده. لأن جسد مخلص الأنام كان قد أودع في القبر ووضع على القبر حجر , ولكن ما كاد يبزغ فجر السبت المسيحي الأول, حتى كانت أنوار الفداء قد عمت الأرجاء وَالظّلاَمُ بَاقٍ. فَنَظَرَتِ الْحَجَرَ مَرْفُوعاً عَنِ الْقَبْرِ. 2فَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَإِلَى التِّلْمِيذِ الآخَرِ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ وَقَالَتْ لأن "شمس البر" قام من قبره قبل أن تقوم شمس الطبيعة من خدرها فكان خليقاً بالذي بدد ظلمة القبر, أن يقوم والظلام مخيم على الأرض. من أجل ذلك لم يستطع أحد أن يرى "كيف" قام المسيح, ومع أننا نؤمن إيماناً وطيداً أن المسيح قام "حقاً". فديانته ليست ديانة "الكيف" بل ديانة "الحق". يستهل هذا الأصحاح بآية, تنبئنا بـ"الآية" الأولى المثبتة لحقيقة القيامة وهي – القبر المفتوح. ومن العجيب أن أول من شهد هذه "الآية", امرأة لم تكن في حياتها السابقة ذات مركز اجتماعي سام – مريم المجدلية([1]) التي يقول عنها لوقا إن الرب "أخرج منها سبعة شياطين" (لو 8: 2). فلا عجب إذا رأيناها مبكرة وذاهبة إلى القبر في مقدمة الجميع, لأنها كانت في مقدمة من غمرتها أفضال المسيح. فثقل الدين يقابله ثقل في المسئولية. عدد 2. (2) المجدلية تخبر بطرس ويوحنا بما رأت: "فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه". يستنتج من تكلم مريم بصيغة الجماعة: "لسنا نعلم أين وضعوه", أنها كانت تتكلم عن لَهُمَا: «أَخَذُوا السَّيِّدَ مِنَ الْقَبْرِ نفسها وهن النساء اللواتي ذهبن إلى القبر بزعامتها, ومعهن حنوط لتعطير جسد المسيح (مت 28: 21 ومر 16: 2 ولو 24: 10). ويستفاد مما كتبه البشيرون الأولون, أن مريم والنساء اللواتي كن معها, كن يقلن فيما بينهن, في طريقهن إلى القبر: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ ولما وصلن إلى القبر وجدن الحجر قد تدحرج عنه, وإذ لم يعرفن شيئاً عن كل ما حدث اندهشن. وحالما دخلن القبر, ولم يجدن جسد الرب تحيرن جداً. أما مريم المجدلية فظنت أن جسد الرب قد سرق. ويفهم من قولها: "أخذوا السيد", أنها ربما ظنت أن اليهود قد سرقوا جسد الفادي, أو أن يوسف الرامي ونيقوديموس قد نقلا الجسد من القبر إلى مرقد آخر. فاختلجت في قلبها لوعة يمازجها الحزن والدهشة, فلم تتمالك نفسها من أن تترك القبر وسائر النساء هناك, وتهرول راكضة إلى بيت بطرس الذي لم يزل بعد محسوباً من زعماء الرسل – على رغم انتشار خبر إنكاره لسيده, وإلى بيت يوحنا "التلميذ الذي كان يسوع يحبه". وهو الذي ظل ملازماً سيده حتى آخر لحظة, "وقالت لهما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه"! حسن أن مريم وهي تتكلم عن "الجسد" الذي في القبر, قالت: "السيد". فهي إذاً كانت أحكم من نفسها وهي لا تدري, لأن الرب كان قد قام وقتئذ. فهو إذاً حي. غير أن مريم, وقعت في سلسلة أغلاط بسبب ضعفها البشري. فقد ذهبت إلى القبر لتعطر جسد يسوع الإنسان, وغاب عنها أن هذا الجسد قد ارتقى إلى العلاء, فتعطرت برائحته كل أجواء السماء. وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ». 3فَخَرَجَ بُطْرُسُ وَالتِّلْمِيذُ الآخَرُ وَأَتَيَا إِلَى جاءت إلى القبر علها ترى جسد المصلوب ممسكاً بسلاسل القبر وقد فاتها أن يد الظلام لا تقوى على ملامسة أهداب "نور العالم". جاءت لتقدم فروض ولائها لإنسان ذهب ضحية ظلم الناس. وقد نسيت أن من أوجب واجباتها أن تقدم عباداتها لهذا المخلص العجيب, الذي التقت فيه رحمة الله بعدالته. مسكينة هذه المجدلية إذ توهمت أن "السيد" أمسى جثماناً هامداً, يستطيع أعداؤه أن "يأخذوه", وقد سهى عليها, أن السيد هو العزيز المقتدر, رب الموت والحياة. ظنت مريم أن كل هذا حدث بفعل أيدي الناس, فتعذبت. مع أنها لو أدركت أن يد الرب, هي التي فعلت كل هذا, لتعزت. إننا في نفس الوقت مدينون لمريم المجدلية بجهلتها وغفلتها. فلو كانت مريم متوقعة قيمة الرب من الأموات, لوجد أمام المعترضين مجال متسع للقول: إن حادثة القيامة تكونت في فكر مريم, نتيجة وساوس, واختلاط عقلي في ذهنها. وهل من ريشة تستطيع أن ترسم لنا مبلغ تأثر مريم أم المخلص بهذا الخبر, حين بلغها وهي مقيمة مع يوحنا في بيته؟ (19: 27). (ب) العلامة الثانية: القبر الخالي. أكفان ولا جسد (20: 3 – 6) عدد 3 و4. (1) بطرس ويوحنا يذهبان إلى القبر مسرعين: سمع الرسولان هذا الخبر الغريب, فخرجا مسرعين إلى القبر. أما بطرس فكان – على ما نعهده فيه من الاندفاع – أسبق الاثنين إلى الانطلاق. وربما وصلت الْقَبْرِ. 4وَكَانَ الاِثْنَانِ يَرْكُضَانِ مَعاً. فَسَبَقَ التِّلْمِيذُ الآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءَ أَوَّلاً إِلَى الْقَبْرِ 5وَﭐنْحَنَى فَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً وَلَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ. المجدلية إلى بيته قبل أن تصل إلى بيت يوحنا (عدد 2). أما يوحنا , فلكونه أصغر الاثنين سناً, فقد استطاع أن يلحق ببطرس "وكان الاثنان يركضان معاً". ومن ثم سبق يوحنا وبطرس وجاء أولاً إلى القبر. فالغيرة قد تكون أسبق من المحبة في بدء الطريق, لكن المحبة تسابق الغيرة وتسبقها في النهاية. عدد 5. (2) يوحنا ينحني على باب القبر, فيحقق العلامة الثانية: "وانحنى" – أي يوحنا . وعلة انحنائه أن باب القبر كان منخفض – "فنظر الأكفان موضوعة", فحقق ما قالته مريم أن "الجسد ليس في القبر". ولعله تعجب من أن الذين أخذوا الجسد, لم يأخذوا الأكفان أيضاً, اقتصاداً في الوقت والتعب. هذا إذا كان الذين أخذوا الجسد, من أعداء المسيح. أما إذا كانوا من أحبائه, فلا يعقل أنهم يأخذون الجسد ويتركون الأكفان. فمن المحقق إذاً, أن اليد التي رفعت الجسد من القبر, ليست يد إنسان – عدواً كان أم صديقاً. ما هذه إلا يد الله. وقد يلذ لنا أن نذكر أن الكلمتين: "انحنى ونظر", مترجمتان إلى العربية عن كلمة واحدة في اللغة الأصلية – وردت أيضاً في عدد 11 – وهي عين الكلمة التي بها وصف بطرس لرسول موقف الملائكة تجاه "أمور" الفداء: "تشتهي ...... أن تطلع عليها" (1 بط 1: 12). ولكون يوحنا متهيباً بطبيعته, لم يدخل القبر, وربما وقف واجماً لشدة حزنه على سيده. 6ثُمَّ جَاءَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَتْبَعُهُ وَدَخَلَ الْقَبْرَ وَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً 7وَﭐلْمِنْدِيلَ الَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعاً مَعَ الأَكْفَانِ بَلْ مَلْفُوفاً فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ. 8فَحِينَئِذٍ دَخَلَ أَيْضاً التِّلْمِيذُ الآخَرُ عدد 6. (3) سمعان بطرس يصل بعد يوحنا , ويدخل القبر, فيرى العلامة الثانية: "ثم جاء سمعان بطرس يتبعه" – لأنه كان أكبر من يوحنا سناً, ونظراً لكونه عملياً في محبته وجسوراً, لم يقف عند حد النظر إلى القبر, بل اندفع كعادته "ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة". الكلمة المترجمة "نظر", معناها الحرفي "نظر بإمعان وتدقيق", فأبصر ما لم يستطع أن يراه يوحنا في لمحته العاجلة. (ج) العلامة الثالثة: المنديل الملفوف على حدة (20: 7 – 10). عدد 7. (1) بطرس يرى هذه العلامة أولاً: "والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعاً مع الأكفان بل ملفوفاً في موضع وحده". هذا مفاده أن المنديل كان ملفوفاً بكل عناية , وموضوعاً من غير عجلة, في مكان على حدة. وردت هذه الكلمة "منديل" مرة أخرى في هذه البشارة (11: 14). عدد 8. (2) يوحنا يقتدي ببطرس ويدخل القبر فيرى هذه العلامة: "فحينئذ دخل أيضاً التلميذ الآخر" – أي يوحنا البشير – "الذي جاء أولاً إلى القبر ورأى فآمن". ما أقوى تأثير الإنسان على غيره, وأشد تأثره من الآخرين! فقد كان لشجاعة بطرس وإقدامه في هذا الظرف الخاص, أجمل تأثير في يوحنا وهو لا يدري. فأمام شجاعة بطرس وإقدامه, اختفى تهيب الَّذِي جَاءَ أَوَّلاً إِلَى الْقَبْرِ يوحنا وإحجامه, لذلك يقول يوحنا – وهو خير من يحدثنا عن نفسه, وأن يكن آخر من يذكر لنا اسمه: "فحينئذ دخل أيضاً التلميذ الآخر الذي جاء أولاً إلى القبر". والظاهر أن يوحنا لم يستطع أن يرى المنديل الملفوف, وهو منحن على باب القبر (عدد 5), لأن المنديل كان موضوعاً في مكان داخلي, ولأن يوحنا كان قد ألقى لمحة عاجلة على محتويات القبر, فاته أن يرى ما رآه بعد أن دخل. (3) تأثير هذه العلامة في يوحنا : "ورأى فآمن". بأي شيء آمن يوحنا؟ أبمجرد الخبر المبهم المزعج, الذي أنبأته مريم المجدلية؟ كلا. لكنه آمن أن الرب قد قام, لأنه بعد أن رأى الأكفان موضوعة, والمنديل ملفوفاً بكل عناية , وموضوعاً على حدة, اقتنع, وآمن بأن المسيح قد قام. لأن في لف المنديل بهذه العناية, ووضعه على هذا النظام, دليلاً على أن اليد التي مدت إلى القبر, ليست لص سارق. لأن السارق بعد أن ينهب ما يريد بكل عجلة, يترك الباقي مبعثراً مشتتاً. هذه إذاً يد عزيز مقتدر يجري أعماله بتأن, ودقة, وعناية, ونظام. بل هذه يد المسيح نفسه إله القدرة والتأني, الذي في أيام جسده, كان ذاهباً ليقيم فتاة ميتة, فتمهل في طريقه, وبكل عناية شفى امرأة مريضة (لوقا 8: 41 – 55). بل هذه يد المسيح, إله الترتيب والنظام, الذي يهتم بعظائم المخلوقات, اهتمامه بأصاغرها. فهو يكسو البلوطة الضخمة, مهابة وجلالاً, ويقيض على البنفسجة الصغيرة بهاء وجمالاً. وَرَأَى فَآمَنَ 9لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرِفُونَ الْكِتَابَ: إن القول بأن يوحنا "آمن أن المسيح قام من الأموات", هو تعبير آخر للقول, بأن يوحنا آمن أن يسوع هو المسيح. وإذا ما أضفنا هذه الكلمة: "آمن", إلى درجات السلم التي ارتقى إليها إيمان التلاميذ في ما مر بنا من هذه البشارة (1" 38 و2: 11 و11: 15 و14: 11), اتضح لنا, أن هذه أرقى درجة بلغها إيمان يوحنا , في سجل بشارته. عدد 9. (4) علة تباطؤ إيمان الرسل – بما فيهم يوحنا . لم يقل يوحنا عن نفسه أنه "رأى وآمن", بنغمة الفخور المعجب بذاته, كأنه كان أسبق الرسل إلى هذا الإيمان الذي هو وليد العيان. كلا. وإنما قالها بروح التواضع, الذي يمازجه شيء من الخجل, لأنه لم يستطع أن يؤمن إلا بعد أن رأى. من أجل ذلك, نراه يدمج نفسه مع سائر الرسل, في الكلام عن تباطؤ إيمانهم: "لأنهم" – أي الرسل بما فيهم يوحنا – "لم يكونوا بعد" – أي إلى الآن – "يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات" فإذاً جهل الرسل بما في الكتب, هو علة تباطئهم في الإيمان بقيامة المسيح. ألا تحمل هذه الكلمات بين جنباتها, اعترافاً ضمنياً, بأن رسل المسيح كانوا أقل من اليهود انتباهاً لكلام السيد؟ لأن متى يخبرنا في بشارته: أن "رؤساء الكهنة والفريسيين اجتمعوا إلى بيلاطس قائلين: يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد ثلاثة أيام أقوم" (متى 27: 62 و63). فكأن أعداء المسيح, كانوا أسرع من أحبائه إلى فهم كلامه. وما أكثر أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ الأوقات التي يكون فيها "أبناء هذا الدهر, أحكم من أبناء النور في جيلهم (لو 16: 8)! أما "الكتاب" الذي يقول يوحنا , إنه هو وسائر الرسل "لم يعرفوه", فهو ما كتب عن المسيح في ناموس موسى , والأنبياء, والمزامير – سيما هذا السفر الأخير (مز 16:10). (قابل هذا بما جاء في لوقا 24: 25 و44). من هذا نستنتج: (ا) أن حوادث كثيرة, تظل أمامنا كسفر مختوم, حتى يقيض عليها الزمان نوراً ساطعاً, فتلألأ أمامنا في ضوء الاختبار, وفي نور روح إرشاد المسيح (لوقا 24: 45). (ب) إن في قيامة المسيح مفتاحاً لأسرار الكتاب. وبغيرها يظل "الكتاب" سفراً مختوماً. (ج) لو لم يكن المسيح قد قام, لكان من المحتم أن يقوم. لأن قيامته ليست "فرض كفاية" بل هي "فرض عين ": "ينبغي لأن يقوم من الأموات". هذه مرة أخرى, قال فيها لبشير كلمة : "ينبغي" في عرض كلامه عن شخص المسيح. وقد يكون من المفيد لنا, أن نستعرض في لمحة موجزة, المواضع التي ارتبطت فيها هذه الكلمة الحتمية: "ينبغي" بحياة السيد. "ينبغي أن يرفع ابن الإنسان" (يوحنا 3: 14 و12: 34) – هذا فرض الفداء الاختياري. "ينبغي أن يذهب إلى أورشليم " (متى 16: 21) – هذا فرض الوصية التي قبلها المسيح من الآب. "فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون" (متى 26: 54, لوقا 9: 22, 24: 7, 26: 44) – هذا فرض المكتوب. "ينبغي أن أكون في ما لأبي" (لوقا 2: 49) مِنَ الأَمْوَاتِ. 10فَمَضَى التِّلْمِيذَانِ أَيْضاً إِلَى مَوْضِعِهِمَا. - هذا فرض شعور المسيح ببنوته الأزلية للآب. "ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك" (لوقا 19: 5) – هذا فرض المحبة الغافرة المتنازلة. "ولي خراف أخر ..... ينبغي أن آتي بتلك أيضاً" (يو 10: 16) – هذا فرض النصرة النهائية, التي ستبلغها كنيسة المسيح عند كمالها. "ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار " (يو 9: 4) – هذا فرض المهمة المعجلة التي تقلدها المسيح من الآب. "أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيراً" (مرقس 8: 31) – هذا فرض المحبة الإلهية الفدائية. "ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة" (لوقا 24: 7) – هذا فرض الخيانة البشرية. عدد 10. (5) رجوع بطرس ويوحنا إلى موضعهما: "فمضى التلميذان أيضاً إلى موضعهما". مضى كل من التلميذين إلى محل إقامته في أورشليم , بعد أن شرفتهما العناية برؤية ذلك القبر الخالي. أما يوحنا فسار في طريقه والإيمان يملأ قلبه. وأما بطرس , فمضى في سبيله, متفكراً في العلامات التي عاينها بنفسه في القبر. وفي الغالب, لم يبلغ درجة الإيمان اليقيني بالقيامة, إلا بعد أن افتقده الرب برحمته, وظهر له بنفسه, حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم عينه (لو 24: 34 و1 كو 15: 5). ومع أننا لا ندري شيئاً عن الحديث الذي دار بين بطرس وسيده في هذه المقابلة, إلا أنه من السهل علينا أن نتصور, أن إنكار بطرس لسيده لم يكن خارجاً عن موضوع حديثهما في هذه المرة, التي هي أول مرة التقيا فيها بعد تلك النظرة الفاحصة المذيبة (لوقا 22: 62). 11أَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ الْقَبْرِ خَارِجاً تَبْكِي. وَفِيمَا هِيَ تَبْكِي انْحَنَتْ إِلَى الْقَبْرِ 12فَنَظَرَتْ ملاَكَيْنِ بِثِيَابٍ بِيضٍ جَالِسَيْنِ (2) الظهور المثلث (20: 11 – 29). ينبئنا هذا الفصل, بثلاث مرات أظهر فيها المسيح ذاته: - أ – لمريم المجدلية (20: 11 – 18) – ب – لتلاميذه في غياب توما عنهم (20: 19 – 25) – ج – لتلاميذه وتوما معهم (20: 26 – 29). - أ – ظهور المسيح لمريم المجدلية (20: 11 – 18). (1) مريم متحيرة باكية: (20: 11 – 13). عدد 11. – أ – حزن مريم المجدلية وولاؤها: "أما مريم فكانت واقفة عند القبر تبكي". بعد أن أتمت مريم مأموريتها التي قامت بها خير قيام, بإبلاغها خبر القبر الخالي إلى بطرس ويوحنا, عادت إلى القبر من طريق غير الطريق الذي رجع منه بطرس ويوحنا. ومن شدة ولائها لسيدها ظلت واقفة عند القبر تبكي. لكن عين المحبة المخلصة المتألمة, الطهورة, لا تكتفي بذرف الدموع, بل تريد دائماً أن تتطلع, علها ترى من خلال الدموع, ما يعيد إليها اطمئنانها, ويرد لها ما غاب عنها, ومن فقدت: "وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر". عدد 12. – ب – مريم ترى ملاكين حيث كان جسد يسوع موضوعاً "فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين, واحداً عند الرأس, والآخر عند الرجلين, حيث كان جسد يسوع موضوعاً". ما أبهى هذا المنظر وَاحِداً عِنْدَ الرَّأْسِ وَالآخَرَ عِنْدَ الرِّجْلَيْنِ حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ مَوْضُوعاً. 13فَقَالاَ لَهَا: «يَا امْرَأَةُ لِمَاذَا تَبْكِينَ؟» قَالَتْ لَهُمَا: «إِنَّهُمْ أَخَذُوا العجيب, الذي رأته مريم! إنه شبيه بمنظر الكروبين اللذين كانا"مظللين الغطاء حيث حل مجد رب الجنود قديماً" (خر 25:22, 1 صم 4:4, 2 صم 6:2, مز 80:1, 109: 1). ولكن على رغم ما في هذا المنظر من جمال وبهاء, فإن مريم لم ترض به بديلاً عن سيدها. ومن العجيب, أنها لم تستغرب رؤية الملاكين, ولم تخف منهما. لأن حزنها العميق وانشغالها الشديد بالعثور على جسد سيدها, ملكاً عليها كل مشاعرها, فتغافلت عن كل شيء عداه. إن قول يوحنا , بأن ملاكين ظهرا لمريم, لا يتنافى ورواية متى , بأن ملاكاً واحداً ظهر لسواها من النساء (متى 28: 5). لأن ذلك الملاك الواحد ظهر للنساء, في الفترة التي تركتهن فيها مريم وانطلقت لتخبر الرسولين بما رأت. وأما الملاكين فقد ظهرا لمريم بعد انصراف سائر النساء. عدد 13 – ج – سؤال الملاكين وجواب مريم: "فقالا لها يا امرأة لماذا تبكين"؟ قد أوضحنا معنى كلمة "امرأة" – كما وردت في الأصل – في 2: 4, فاطلبها هناك. "قالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه". مع أن جواب مريم عن سؤال الملاكين, يتفق في جوهره وقولها الذي خبرت به بطرس ويوحنا (عدد 2), إلا أنهما يختلفان في كلمتين: أولاهما – أنها في كلامها مع بطرس ويوحنا, قالت "السيد" بصيغة التعميم. ولكن في جوابها للملاكين قالت "سيدي" – بصيغة التخصيص. وثانيهما: سَيِّدِي وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ». 14وَلَمَّا قَالَتْ هَذَا الْتَفَتَتْ إِلَى الْوَرَاءِ فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَاقِفاً أنها في حديثها مع الرسولين تكلمت بصيغة الجماعة: "نعلم". ولكنها في كلامها مع الملاكين, تكلمت بصيغة المفرد: "أعلم". فكأنها في كلامها الأخير, عبرت عن خسارتها الشخصية وحيرتها الفردية, اللتين أصابتاها, بفقدانها جسد سيدها. (2) مريم غافلة (20: 14 و15). عدد 14 – أ – مريم ترى يسوع ولا تميزه: ما كادت مريم تفرغ من إجابتها الملاكين عن سؤالهما, حتى حانت منها التفاتة إلى الوراء. ولعلها لم ترغب في مواصلة الحديث مع الملاكين, لأنها لم تر في نغمة كلامهما بارقة أمل بإزالة سبب حيرتها. أو ربما لأنها أحست بطريقة ما, أن شخصاً آخر قد حضر. أو كما يقول يوحنا الذهبي الفم: إنها لمحت على وجهي الملاكين إمارات جديدة – ولعلها إمارات تهيب وإعجاب, مما دلها على أنهما يرحبان بقدوم شخص عجيب! " فنظرت يسوع واقفاً ولم تعلم أنه يسوع". ولكم من المرات يتراءى لنا يسوع في سبيل حياتنا اليومية, ونحن عن قدومه غافلون! فقد يتراءى لنا في صورة فقير بائس ينتظر عوناً, أو في شكل ضيف يجلس على موائدنا ينتظر سخاءنا, أو في هيئة جليس يستمع لأحاديثنا. يعزى جهل مريم بحقيقة يسوع إلى: (1) عدم توقعها أن تراه. (2) التغير الذي طرأ على جسده بعد القيامة. لأن جسده القدوس, استمر إلى ساعة موته خاضعاً لنواميس طبيعتنا البشرية المحدودة. لكنه بعد القيامة كان وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ يَسُوعُ. 15قَالَ لَهَا يَسُوعُ: «يَا امْرَأَةُ لِمَاذَا تَبْكِينَ؟ مَنْ تَطْلُبِينَ؟» فَظَنَّتْ تِلْكَ أَنَّهُ الْبُسْتَانِيُّ فَقَالَتْ لَهُ: «يَا سَيِّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ يدخل, ويخرج, ويظهر, ويغيب, على أسلوب خفي لا يستقصى (20: 19). (3) ربما لأن عيني مريم أمسكتا عن معرفة شخص المسيح, مثلما أمسكت أعين تلميذي عمواس عن مرأى سناه (لوقا 24: 16). عدد 15 – ب – سؤال المسيح وجواب مريم: ".... يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟". هذه هي أولى الكلمات التي نسمعها من المسيح بعد قيامته. سؤالان عجيبان – أولهما ممهد لثانيهما, وثانيهما مؤيد ومفسر لأولهما. "لماذا تبكين؟ من تطلبين؟" بهذه الكلمات, سأل المسيح مريم عن علة بكائها, وسبب عذابها, الذي هو أيضاً مصدر عزائها: "لماذا تبكين؟ من تطلبين؟" – وهل تخلو هذه الكلمات من تنبيه ضمني من المسيح لمريم, على خطأها ببكائها؟ فكأني به يقول لها: "أخطأت بطلبك الحي بين الأموات"! أما مريم, فظنت أن الذي يكلمها هو "البستاني". لأن قبر المسيح كان في بستان فكان من الطبيعي, أن تتوقع مريم وجود البستاني هناك. فقالت له "يا سيد إن كنت أنت" – أنت لأي واحد من الأعداء – قد حملته, فقل لي أين وضعته وأنا آخذه". من العجيب, أن مريم في حزنها لم تحسب حساباً لضعف قوتها, فتوهمت أن في إمكانها – وهي امرأة ضعيفة – أن ترفع جثة من موضعها. لكنها, في كل كلامها – سواء مع بطرس ويوحنا, أو مع الملاكين, أو مع يسوع الذي ظننته البستاني – كانت تتكلم عن المسيح قَدْ حَمَلْتَهُ فَقُلْ لِي أَيْنَ وَضَعْتَهُ وَأَنَا آخُذُهُ». 16قَالَ لَهَا يَسُوعُ: «يَا مَرْيَمُ!» فَالْتَفَتَتْ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ: كأنه شخص حي, ماثل أمامها. فلم تقل مرة واحدة: "جسد ", ولا "جثة", بل قالت: "السيد" (عدد 2) و"سيدي" (عدد 13). ولكون المسيح حاضراً في ذهنها هي, ظنت أنه حاضر أيضاً في ذهن غيرها, فقالت عنه في عدد 15, "حملته" ... "وضعته" ... آخذه", من غير أن تذكر اسمه بالذات. عدد 16. (3) مريم مؤمنة: "قال لها يسوع يا مريم"! إن مخاطبة المسيح إياها في العدد السابق بالقول: "يا امرأة" لم يقابل منها بأي اهتمام, لأن الملاكين سبقا فخاطباها بنفس هذه الكلمة (عدد 13) فلم تر فيها شيئاً جديداً. لكنها عندما سمعت هذا الشخص العجيب يناديها باسمها, تأكدت أنه هو راعيها الصالح, الذي يناديها باسمها الخاص. ومن أسباب عزائنا, أن نذكر أن راعينا الصالح, هو أيضاً طبيبنا الحكيم, فهو لا يسلط نوره دفعة واحدة على العيون المغمورة بظلال الفجر, بل يقدم لها النور تدريجياً. في بادئ الأمر خاطب المسيح المجدلية بقوله لها: "يا امرأة", وعندما وجدها على استعداد لقبول مزيد من النور, قال لها: "يا مريم". وربما لو ابتدرها بالقول: "يا مريم" لصعقت من شدة الفرح وفرط العجب. وكأن مريم كانت ضالة في برية أحزانها, تائهة عن حقيقة ذاتها, غافلة عن شخصية راعيها, فلما سمعت الراعي الصالح يناديها باسمها, ردت نفسها إليها, وإلى راعيها. عندئذ "التفتت" – كأنها كانت «رَبُّونِي» الَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمُ. 17قَالَ لَهَا يَسُوعُ: «لاَ تَلْمِسِينِي لأَنِّي لَمْ إلى الآن مطرقة بوجهها إلى الأرض حياء, وهي تخاطبه, أو ربما كانت ناظرة هنا وهنالك, من فرط حيرتها, ولعلها كانت قد اتجهت ببصرها مرة أخرى إلى القبر (عدد 14) وهنا استجمعت كل ما عندها من قوة الرجاء, واليقين, والإعجاب, والتعبد, وارتمت عند قدميه محاولة أن تمسك بهما, أو بهدب ثوبه (قابل هذا بما جاء في متى 28: 9 و10), وعبرت عن شعورها بكلمة واحدة, لفظتها بلغتها العبرية: "ربوني"! الذي تفسيره "يا معلم". إن كلمة "ربوني" أقوى وأرفع من كلمتي "راب" و"رباي". ومعناها "المعلم الأعظم". وقد قالتها مريم معبرة بها عن يقين معرفتها بشخص المسيح, وعظم ابتهاجاً برؤيته حياً مقاماً, وشدة تكريمها له بعد قيامته من الأموات. (4) مريم مبشرة: (20: 17 و18) عدد 17. (1) مريم تتسلم البشرى: "قال لها يسوع لا تلمسني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم". تتضمن هذه الكلمة: تنبيهاً لمريم عن خطأها, وعلة هذا التنبيه: "لا تلمسيني لأني ....". الكلمة المترجمة, "تلمسيني", معناها الحرفي: "لا تمسكيني وتتعلقي بي". ولو كانت هذه لمسة من يريد أن يتحقق أن للمسيح جسداً حقيقياً بعد القيامة "لسمح لها المسيح بها, ودعاها إليه, لأنه واضح من لوقا 24: 38, أن المسيح لم يكتف بأن سمح للتلاميذ بأن يلمسوه, بل دعاهم وأمرهم أن "يجسوه", في نفس هذا اليوم. أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلَكِنِ اذْهَبِي إِلَى أخوتي وظاهر أيضاً من يوحنا 20: 27, أن المسيح قال لتوما, بعد أسبوع من هذا التاريخ: "هات يدك وضعها في جنبي". ولكن هذه لمسة من ظنت أن صلة المسيح بتلاميذه بعد قيامته, ستعود مثلما كانت قبل القيامة, عن طريق الحواس الطبيعية, كالنظر واللمس والسمع. من أجل ذلك نبهها المسيح إلى أن مدة معاشرته الجسدية لتلاميذه وأتباعه, قد انقضت, وأن لا سبيل إلى شركتهم معه بعد القيامة, إلا عن طريق روحه الأقدس (14: 18 و19 و20 و16: 20 – 28). وبما أن الروح القدس, لم يكن قد أعطى بعد, لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد (7: 39), لذلك أفهمها الفادي, أن موعد هذه الشركة الروحية لم يأت بعد. إذ قال لها: "لأني لم أصعد بعد ...". فقبل القيامة, كان المسيح عائشاً بالجسد مع تلاميذه, ولكن بعد الصعود, عاش فيهم بروحه. هذا يوافقه قول الرسول: "وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد, لكن الآن لا نعرفه أيضاً" (2 كو 5: 16) (2) مهمة معجلة: "ولكن اذهبي إلى أخوتي ...". كأنه أراد أن يقول لها: "بدلاً من أن تصرفي وقتك وجهودك في ما لا طائل تحته, لأن أوانه لم يأت بعد, "اذهبي إلى أخوتي ...". هذه مهمة جليلة, أبان فيها السيد: (ا) الشرف الممتاز الذي وهبه السيد لمريم المجدلية, بأن جعلها "رسولة" الرسل: "اذهبي ...". ألا نلاحظ أن المسيح, إذ أوصى مريم بهذه الوصية, متعها بأعظم مما كانت تطلب أو تتمنى؟ تمنت هي أن تمسك وَقُولِي لَهُمْ: إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَإِلَهِي وَإِلَهِكُمْ». قدميه, شرفها هو بأن جعلها تبلغ أول رسالة عن قيامته المجيدة. وهل من فرصة يتمتع فيها الإنسان بمعاشرة المسيح, نظير المجال الذي يظفر به من يكون خادماً له: "حيث أكون هناك أيضاً يكون خادمي"؟ (ب) أخوة التلاميذ للمسيح: "إلى أخوتي". قبلاً سماهم "عبيداً", ودعاهم "أحباء", وكأنه رأى أن هذين اللقبين غير كافيين, فجاد عليهم بلقب جديد ممتاز: "أخوة" – دلالة على متانة الاتحاد الروحي الكائن بينه وبينهم. (ج) امتياز بنوة المسيح بنوة التلاميذ: "وقولي لهم: إني أصعد". لم يقل المسيح في رسالته لمريم: "قولي لأخوتي إني قمت", بل "إني أصعد". وكأن القيامة كانت عربون الصعود, أو هي الخطوة التمهيدية التي تكملت بالصعود. هذا دليل على أن الصعود عمليته تمت تدريجياً في خطوات متتابعة, فكانت القيامة أولى هذه الخطوات. وكان انطلاق المسيح إلى السماء خاتمة هذه الخطوات. ومن الأمور التي تستدعي دقة الملاحظة, أن المسيح لم يشرك التلاميذ معه في صلته بالآب, بل جعل بنوته للآب, متميزة وممتازة عن بنوتهم هم, فقال: "إلى أبي وأبيكم", لا "إلى أبينا". لأن بنوته للآب, تمتاز عن بنوة المؤمنين: في النوع, والرتبة, والطبيعة. فالمسيح هو الابن, بحق طبيعي, لكن التلاميذ وسائر المؤمنين هم أبناء بالتبني. قال المسيح: "إلهي", باعتبار كونه "ابن الإنسان المتجسد" لأجل خلاص البشر – حتى في هذه النسبة أيضاً يمتاز الفادي عن البشر. 18فَجَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ التّلاَمِيذَ أَنَّهَا رَأَتِ الرَّبَّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هَذَا. 19وَلَمَّا كَانَتْ عدد 18. (ب) مريم تبلغ البشرى إلى التلاميذ: "فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا". هذه أول بشرى في تاريخ كنيسة العهد الجديد, بل هذه هي البشارة الدائمة التي ينبغي أن ينادي بها كل فرد, بناء على اختباره الخاص: "رأيت الرب". إن قول البشير: "فجاءت مريم وأخبرت" – كما ورد في الأصل – يفيد أن مريم حالما رجعت من القبر, بدأت تلهج بخبر القيامة. وهكذا يكافئ الرب منتظريه. فقد بقيت مريم عند الصليب, وبكرت عند القبر, فتمتعت ببركة الوعد القائل: "الذين يبكرون إلي يجدونني". إن في هذا برهاناً ضمنياً على صدق البشيرين, وإلا لقالوا إن أول من رأى الرب, هو بطرس "الصخرة", أو مريم العذراء "أم المخلص", لا مريم المجدلية "التي أخرج منها الرب سبعة شياطين". - ب – ظهور المسيح للتلاميذ في غياب توما (20: 19 – 23). في هذه المرة عالج المسيح خوف تلاميذه, مثلما كافأ في ظهوره السابق إيمان مريم (20: 11 – 18). في تلك المرة ظهر المسيح لتلاميذه في الصباح. وفي هذه المرة, في المساء. الظهور السابق كان لفرد. وهذا, لجماعة, ذلك الظهور كان في الخلاء عند القبر, وهذا في المدينة أورشليم , وفي غرفة خاصة. عَشِيَّةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ أَوَّلُ الأُسْبُوعِ وَكَانَتِ الأَبْوَابُ مُغَلَّقَةً حَيْثُ كَانَ التّلاَمِيذُ مُجْتَمِعِينَ لِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنَ الْيَهُودِ ينقسم هذا الفصل إلى قسمين: (1) خوف التلاميذ (20: 19 (أ)), (2) ظهور المسيح المقام وعطاياه لتلاميذه (20: 19 (ب) – 23). عدد 19 (أ). (1) خوف التلاميذ: "ولما كانت عشية ذلك اليوم" – وهو أول الأسبوع – "وكانت البواب مغلقة, حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود". يضع البشير أهمية خاصة على "ذلك اليوم" لأنه صار يوم الرجاء للرسل وللكنيسة. فكان من المناسب جداً أن يقع في أول الأسبوع, لينشر نور رجائه المقدس, في أرجاء سائر أيام الأسبوع. فإذا كانت الباكورة مقدسة, تقدست كل الأثمار. "ذلك اليوم", هو يوم الأيام! فيه تحررت قلوب مستعبدة. لأن فيه استقرت حمامة الرجاء في القلوب التي طار منها عصور الأمل يوم الجمعة الحزينة. إن "ذلك اليوم" شمس بالنسبة لسائر الأيام, وما هي إلا كواكبه, لأن كل أنوارها مستمدة من نور "يوم الأيام". فلا عجب إذا صار هو سبت المسيحية الجديد. فيه قام المسيح. وفي مثله ظهر لتلاميذه في علية أورشليم . وفي مثله ظهر أيضاً لتلاميذه على شاطئ بحر طبرية, كما يعتقد معظم المفسرين. "ولما كانت عشية ذلك اليوم" – نحو الساعة الثامنة مساء – "وهو أول الأسبوع" – وكان تلميذا عمواس قد رجعا إلى أورشليم , وأخبار القيامة قد انتشرت ي المدينة, خاف التلاميذ من أن يلحقهم أذى من رؤساء اليهود, جَاءَ يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِ وَقَالَ لَهُمْ: الذين تبرعوا لهم بتهمة سرقة جسد المسيح, قبل قيامته بثلاثة أيام (متى 27: 63 و64). ومن يدري ماذا يفعلون بهم الآن؟ لذا خلوا إلى بعضهم البعض في علية أورشليم , وأغلقوا غرفتهم. خطأ ما أكبره! فإنهم خافوا في الوقت الذي كان ينبغي أن يتذرعوا فيه بشجاعة دونها شجاعة الأسود. (2) ظهور المسيح المقام وعطاياه لتلاميذه (20: 19 (ب) – 23). عدد 19(ب). ظهور المسيح في الوسط: "جاء يسوع ووقف في الوسط". إننا لا نشاطر كلفن رأيه القائل إن المسيح فتح الأبواب من غير أن يدري به التلاميذ. لأن الأبواب كانت مغلقة الإحكام بسبب خوف التلاميذ من اليهود. فمع أن جسد المسيح, بعد القيامة, كان جسداً حقيقياً, إلا أنه يختلف في أشياء كثيرة عن جسده قبل القيامة. والظاهر أن المخلص كان يجتاز في لحظة واحدة من مكان إلى آخر, وأن تلاميذه كانوا مراراً يرونه, ويتحادثون معه, ولا يميزونه, إلا متى أراد هو أن يظهر ذاته لهم. المسيح كان قبل موته, ظاهراً بجسده إلا في الأوقات التي أراد أن يختفي به فيها. لكنه بعد القيامة كان مختفياً بجسده, إلا في الأوقات التي أراد أن يظهر به فيها. عدد 19 (ج) – 21 (أ). الهبة الأولى – السلام. حالما ظهر المسيح لتلاميذه, أعطاهم سلاماً فياضاً – سلام الماضي والحاضر – سلام الغفران واليقين "وقال لهم سلام لكم" (19 ج). لم تكن تحية جوفاء, هذه التي حيا بها المسيح المقام تلاميذه. لكنها تحية غنية, محملة بسلامه العميق القلبي, الذي «سلاَمٌ لَكُمْ». 20وَلَمَّا قَالَ هَذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ فَفَرِحَ التّلاَمِيذُ إِذْ رَأَوُا الرَّبَّ. 21فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضاً: «سلاَمٌ لَكُمْ. كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُ يبدد مخاوف الماضي وشكوك الحاضر. هذا هو سلام الغفران, الذي ستر به المسيح تقصيرات التلاميذ وجبنهم (راجع تفسير 14: 27). عدد 20. (أ) ضمان السلام وحجة دوامه: "سلام لكم ... ولما قال هذا أراهم يديه وجنيه". بذلك تأكد التلاميذ أن المسيح قام حقاً. لأنهم إذ رأوا يديه وجنبه تبينوا فيها آثار المسامير والحربة "ففرحوا إذ رأوا الرب", لأنهم تحققوا أنه "هو الرب". إن السلام الذي قدمه المسيح لتلاميذه قد اشتراه لهم بصليبه, فاليدان المثقوبتان, والجنب المطعون, هي الوثيقة الحية التي خطها المسيح بدمائه, وقدمها للتلاميذ كحجة خالدة, وضمان يقيني لسلامه. قال ستيوبتز للوثر: "تأمل باستمرار في جروح المسيح, فهي ختم الفداء, وهي ضمان السلام الذي هو وليد الفداء". عدد 21. (ب) سلام المستقبل – سلام الخدمة: "فقال لهم يسوع أيضاً سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا". بعد أن طمأن المسيح تلاميذه بسلام الماضي, وملأ قلبهم يقيناً بسلام الحاضر, أراد أن يعدهم لمسئوليات المستقبل, باعتبار كونهم سله في العالم, فوهبهم أيضاً سلام المستقبل. لأن السلام هو ترياق الماضي, وعلاج الحاضر, وقوة المستقبل. الهبة الثانية: شرف الكرازة باسم المسيح: "كما أرسلني الآب أرسلكم أنا". مع أن رسالة الرسل ليست على طراز رسالة المسيح – لا: (1) من أُرْسِلُكُمْ أَنَا». 22وَلَمَّا قَالَ هَذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمُ: حيث الزمن – لأن المسيح أرسل منذ الأزل, لكن التلاميذ أرسلوا في وقت معين . ولا: (2) من حيث الرتبة, لأن المسيح رسول الآب الأوحد على رتبة لا يدانيه فيها الرسل. إلا أن التشابه الذي بين الرسالتين, كائن في الاسم, والسلطان. فكما أن لمسيح جاء إلى العالم حاملاً اسم الآب, ومتقلداً سلطانه, كذلك انتشر الرسل في العالم حاملين اسم المسيح, ومتقلدين سلطانه. عدد 22. الهبة الثالثة – عطية الروح القدس: "ولما قال هذا, نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس" – هذا هو "رأسمال" التلاميذ في الخدمة – بل هذا هو ضمان نجاحهم فيها – الروح القدس. فكما أن قيامة المسيح تعتبر عربوناً لصعوده, كذلك يعتبر قبول التلاميذ عطية الروح القدس من المسيح المقام عربوناً لنوالهم ملء الروح القدس من المسيح الممجد يوم الخمسين. "قال لهم سلام لكم ... ولما قال هذا أراهم يديه ..." "قال لهم أرسلكم أنا ... ولما قال هذا نفخ, وقال لهم اقبلوا الروح" تقع هذه العبارات في أربعة مقاطع – تسير في صفين متوازيين. فالمقطع الأول, يتمشى مع المقطع الثالث, مثلما يسير المقطع الثاني جنباً إلى جنب مع الرابع. وكما أن المقطع الثاني هو ضمان الأول وحجته, كذلك الرابع, ضمان الثالث وحجته. هبة السلام: " ... قال لهم سلام لكم ...". ضمانها وحجة دوامها: "ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه". «ﭐقْبَلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ. 23مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ مهمة الكرازة: " .... كما أرسلني الآب أرسلكم أنا". ضمانها وحجة نجاحها: "ولما قال هذا وقال لهم أقبلوا الروح". "نفخ وقال لهم([2]) اقبلوا([3]) الروح القدس". يذكرنا هذا القول, بذاك الذي ورد في غرة سفر التكوين:"وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة " (تك 2: 7). هذه مرة أخرى يلتقي فيها يوحنا البشير, كاتب بشارة الخليقة الجديدة, بموسى كاتب سفر تكوين الخليقة الأولى (راجع يوحنا 1: 1). فعندما هيأ الله هيكل الإنسان الأول, نفخ في أنفه نسمة الحياة الطبيعية. وكذلك عندما هيأ المسيح قادة كنيسته المجيدة, نفخ فيهم نسمة روحه الأقدس. قال أغسطينوس: "إن المسيح إذ نفخ فيهم وقال "اقبلوا الروح القدس" برهن على أن الروح القدس, ليس روح الآب فقط, بل روحه هو أيضاً". عدد 23. الهبة الرابعة: السلطان المترتب على نوال الروح القدس "من غفرتم خطاياه تغفر له, ومن أمسكتم خطاياه أمسكت". إن كل هبة من الهبات الأربع التي منحها المسيح المقام لتلاميذه, مترتبة على الهبة تُغْفَرُ لَهُ وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ السابقة له, وممهدة للهبة اللاحقة بها. ومن الأهمية بمكان عظيم, أن نذكر: (1) أنه واضح من لوقا 24: 33, أن هذه الجماعة الملتئمة, لم تكن قاصرة على الرسل, بل كانت تضم معهم قوماً آخرين من المؤمنين بما فيهم تلميذي عمواس (لوقا 24: 3). فهبات المسيح المتضمنة في هذا الفصل المجيد, ليست محتكرة للرسل, لكنها تشمل أيضاً كل الجماعة التي تتألف منها كنيسة المسيح على الأرض. (2) أن هذا السلطان ليس وقفاً على فرد من الأفراد, مهما سمت رتبته, لكنه من حق كل الجماعة. (3) أن الحل والعقد المذكورين في هذه الآية, ليسا من الأحكام التعسفية التي يصدرها من يشاء, حسبما يشاء, بل هما من النتائج المترتبة على الكرازة بكلمة البشارة. فالكلمة نفسها هي خير حكم لمن يقبلونها, وعلى من يرفضونها. أو بعبارة أخرى: إن خير حكم للإنسان, أو عليه, هو الإنسان نفسه – فإن قبل كلمة البشارة تمتع بنعمة الغفران, وإن رفضها صار هو الحاكم على نفسه بأنه ليس أهلاً لهذه النعمة. وخير مثال لذلك, ما جاهر به بولس وبرنابا لليهود الذين لم يقبلوا كلمة الإنجيل "كان يجب أن تكلموا أنتم بكلمة الله ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية, هو ذا نتوجه إلى الأمم" (أعمال 13: 46). وما إمساك الخطايا إلا نتيجة طبيعية لعدم غفرانها. (3) أن هذا السلطان المسلم للرسل ولجماعة المؤمنين, هو سلطان الإعلان, والتصريح. لا سلطان الحكم والقضاء. فالمسيح وحده يغفر خَطَايَاهُ أُمْسِكَتْ».24أَمَّا تُومَا الخطايا لكن خدامه يصرحون بأن هذا الغفران قد تم أو لم يتم – بناء على قبول الإنسان كلمة الخلاص, أو رفضه إياها, فسلطان الكنيسة في الروحيات, مماثل لسلطان كهنة اليهود في أمر المصاب بالبرص قديماً, حين كانوا يحكمون بطهارة من شفي من دائه, وبنجاسة من لم يشفى منه بعد, ولكن لم يكن في سلطانهم أن يشفوا أحداً من البرص ولا أن يضربوا به أحداً. وهو أيضاً على مثال السلطان الذي وهبه الله لإرميا (إرميا 1: 10). هو إذاً سلطان متعلق بإعلان الغفران لا بالغفران ذاته. (5) وإذا سلمنا جدلاً, مع القائلين بأن هذا السلطان محتكر للرسل, فما هذا السلطان الذي خوله المسيح إياهم, حين أوحى إليهم بروحه الأقدس أن يضعوا دستور الإيمان في رسائلهم. فكل ما قالوه في هذا الباب صار حكماً لا ينقض ولا يبرم. (ج) ظهور المسيح لتلاميذ وتوما معهم (30: 24-29). "فتيلة مدخنة لا يطفئ, وقصبة مرضوضة لا يقصف, حتى يخرج الحق إلى النصرة" – هذا هو الوصف البليغ الذي خلعه زعيم أنبياء العهد القديم على المسيح. وهو نفس الوصف الذي يلابس المسيح في هذا الظرف الذي نحن بصدده الآن. فقد حدثنا يوحنا في الأعداد السابقة, عن ظهور المسيح لتلاميذه في غيبة اثنين منهم – أحدهما: يهوذا الذي ذهب قتيل اليأس, بعد أن ذّهبت فيه كل وسائل الإسعاف أدراج الرياح. وثانيهما: توما الذي "يقال له "التوأم" الذي كان على شفير جرف عدم الإيمان, فأدركه الراعي الصالح, وانتشله قبل أن يهوي به الجرف إلى حضيض عدم الإيمان, والهلاك. أَحَدُ الاِثْنَيْ عَشَرَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ في هذا الفصل, نرى ثلاث صور لتوما:( 1) توما مصاباً بداء الشك (2: 24 و25). (2) توما بين يدي طبيب الأرواح يستأصل منه داء الشك (20: 26 و27). (3) توما يبرأ من الشك ويجاهد بإيمانه (20: 28). وفي ختام هذا الفصل نرى أرقى ذروة في درجات الإيمان (20: 29). (1) الصورة الأولى: توما مصاباً بداء الشك (20: 24 و25). عدد 24. (1) توما المتخلف عن جماعة الرسل: "أما توما واحد من الإثني عشر , الذي يقال له التوأم, فلم يكن معهم حين جاء يسوع". لسنا ندري هل نلوم توما, أو نحمده على شكه, الذي صار في ترتيب العناية سبباً في تثبيت حقيقة القيامة في أذهان الأكثرين على ممر الدهور. لأن هذا الشك أضحى سبباً في إضافة براهين جديدة إلى قائمة البراهين المؤيدة لحقيقة القيامة. إننا نشكر رب توما, الذي أخرج لنا من شك توما الجافي, حلاوة لحلقنا. مع أن التلاميذ صار عددهم الآن أحد عشر – بعد وفاة يهوذا – إلا أن يوحنا لا يزال يذكرهم بعددهم الذي ذكرهم به في 6: 67, على اعتبار أن مكان يهوذا لم يخل إلا إلى حين. فكأن يوحنا رأى في عددهم الكامل, معنى رمزياً إلى أسباط كنيسة العهد الجديد المكملين. "أما توما الذي يقال له التوأم" – سبقنا فأوضحنا المراد بكلمة: "توأم " في شرح 11:16, فاطلبه هناك – "فلم يكن معهم حين جاء يسوع". ما أعظم الخير الذي يحرم الإنسان نفسه منه, بتخلفه عن اجتماع القديسين. فمهما يكن محضر القديسين حقيراً في مظهره, إلا أن المرء يعجز فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عن أن يقدر مبلغ الخسارة التي تلحق بمن "يتركون اجتماعهم كما لقوم عادة" لأنه في ساعة لا تخطر على بال أحد, يظهر المخلص ذاته لجماعة المؤمنين. فبسبب تخلف توما عن اجتماع الرسل في أحد القيامة, حرم نفسه من التملي من وجه مخلصه, ورؤية يديه وجنبه. وبسبب هذا الحرمان, أوقع نفسه في لج الشك أسبوعاً أو بعض أسبوع, وأعطى داء الشك فرصة, حتى تغلغل في دمه, وكاد يؤدي بحياته الروحية. ولئن سكت البشير عن أن يذكر صراحة علة تخلف توما عن اجتماع الرسل إلا أننا نستطيع أن نستنتج ضمناً, أن توما كان عصبي المزاج يعيش بعواطفه, وينظر دائماً إلى الجانب المظلم في الحياة. فعندما كان سيده ذاهباً إلى بيت عنيا, ليقيم لعازر من الأموات, لم يستطع توما أن يفكر في القيامة, بل فكر في الموت. وقال للتلاميذ رفقائه "لنذهب نحن أيضاً لكي نموت معه" (11: 16). وفي مناسبة أخرى, ما كاد يستمع لحديث المسيح مع تلاميذه عن علمهم "بالطريق" حتى قال ضجراً متبرماً: "لسنا نعلم أين تذهب, فكيف نقدر أن نعرف الطريق" (14: 5). إلى هذا الحد, كانت نظرة توما إلى الحياة قاتمة سوداء – هذا بينما كان المسيح معه بالجسد. فكم أمست نظرته إلى الحياة أشد سواداً بعد موت فاديه. ويكاد يكون من المحقق, أن موت المسيح كان صدمة قوية أصابت إيمان توما ورجاءه. ولعله كان يقول في نفسه, بعد موت المسيح مباشرة: "ألم حِينَ جَاءَ يَسُوعُ. 25فَقَالَ لَهُ التّلاَمِيذُ الآخَرُونَ: «قَدْ رَأَيْنَا الرَّبَّ». فَقَالَ لَهُمْ: «إِنْ لَمْ أُبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَثَرَ الْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ إِصْبِعِي فِي أَثَرِ الْمَسَامِيرِ أقل له مراراً وتكراراً أن لا يقف في طريق رؤساء اليهود؟ ولكن هذا ما حصل, فالذي تحذرين يا نفس قد وقع". أمام هذه الأفكار المظلمة القاتمة, شعر توما بمرارة في نفسه وبسببها أقصى نفسه عن حظيرة الرسل – ولو إلى حين. فلما ظهر لهم المخلص في أول أحد للقيامة: "لم يكن توما معهم". في هذه الآونة, كان توما "واحداً من الرسل", مع أنه لم يكن معهم. بخلاف يهوذا الذي كان مع لرسل لكنه لم يكن منهم. ولو كان منهم لبقي معهم (1 يو 2: 19). عدد 25. (ب) التلاميذ يخبرون توما بأنهم رأوا الرب "فقال له التلاميذ قد رأينا الرب". لاشك في أن التلاميذ أخبروه بتشككهم هم أيضاً في بدية الأمر, وكيف أن الرب دعاهم إلى أن يجسوه, وينظروا ليحققوا أن له جسداً حقيقياً (لو 24: 39 و40). (ج) توما يتسلح بنية عدم الإيمان: "فقال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير, وأضع إصبعي في اثر المسامير, وأضع يدي في جنبه لا أؤمن". كان من الممكن أن يصدق توما زملاءه الرسل, وهو يعهد فيهم الصدق. لكن ما سمعه منهم عن رؤيتهم جسد الرب, ولمسهم إياه, كان محرضاً له على أن يطلب هو الآخر نفس هذه العلامة. وزاد فأمعن في طلب ثلاث علامات – كل منها أقوى من سابقتها, وبدونها يأبى إلا أن يكون غير وَأَضَعْ يَدِي فِي جَنْبِهِ لاَ أُومِنْ».26وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مؤمن: "إن لم أبصر" .... "إن لم أضع إصبعي" .... "إن لم أضع يدي ....". ليس عيب توما, أنه طلب هذه العلامات التي أتيح غيره من الرسل أن يتمتع بها أو ببعضها, لكن عيبه في تسلحه بنية عدم الإيمان. لأن النبرة في كلامه واقعة على عدم الإيمان لا على الإيمان. فبدلاً من أن يقول: "إن رأيت ولمست, آمنت", قال: "إن لم أر ... وإن لم أجس ... لا أؤمن". فكأنه كان إلى عدم الإيمان أقرب منه إلى الإيمان. كان الظلام يحيط بكلمات توما من جميع الجهات إلا من جهة واحدة منيرة – هي تفكيره المتواصل في آلام سيده. وأن تلميذاً هذه حاله, لا بد وأن يرسو على مرفأ الإيمان بأمان. (2) الصور الثانية: توما بين يدي طبيب الأرواح يستأصل منه داء الشك (20: 26 و27). لقد عالج طبيب الأرواح داء توما بوسيلتين: أولاهما – عامة : وهي ظهوره للرسل وتوما معهم. (عدد26). والثانية – خاصة: وهي طلبه إلى توما أن يختبره بنفسه اختباراً حسياً, حسبما طلب (عدد 27). عدد 26. (1) ظهور المسيح للتلاميذ وتوما معهم: "وبعد ثمانية أيام" – أي في الأحد التالي لأحد القيامة. قال البشير: "ثمانية أيام" – كعادة اليهود, في حسبان أول يوم وآخر يوم ضمن المدة التي يقصدونها. قضى التلاميذ السبعة الأيام التي بعد أول يوم في الفصح, في أورشليم , كعادة اليهود, فصاروا في نهاية هذه المدة على وشك أن يتركوا أورشليم , ليرجعوا إلى محال إقامتهم في الجليل. ولكن كيف يمكنهم أن يغادروا عليتهم كَانَ تلاَمِيذُهُ أَيْضاً دَاخِلاً وَتُومَا مَعَهُمْ. فَجَاءَ يَسُوعُ وَالأَبْوَابُ مُغَلَّقَةٌ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِ وَقَالَ: المعهودة, في هذا اليوم التاريخي, المقدس, المعهود – يوم الأحد – الذي في غرة مثله من الأسبوع الماضي, قام سيدهم, وفي مسائه أظهر لهم ذاته. لذلك لم يبرحوا أورشليم في ذلك اليوم, توقعاً منهم أن يمن عليهم سيدهم بإظهاره ذاته لهم مرة أخرى. ولعل نفوسهم الشريفة, أبت عليهم أن يتركوا أورشليم في هذه الآونة وواحد منهم – توما – متخلف عن جماعتهم. وفي الغالب جداً, دعوا هذا الرسول يجتمع بهم في هذا اليوم علهم يفوزون وإياه, في هذه المرة أيضاً, بمثل ما فازوا به في الأحد الماضي. أما "راعي النفوس" الأعظم, فقد كان عند حسن ظن رسله به, فكافأ كل إنتظاراتهم فيه, وظهر لهم في هذه المرة أيضاً, ليزيدهم يقيناً على يقين, وليرد هذا الحمل الضائع إلى الحظيرة. هذه هي المرة الثالثة, التي أظهر فيها المسيح ذاته بعد القيامة, في سجل هذا الأصحاح. وهي السادسة بين جميع المرات التي في كل البشائر. يستفاد من قول البشير: "كان التلاميذ أيضاً داخلاً", إنهم كانوا مجتمعين في ذات المكان الذي اجتمعوا فيه الأحد الماضي. إلا أن "خوفهم من اليهود", قد انتفى منهم في هذه المرة الثانية, لأن تيقنهم من قيامة سيدهم, انتزع من بين ضلوعهم قلوب الغزلان, ووضع مكانها قلوب الأسود. "فجاء يسوع والأبواب مغلقة". ذكر البشير هذه العبارة, ليقرر لنا «سلاَمٌ لَكُمْ». 27ثُمَّ قَالَ لِتُومَا: «هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي أن المسيح دخل إلى مكان اجتماعهم بطريقة معجزية – "ووقف في الوسط وقال سلام لكم" – اطلب تفسير 20: 19, حيث وردت هذه الكلمات بالذات. عدد 27. (ب) المسيح يدعو توما إلى أن يختبره بنفسه اختباراً حسياً: "ثم قال لتوما" – في هذه الأثناء, حانت من المسيح التفاتة إلى توما, بها مزق حجب الشكوك التي كان مدثراً بها هذا الرسول المستضعف, فانتشله الفادي من وهدة عدم الإيمان, مثلما انتشل بطرس من هاوية اليأس, بتلك النظرة التي أدمت قلبه واستدرت الدموع من عينيه (لوقا 22: 62), ثم مد يده المثقوبة إلى توما, وقال "هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي" – ثم كشف له عن جنبه المطعون, وقال: "وهات يدك وضعها في جنبي" – وهنا شعر توما المسكين, كأن طبيب الأرواح قد وضعه "على المشرحة", وسلط عليه أنواراً كشافة من علمه الكلي, فكانت هذه الأنوار أقوى من الراديوم, وأنفذ فعلاً من أشعة رتنجن. وما كان أشد غرابة توما عندما سمع فاديه يردد على مسمعه تلك الكلمات عينها, التي سبق توما فأفضى بها إلى التلاميذ رفقائه. لا شك أنه أحس وقتئذ بمثل ذلك الإحساس, الذي ملأ قلب نثنائيل, حين أدرك أن المسيح عالم بماضيه وحاضره (1: 48 و49). غير أن كلمات المسيح لتوما, لم تكن مجرد دعوة منه لذلك التلميذ, بأن يفحصه فحصاً حسياً, لكنها تحمل بين طياتها تعنيفاً وتلويماً, كما يظهر من وَلاَ تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِناً». 28أَجَابَ تُومَا: «رَبِّي وَإِلَهِي». قوله له: "ولا تكن غير مؤمن بل مؤمناً", لأنه علم بالنية التي كان قد بيتها توما في قلبه, وتسلح بها – نية التشكك. ولو بقي هذا المسكين على هذه الحال, لقاده التشكك إلى عدم الإيمان. فكأنه كان على مفرق طريقين, بل كان عدم الإيمان أقرب منه إلى الإيمان. هذه, ولاشك, حالة شاذة. لأنه من الطبيعي أن يؤمن الإنسان, إلى أن يتبين سبباً لعدم الإيمان, لكن توما صمم على عدم الإيمان, ما لم يجد سبباً للإيمان. هذا إنسان سلبي. عدد 28. (3) الصورة الثالثة: توما يبرأ من الشك. ويجاهر بإيمانه: غالباً جداً, لم يجد توما داعياً إلى أن يلمس يدي المسيح ولا أن يضع يده في جنبه, بعد أن تحقق من كلامه له, أنه علاّم الغيوب. عندئذ لم يقتنع فقط بأن المسيح قام, بل أيقن أيضاً أن المسيح المقام هو "الرب الإله". هاتان الكلمتان, تقابلهما في العهد القديم كلمتا "يهوه الوهيم" – "السيد الرب" (إشعياء 61: 1). على أن توما لم يكتف بالقول إن المسيح رب وإله, بل أدخل نفسه في نسبة جديدة معه, فقال – موجهاً الكلام إلى المسيح بالذات: "ربي وإلهي"! هذه درجة ممتازة في الإيمان, تفوق كل الدرجات التي مررنا بها في هذه البشارة. فكأن يوحنا البشير قد بلغ مدى بشارته عند هذا العدد. ومن العجيب أن الذي صرح بهذا الإيمان الممتاز, هو توما الذي طبع بطابع الشك – وهكذا يصير الآخرون أولين ! 29قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «لأَنَّكَ رَأَيْتَنِي يَا تُومَا آمَنْتَ! طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا عدد 29. أرقى ذرى الإيمان: "قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما, آمنت؟ طوبى للذين آمنوا ولم يروا". في هذا العدد يتجلى أمامنا أمران: أولهما - استفهام ممتزج بتعجب: "لأنك رأيتني يا توما آمنت"؟! جميل أن المسيح لم يعنف توما على كلمات التعبد التي وجهها إليه, كما أنه لم ينفر منها – هذا دليل على أن المسيح أعظم من ملاك , وإلا لاقتدى بملاك الرؤيا الذي عنف الرائي على عبادته له وقاله له: "لا تفعل ... اسجد لله" (رؤ 19:10). فضلاً عن هذا, فإن المسيح رحب بهذه العبادة التي قدمها له توما, وقبلها كحق له, لا ينازعه فيه أحد - هذا دليل قاطع على أن المسيح إله تام. وإن لم يكن إلها تاماًً لا يقبل العبادة التي لا يليق تقديمها إلا لله وحده!. والأمر الثاني – هو الغبطة المذخرة لجميع المؤمنين على ممر الأجيال: "طوبى للذين آمنوا ولم يروا" – هذا نصيب ممتاز, يفوق النصيب الذي تمتع به البشير نفسه لأنه آمن بعد أن رأى (20: 8). تذكرنا هذه الغبطة التي ميز بها المسيح المؤمنين من الرسل, بتلك الغبطة التي سبق فميز بها المؤمنين عمن تربطهم به صلة جسدية (لوقا 11: 27 و28). إن توما هو الشخص الوحيد – في الرسل – الذي قدمت له فرصة التمتع بهذه الغبطة, لكنه تركها تمر من بين يديه, فأضحت من نصيبنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. وهكذا يلتقي آخر هذه البشارة بأولها. في مقدمتها أسمعنا يوحنا كلمة وَلَمْ يَرَوْا».30وَآيَاتٍ أُخَرَ كَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ قُدَّامَ تلاَمِيذِهِ لَمْ تُكْتَبْ فِي هَذَا الْكِتَابِ. 31وَأَمَّا هَذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ المؤمن الواثق: "كان الكلمة الله .... والكلمة صار جسداً" (1: 1 و14), وعند ختامها أسمعنا هتاف من كان شاكاً فآمن: "ربي وإلهي"! غاية يوحنا من كتابة بشارته, وغاية غايته (2: 30 و31). في هذين العددين, أبان يوحنا البشير غايته من كتابة بشارته, بكلمتين – أولاهما: سلبية (عدد 30), والثانية: إيجابية (عدد 31). عدد 30. (أ) غاية يوحنا من كتابة بشارته – الجانب السلبي: "وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب" – لم يقصد يوحنا أن يلم في بشارته بكل المعجزات التي صنعها المسيح قدام تلاميذه, ولكنه تخير منها سبع معجزات –والسبعة عدد كامل – كنموذج يساعده على الوصول إلى غرضه. ولقد أجاد في ترتيب هذه المعجزات ترتيباً تدريجياً منطقياً, ثم ختمها بمعجزة المعجزات – قيامة المسيح من الأموات. عدد 31. (ب) غاية يوحنا من كتابة بشارته – الجانب الإيجابي: "وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا" :(1) "أن يسوع هو المسيح" رجاء اليهود, ومشتهى الأمم, الذي تمت فيه نبوات العهد القديم وتكملت فيه رموزه : (2) أن يسوع المسيح هو "ابن الله", و"كلمة الله" المتجسد. فهو ليس نبياً على طراز جديد نظير موسى , وإيليا, وداود. بل هو "الله الذي ظهر في وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ بِاسْمِهِ. الجسد". ولو لم يكن المسيح ابن الله لما أمكن أن يكون هو مسيح إسرائيل أو مسيح الله, فمسيحيته قائمة على بنوته, وبنوته تدعم مسيحيته. هو الإنسان الكامل لأنه هو الإله الحق – "هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية" (1 يو 5: 20). إن لهذه الغاية التعليمية, غاية عملية – هي:" لكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه". فمع أنه يكفي أن يكون الإيمان غاية في ذاته, إلا أن يوحنا جعله أيضاً وسيلة لغاية عملية – نوال "الحي الأبدي". فليست غاية يوحنا عقائدية, فحسب, بل هي أيضاً أخلاقية عملية. إن هذه الحياة الأبدية مرتبطة ارتباطاً حياً "باسمه". وهكذا نسمع في خاتمة هذه البشارة صدى صوت بدايتها: "فيه كانت الحياة ... باسمه" (1: 4 و12) - هذا هو الصوت "لكي تكون لكم حياة باسمه" (20: 31) – هذا هو الصدى (1) لقبت مريم بـ"المجدلية", نسبة إلى بلدها "مجدل " وهي المدينة التي آتى إلى تخومها المسيح بعدما أشبع الأربعة آلاف, في الجنوب الشرقي من بحر الجليل (متى 15: 39) ويعتقد الأكثرون أنها "المجدل" الحالية, التي تبعد نحو ساعة إلى شمال طبرية,
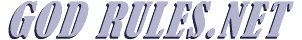 |
